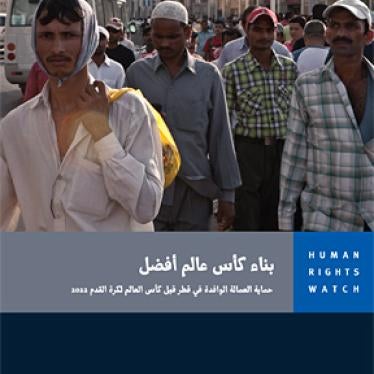بعد أسبوعين، سوف يحل الرئيس المصري حسني مبارك ضيفاً على البيت الأبيض للمرة الأولى منذ عام 2004. ومصر بالطبع حليفة أساسية للولايات المتحدة، والولايات المتحدة تحتاج أمس الحاجة إلى مساعدتها، في سياق محاولة الرئيس باراك أوباما بدء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من جديد. لكن الرئيس مبارك ليس ضيفاً نموذجياً، فهو صورة للحاكم العربي السلطوي، إذ يرأس نظاماً يُخضع معارضيه للتضييق والاحتجاز، والتعذيب فيه منتشر. نعم، احتفى مبارك بتنصيب أوباما رئيساً بأن أخلى سبيل أشهر سجين سياسي في مصر، وهو المُعارض أيمن نور. لكنه لم يُظهر ميلاً إلى السعي لإجراء إصلاحات أوسع، ويبدو حريصاً على أن يخلفه ابنه في الحُكم. وهو يقابل شخصيات مُريبة، إذ تحدى صراحة إحدى أولويات إدارة أوباما بأن دعى الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة بعد أن وجهت إليه الاتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
وتناقلت التقارير رفض مبارك زيارة واشنطن أثناء ولاية جورج دبليو بوش الثانية رئيساً، جراء انتقادات تلك الإدارة من الحين للآخر للسياسات القمعية في مصر. وسوف تخبرنا كيفية استقبال إدارة أوباما له الكثير عن أهمية حلفاء الإدارة في الترويج لحقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط، والشيء نفسه بالنسبة لزيارة أوباما إلى مصر في يونيو/حزيران، حين سيُلقي خطابه المُنتظر على العالم الإسلامي. ومع بدء أوباما في استعادة السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة، فكيف سيختار استخدام هذه السلطة في مصر وغيرها من الدول؟
لا ريب أن الإدارة تريد أن تنأى بنفسها عن منهج إدارة بوش التبشيري، التي تعهدت بنشر الحرية و"القضاء على الطغاة في زمننا هذا" فقط لنرى بعد ذلك وعلى الفور الشعارات تتحطم على صخرة حرب العراق وعار التعذيب وغوانتانامو. وقد كان أوباما محقاً في التركيز على استعادة الثقة في الجانب الأخلاقي للولايات المتحدة.
وفي مطلع عام 2004، رافقتُ المعارض المصري المتميز سعد الدين إبراهيم إلى البنتاغون لمقابلة بول ولفويتز، أحد مهندسي "أجندة الحرية" الخاصة ببوش في الشرق الأوسط. وأبدى إبراهيم امتنانه الحقيقي لالتزام بوش بحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم الإسلامي، لكنه بعد ذلك قال إن سجن غوانتانامو يضر أبلغ الضرر بهذه القضية. وكاد ولفويتز يخرج من الحجرة لمّا قال ذلك. لم يتحمل أن يخبره بطل من أبطال الحركة الديمقراطية العالمية بأن إدارته تصم فكرة الترويج للديمقراطية الأميركية بالعار.
لكن هنالك جانب آخر من قصة بوش والديمقراطية والشرق الأوسط. خلال تلك السنوات، كان النشطاء المصريون الذين يحضرون إلى مكتبي في هيومن رايتس ووتش يقولون لي إن أحداث غوانتانامو وأبو غريب تجعلهم يرغبون في النأي بأنفسهم عن الولايات المتحدة. لكن وفي أحيان كثيرة يسألون أيضاً: "إلى من يمكن أن نتحدث في وزارة الخارجية كي نحصل على المزيد من الدعم الأميركي لنشاطنا في مصر؟" فعلى كراهيتهم لبوش، فإنهم كانوا يعرفون أن جهوده المبكرة للضغط على مبارك (قبل أن تخمد هذه الجهود في عام 2005) بدأت في إحداث فارق. فقد تم إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، وسُمح لشخص من المعارضة بالترشح للرئاسة، وأحس المجتمع المدني بوجود مساحة أكبر للتنفس.
لكن تحطم آمالهم فيما بعد كان الجانب المعاكس للأمل في ظهور أميركا جديدة. والآن فإن هؤلاء النشطاء أنفسهم – وملايين الناس العاديين في مصر وفي شتى أنحاء الشرق الأوسط ممن يريدون العيش في مجتمعات أكثر انفتاحاً وعدلاً – يتوقعون المزيد من الرئيس الأميركي غير المُحمل بالعبء الأخلاقي للرئيس السابق، والذي يبدو مُقدراً للغاية لكفاحهم اليومي، من واقع تاريخه والمُثل والأفكار التي أعلن عنها.
إلا أن الكثير ممن راقبوا أوباما في أيامه الأولى بدأ يراودهم الشك إزاء أنه سيسعى حثيثاً إلى الترويج لأجندة حقوقية تنتقد حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر. فأوباما مشغول بالأزمة المالية العالمية. وهو يحتاج لأن يسعى زعماء مثل الرئيس مبارك لتحقيق أهداف هامة أخرى. إذ قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في طريقها إلى الصين أن الترويج لحقوق الإنسان "لا يمكن أن يتداخل" مع تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، ومما أوقف النشطاء الحقوقيين للتأمل والتفكير أيضاً، إشادتها غير المستحقة بالرئيس مبارك فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، أثناء زيارتها الأخيرة إلى مصر.
وعلى الرغم من شعاراته وأفكاره المثالية، فإن أوباما رجل واقعي. إنه لا يسعى لمخططات كبرى لإعادة صياغة العالم أو لسياسات تحركها دوافع أخلاقية، ويجب إقناعه بأن الضغط على الحلفاء المعاندين من أجل احترام حقوق الإنسان هو أمر في صالح الولايات المتحدة، أي أنه من الذكاء القيام بهذا، وليس مجرد شيء يبث شعوراً طيباً في الأميركيين. ولحسن الطالع، فإن إثبات أهمية الترويج لحقوق الإنسان أمر يسير. فالواقعية هي التي تبرر الحاجة إلى استرجاع هذه السياسة، وليس رفضها.
من المعروف أنه في الشرق الأوسط استفادت الولايات المتخدة استفادة إستراتيجية خلال سنوات شراكتها غير الواثقة بالنظم الأوتوقراطية، بما في ذلك النفط والتعاون ضد إيران وعراق صدام حسين. لكن الشخص الواقعي سيعرف أيضاً بأن هذه الفوائد دُفع ثمناً لها تكاليف إستراتيجية أخرى، مع استغلال القاعدة وغيرها من الجماعات العنيفة لتقرب أميركا من النظم الديكتاتورية، من أجل الحصول على الدعم لقضيتهم، وقاومت الحكومات السلطوية حركات المعارضة التي كان من الممكن أن تنافس المتطرفين. وفي الواقع، فإن زعماء مثل مبارك منحوا مساحة أكبر للجماعات الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين، أكثر مما منحوا للنشطاء الديمقراطيين علمانيي التوجه، من أجل خلق الوهم بأن البديل الوحيد لحكمهم هو استيلاء الإسلاميين على السلطة. وحين انطلت تلك الكذبة على الولايات المتحدة، فلم تجن منها فقط استياء الرأي العام، بل زيادة التهديدات الأمنية أيضاً.
باكستان، التي تواجه فيها الإدارة الجديدة أكبر التحديات الأمنية، هي مثال آخر يثبت هذه النقطة. فالرئيس بوش أعفى ديكتاتور باكستان، برويز مشرف، من "أجندة الحرية" لأن وكما قالها بوش بشكل لا يُنسى، فإن مشرف "يلازمنا أشد الملازمة في حربنا ضد الإرهاب وهذا ما أقدره منه". وفي الواقع، فإن جيش مشرف قام بحماية الميليشيات، فيما ركز أغلب سلطته القمعية على زعماء وجماعات المعارضة المعتدلة، وهم من يمثلون أكبر خطر على حُكمه. ودعم بوش لمشرف كان غير عملي بالمرة، إذ سمح لطالبان بالحصول على منطقة آمنة في الحزام القبلي في باكستان وهمّش قطاعات المجتمع الباكستاني التي يُرجح أن تدعم أكثر من غيرها حملة فعالة ضد المتطرفين.
واليوم، فإن الإدارة العملية بحق يجب أن تقول: إذا أردنا جلب الاستقرار إلى حزام باكستان القبلي، ومن منظور واقعي، فعلينا أن ندفع باكستان إلى تشغيل محاكم نزيهة وفعالة في المنطقة، بحيث لا يمكن لطالبان ملء الفراغ القضائي هناك. وعلينا ألا نركز على قتال باكستان للمتطرفين من عدمه، بل على كيفية قتالها لهم، مع الإصرار على حملة لا تنال من أرواح المدنيين وتبني المؤسسات التي يثق بها الشعب. وبالمثل، إذا أراد أوباما جلب السلام إلى الشرق الأوسط، فعليه ومن منطلق الواقعية، أن يتصدى للممارسات الإسرائيلية (والخاصة بالسلطة الفلسطينية) التي تقوض من الدعم الفلسطيني للمفاوضات. وإذا أراد أن تسهم الصين في التقدم في الملف البيئي، فعليه ومن منطلق الواقعية أيضاً أن يضغط على حُكام الصين من أجل ترك الصحافة الحرة تنتقد من يسيئون إلى البيئة في الصين. وإذا أراد إحراز تقدم دبلوماسي غير مسبوق مع إيران، فمن منطلق واقعي، عليه أن يصبح على صورة مقبولة أكثر للمواطن الإيراني الذي يريد قدراً أكبر من الحرية وارتباطاً بالعالم الخارجي، كي يقل الدعم الداخلي للحكومة مقابل الضغط الخارجي.
وإذا كان الوعد الكبير في رئاسة أوباما يكمن في قدرته على التواصل مع شعوب فقدت ثقتها في الولايات المتحدة، إذن ومن منطلق الواقع، فعليه أن يتحدث عمّا هو أكثر من بناء المدارس وتوفير الوظائف. عليه أن يتصدى للإحساس السائد بالإجحاف وفقدان الكرامة جراء أعمال الحكومات القمعية، وفي أحيان كثيرة – كما في حالة مصر – ببث الإحساس بأن الولايات المتحدة تميل في أغلب الأحيان ضد جانب المقموعين. وأثناء حملته الانتخابية، أوحى أوباما بأنه يتفهم هذا. ولدى سؤاله في إحدى محاوراته الأولى عمّا إذا كانت حقوق الإنسان "أكثر أهمية من الأمن الوطني الأميركي"، أجاب: "المفهومان لا تناقض بينهما، فهما يُكملان أحدهما الآخر". وأردف قائلاً: "كلما زادت رؤيتنا للقمع، قلت المنافذ التي يمكن للناس أن يعبروا من خلالها عن أنفسهم وطموحاتهم، وتزامن هذا مع تدهور وضعنا، وزادت كراهية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
هذا لا يعني أن على أوباما ألا يتحدث مع مبارك، أو ألا يسافر إلى مصر لإلقاء خطابه. على النقيض، فالحدثين فرصتين لنقل رسالته مباشرة إلى مبارك وإلى الشعب المصري على حد سواء. ولا يعني أن عليه بالتبشير من واقع الأفضلية الأخلاقية، بل على النقيض، فإقراره بالأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة سيجعل رسالته أقوى (من المفارقات المثيرة للسخرية أن أخطاء بوش ستُسهّل على أوباما استخدام هذه الآلية الفعالة).
ويعني هذا ببساطة أن عليه التحدث بصراحة عن أخطاء حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط، مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وأن يستخدم نفس أدوات التأثير للترويج لهذا الهدف مثلما يروج لأي من أهداف المصلحة الوطنية الأخرى. فمع تواصله مع قلب المنطقة؛ فعليه أن يتناول جوهر الموضوع.