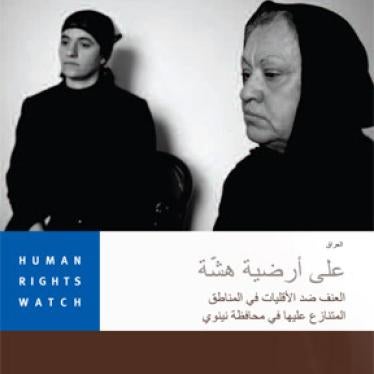الهجوم المميت الذي شنه مسلحون على علاقة بالقاعدة واستهدف كنيسة كاثوليكية في بغداد، الذي تلاه مجموعة من التفجيرات المنسقة الأكثر دماراً والتي استهدفت أحياء للشيعة وسلسلة التفجيرات التي استهدفت منازل المسيحيين، دفعت بجميع العراقيين من جميع الطوائف إلى حالة جديدة من اليأس. هذه المذابح أضرت كثيراً بفرص العراق في وضع حوادث إراقة الدماء من هذا النوع على رف ذكريات الماضي. ويتضح منها أن المكاسب الأمنية على مدار العامين الماضيين ربما يثبت قريباً أنها كانت مكاسب مؤقتة، ما لم يضغط العراقيون ومن معهم من حلفاء دوليين، على وجه السرعة، من أجل إجراء التغييرات اللازمة من أجل وضع حد لإراقة الدماء بشكل نهائي.
خطط القاعدة الخاصة بالعراق سهلة الفهم. حتى قبل أن يقود جورج دبليو بوش الغزو ضد صدام حسين، كانت القاعدة تسعى للاستفادة من الحرب الوشيكة وإحساس الغضب الذي ستثبه تلك الحرب في أوساط المسلمين السنة. أبو مصعب الزرقاوي، الذي أصبح زعيم القاعدة في العراق حتى وفاته في يونيو/حزيران 2006 في غارة جوية، من المُعتقد أنه دخل العراق من أفغانستان عام 2002 وانضم إلى البقايا المتشظية للحركات الإسلامية الكردية.
وكما ظهر من المراسلات التي تم كشفها بين الزرقاوي والقاعدة، فإن الزرقاوي اعتمد خطة للمعركة شديدة الدمار والتطرف لدرجة أن الشخص رقم اثنين في القاعدة، أيمن الظواهري، أعرب عن تحفظاته عليها في خطاب له أرسله عام 2005. في العام التالي بدأ الزرقاوي حملة لإهدار دماء السنة والشيعة بعد أن هاجم ودمر أحد المقدسات الشيعية، مسجد العسكري في السامراء، عام 2006.
وتمكن الزرقاوي ورفاقه من مسلحي القاعدة من انتزاع الدعم من قطاعات واسعة من السنة، بسبب تهميش الأقلية السنية، بعد أن كان السنة يتمتعون بتفوق سياسي واقتصادي واسعين أثناء حُكم صدام حسين وأثناء الحكومات السابقة. الشكاوى المشروعة الخاصة بالسنة - بالإضافة إلى شكاوى الأكراد والشيعة والأقليات الصغيرة في العراق - تشكل خطوط الشقاق الأساسية التي يجب معالجتها، وإلا فلا فرصة أمام العراق لتحقيق السلام.
العودة التدريجية لعنف المتمردين السنة هو توجه مزعج ومقلق. وأعضاء مجالس الصحوة العراقية الموالية للحكومة، بدأوا يتخلون عن مجالسهم ويعاودون الانضمام إلى التمرد السني. إنهم محبطون من وصول الخلاف السياسي إلى نقطة لا يمكن معها الحل في بغداد، وهي النقطة المرجح أن تستمر رغم الاتفاق أخيراً على إنشاء ائتلاف حكومي، ومن التهميش المستمر للسنة وإخفاق المؤسسات الأمنية التي يهيمن عليها الطرف الشيعي في ضم المجالس التي يهيمن عليها السنة ضمن الجهاز الأمني العراقي. جرأة المتطرفين السنة في ازدياد، إذ يحذرون من تبقى من أعضاء مجالس الصحوة بأن عليهم الكف عن قتالهم وإلا فقدوا حياتهم وحياة أسرهم.
ولطمأنة قيادات السنة إلى أن مصالحهم ستتحقق إذا استمروا في التعاون على مسار قوات الأمن العراقية - مع كسب ثقة جميع العراقيين - فمن الواجب أن تصبح هذه المؤسسات الأمنية خاضعة للمحاسبة بعيدة كل البعد عن فرض النفوذ الطائفي لهذا الطرف أو ذاك عليها. في أبريل/نيسان، قابلت هيومن رايتس ووتش محتجزين جرى نقلهم من سجن سري في مطار مثنى ببغداد كان يستضيف نحو 420 محتجزاً من شمال العراق، تحت سيطرة المكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي. وصف المحتجزون أعمال وحشية ممنهجة مورست بحقهم. وفي أحيان كثيرة، كانت قوات الأمن التي تلقت تدريب أمريكي في العراق متواطئة في تشغيل فرق القتل وغير ذلك من الانتهاكات غير المقبولة.
إنه دون الثقة في انتهاء هذا السلوك الإجرامي في أوساط قوات الأمن، فمن غير المرجح بناء الثقة حتى في أوساط الأغلبية الشيعية، دعك من السنة والأقليات الأخرى. على الحكومة العراقية أن تتحرك على وجه السرعة من أجل دمج أعضاء مجلس الصحوة ضمن الجهاز الأمني العراقي، مع منح التدريب الملائم لجميع قوات الشرطة والجيش والعدالة الجنائية، على حقوق الإنسان، مع إنشاء آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة. كما أن على الحكومة أن تفتح التحقيقات المستقلة والنزيهة في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تؤدب وتقاضي جنائياً المسؤولين على كافة المستويات.
ومن القضايا شديدة الحساسية وضعية "الأراضي المتنازع عليها" الغنية بالنفط في شمال العراق، المتنازع على ملكيتها بين أكراد العراق والحكومة المركزية العراقية. كان صدام حسين قد لجأ إلى الإبعاد الممنهج للأكراد وغير العرب من الأراضي المتنازع عليها، وجاء بالعرب لشغل قراهم. سياسة "التعريب" هذه وصلت إلى ذروتها عام 1988 في حملة الإبادة الجماعية "الأنفال" ضد الأكراد.
أدت الحرب عام 2003 إلى عكس الوضع سريعاً، إذ سيطر المقاتلون الأكراد على أغلب الأراضي المتنازع عليها وفر العرب المنقولين إلى الشمال ضمن سياسة التعريب، من العديد من القرى. وما زال الوضع متوتراً على امتداد شريط من الأرض على الحدود العراقية السورية وحتى الحدود مع إيران. الأراضي المتنازع عليها تعتبر عُشر مساحة العراق - وليست قضية صغيرة - ويمكن أن تنفجر في صورة حرب مفتوحة إذا ظلت دون حل. وهناك الآلاف من العرب الذين فقدوا بيوتهم في عام 2003 لدى عودة المقاتلين الأكراد، ما زالوا متروكين بلا حلول، والكثير منهم مشردين بلا بيوت، منذ فقدوا أراضيهم الأصلية في أثناء تهجير صدام حسين إياهم إلى الشمال.
معركة السيطرة على "الأراضي المتنازع عليها" في الشمال ليست بين الأكراد والعرب ببساطة. فبين الطرفين أكبر تجمع من الأقليات الدينية العراقية: الأزديين والشبك والكلدانيين والأشوريين والمسيحيين، الذين يعتبرون جميعاً سهول نينوي المحيطة بالموصل ديارهم منذ آلاف السنين.
هجمات الكنيسة في بغداد لم تستهدف رواد الكنيسة فحسب، بل سددت ضربة موجعة لعادات التسامح الديني والتعايش السلمي في العراق. العراق يضم بعض أقدم الأقليات الدينية في العالم. الكلدانيون والآشوريون ومسيحيون آخرون في العراق يمارسون شعائرهم منذ عهد الحواريين، ولا يضاهي قِدم هذه التقاليد الدينية في العراق إلا الأقليات الأخرى من قبيل الأزديين والصابئة والمندائيين، الذين تعود تعاليمهم إلى يوحنا المعمدان. والآن، يخشى الكثيرون أنهم آخر من يمارس ديانتهم في العراق، وأنه ربما ما سيعرضهم قريباً المتطرفون للانقراض.
وقد ضغطت حكومة إقليم كردستان على الأقليات الدينية عن طريق الاعتقالات التعسفية وأعمال الترهيب والعنف من أجل دعم مطالب الحكومة الإقليمية على أراضي المنطقة. وشن المتطرفون من العرب السنة حملة قاتلة من أعمال القتل الجماعي ضد الأقليات الدينية، إذ وصفوهم بـ "الكفار" و"الصليبيين".
من الحلول العادلة لقضية "الأراضي المتنازع عليها" الإقرار بأن هذه الأراضي لا تخص "الأكراد" بشكل حصري ولا "العرب"، بل هي رقعة من الأرض يجب اعتبارها خلاصة الهوية العراقية، على حالها قديماً. ولن يتأتى الاستقرار إلا مع رفض العراقيين للمطالبات التي تتجاهل الأطراف الأخرى، فيما يخص المناطق المتنازع عليها، مع الاتفاق على حماية حقوق من يعيشون في الأرض على أساس من المساواة.
المهلة المتاحة لدرء موجة جديدة من إراقة الدماء هي مهلة جد محدودة، لكن لم تُفقد بعد. أغلب العراقيين متعبين من النزاع وساءهم كثيراً رؤية إهدار الدماء عبر السنوات القليلة الماضية. لكن إخفاق رجال السياسة العراقيين في الوفاء بمسؤولياتهم أمام شعبهم والعمل على تسوية قضية أساسية تواجه العراق - أو أن يبدأوا العمل من الأساس - يعرض العراق مرة أخرى لخطر مميت. هناك قضايا صعبة تنتظر الحل، والهجمات الأخيرة تذكرنا من جديد بأن هذه المشاكل لن تختفي من تلقاء نفسها إذا تجاهلناها.