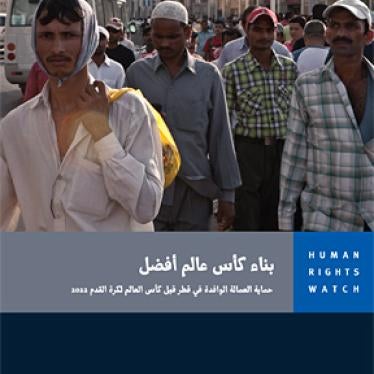لم يكن الشهر الماضي جيداً فيما يتعلق بالتسامح الديني.
فبينما كانت مصر تترنح على حافة الفوضى في أعقاب قيام الجيش بخلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي، عمد معتدون مجهولون إلى قتل قسيس قبطي في سيناء، وقام متشددون مسلمون بالاعتداء على كنائس في المنيا، وحرقوا منازل عدد من الأقباط في الأقصر.
وفي باكستان قام انتحاري يوم 30 يونيو/حزيران بقتل 28 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم على بزارة تاون، وهي منطقة شيعية بمدينة قطا. تبنت الحادث جماعة عسكر جانغفي السنية المتطرفة، فيما يعد الحلقة الأحدث ليس إلا في سلسلة من الفظائع الطائفية في باكستان.
كما قال فرانسسكو موتا، رئيس شؤون حقوق الإنسان الأممي في العراق، يوم 5 يوليو/تموز، إن النزاع العراقي يتخذ أبعاداً طائفية أكثر شراسة من أي وقت سبق. وقد تسببت الهجمات العنيفة ـ التي يصطبغ الكثير منها بصبغة طائفية ـ في هذا العام حتى الآن في مقتل نحو 3 آلاف مدني عراقي، قتل أكثر من 100 منهم في الأيام القليلة الأولى من شهر يوليو/تموز وحده.
ولا تقتصر الطائفية المقيتة على الدول الإسلامية وحدها ـ بدليل الهجمات التي يشنها البوذيون بقيادة رهبانهم على أقلية الروهينغيا في بورما، ورهاب الإسلام المتنامي في أوروبا. إلا أن هذه النزعة تنتشر بصفة خاصة ـ وتثير الانزعاج ـ في العالم الإسلامي، وتصيب مناطق تعايش فيها الناس معاً طوال قرون. يعمل العنف على تمزيق المجتمعات، ويغذي عدم الاستقرار السياسي والانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان. وتتخذ منها الحكومات السلطوية سبباً لمقاومة مطالب الشعوب بالحقوق السياسية.
ولا شك أن الحرب الأهلية في سورياقد ساعدت على تغذية التوترات الطائفية التي تتخلل المنطقة. بدأ الصراع بتأليب حكومة وجيش تهيمن عليهما الأقلية العلوية في سوريا (المنتسبة إلى الإسلام الشيعي) ضد حركة احتجاج شعبية. وضاعف الرئيس بشار الأسد وأعوانه من الانقسام الطائفي بشيطنة النشطاء المطالبين بالديمقراطية وتصويرهم كمتشددين وجهاديين. وها قد تحول عفريتهم إلى حقيقة، فقد تحولت الانتفاضة إلى تمرد مسلح تحتكره وتهيمن عليه بشكل متزايد الجماعات الإسلامية السنية، بما فيها المقاتلون الأجانب الذين يحمل بعضهم أجندات طائفية صريحة.
ويصطف اللاعبون الإقليميون في سوريا في صفوف طائفية، فتؤيد إيران وحزب الله والعراق الأسد، بينما يتولى ائتلاف من الدول السنية تقوده المملكة العربية السعودية دعم المتمردين. لقد صار النزاع السوري أحدث ميدان للقتال في الصراع الإقليمي طويل الأمد على النفوذ بين إيران والسعودية. ومع تزايد تأطير الخلافات السياسية في أطر طائفية، يكمن الخطر في ضربة ارتدادية تبتلع المنطقة كلها.
وفي هذا المفترق الحاسم، يبدو القادة الإقليميون وكأنهم ينهجون أحد نهجين، كلاهما ذو تأثير عكسي. فهم إما يغضون الطرف عن خطاب الكراهية المستوحى من الدين، أو يتلاعبون بالطائفية لمصلحتهم الخاصة. في الشهر الماضي في القاهرة، حضر رئيس الجمهورية في ذلك الوقت محمد مرسي مؤتمراً ندّد فيه دعاة سنة بالإسلام الشيعي. وبعد أسبوعين أخفق في إدانة جرائم القتل الطائفية الصريحة لأربعة من الشيعة المصريين في قرية على أطراف القاهرة.
أما النظام الملكي السعودي، الذي دأب على ترويج تيار محافظ وقليل التسامح من الإسلام السني لدعم شرعيته السياسية، فهو يلعب بورقة الطائفية لقمع أقليته الشيعية، واستغلال مطالب الديمقراطية وحقوق الإنسان لتدعيم نفوذه الإقليمي. وتقمع البحرين أكثريتها الشيعية، وتهيج النزعات الطائفية في الداخل، على أساس مجابهة تهديد مفترض من إيران. إن بعض نماذج الخطاب الطائفي التحريضي الأكثر ضراوة تأتي من الدعاة السنة في منطقة الخليج العربي، الذين يقدر أتباعهم على تويتر وفيسبوك بالملايين.
فما الذي يمكن فعله حيال هذا؟
لا يتمثل الحل في قمع الحق في السخرية من ديانة شخص آخر وإهانتها. حين تقمع الحكومة خطاب الكراهية فكثيراً ما يكون دافعها هو استرضاء المتعصبين ذوي النفوذ الذين يزعمون تمثيل الأغلبية، بدلاً من حماية الأقليات المستضعفة. ومن الأمثلة على هذا الملاحقات القضائية بتهمة ازدراء الأديان للمنتمين إلى ديانات الأقلية في باكستان ومصر. كثيراً ما يكون ضحايا القوانين التي تعاقب خطاب الكراهية هم عين الأشخاص المستهدفين بأخطر نماذج خطاب الكراهية. ولعله من الأفضل أن تلغى كافة القوانين التي تجرم ازدراء الأديان.
ومع ذلك فإن قمع خطاب الكراهية ضروري حينما يتحول إلى تحريض مباشر على العنف. وفي مثل تلك الحالات تقع على عاتق الحكومات مسؤولية ملاحقة المسؤولين عن التحريض والعنف على السواء. لكن بالنظر إلى مخاطر قمع التعبير المشروع عن الرأي، وخاصة في منطقة كثيراً ما تقوم الحكومات السلطوية فيها بزج المنتقدين في السجون وإسكات أصواتهم، فإن من الواجب مجابهة خطاب الكراهية الذي لا يتجاوز حدود التحريض بالإدانة والوصم بدلاً من القمع.
وقد بدأت بعض الشخصيات البارزة تتخذ موقفاً جاداً، ففي مايو/أيار أصدر مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق، ومحمد خاتمي الرئيس الإيراني السابق، نداءً بوضع حد للعنف الطائفي المميت بين السنة والشيعة، ودعيا منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل قوة مهام تعالج هذه القضية. كما أطلقت المنظمة نفسها في 2005 مبادرة مدتها 10 سنوات لمعالجة التوترات الطائفية داخل العالم الإسلامي.
لكن دعم فرق العمل والحوار والمصالحة لا تكفي، فعلى عدد أكبر من القادة أن يرفعوا أصواتهم بقوة، وليس الرؤساء ورؤساء الوزارة السابقين فقط، بل المسؤولون الحاليون، ومعهم الزعماء الدينيون وقادة الأحزاب السياسية وأصحاب التأثير من الكتاب والإعلاميين. وعلى الدول أن تتوقف عن ملاحقة أقلياتها (أو أكثرياتها المقموعة) وتهميشها والتضييق عليها، وأن تقبل أفرادها كأعضاء كاملي الأهلية والمساواة في المجتمع.
إن ما نشهده اليوم من طائفية قبيحة وانعدام للتسامح الديني هو نتيجة جزئية للتقلبات في دول كسوريا والعراق، ذات التراث العريق من التنوع الديني. كما أنه محصلة أنماط راسخة من السلطوية والتمييز والإفلات من العقاب. والحل الوحيد على المدى الطويل هو الإصلاح السياسي، وإنشاء مؤسسات الدولة التي تحمي حقوق الإنسان وقيم المساواة والشمول والتعددية وتعزز احترامها.
توم بورتيوس هو نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش. على تويتر: @tomporteous