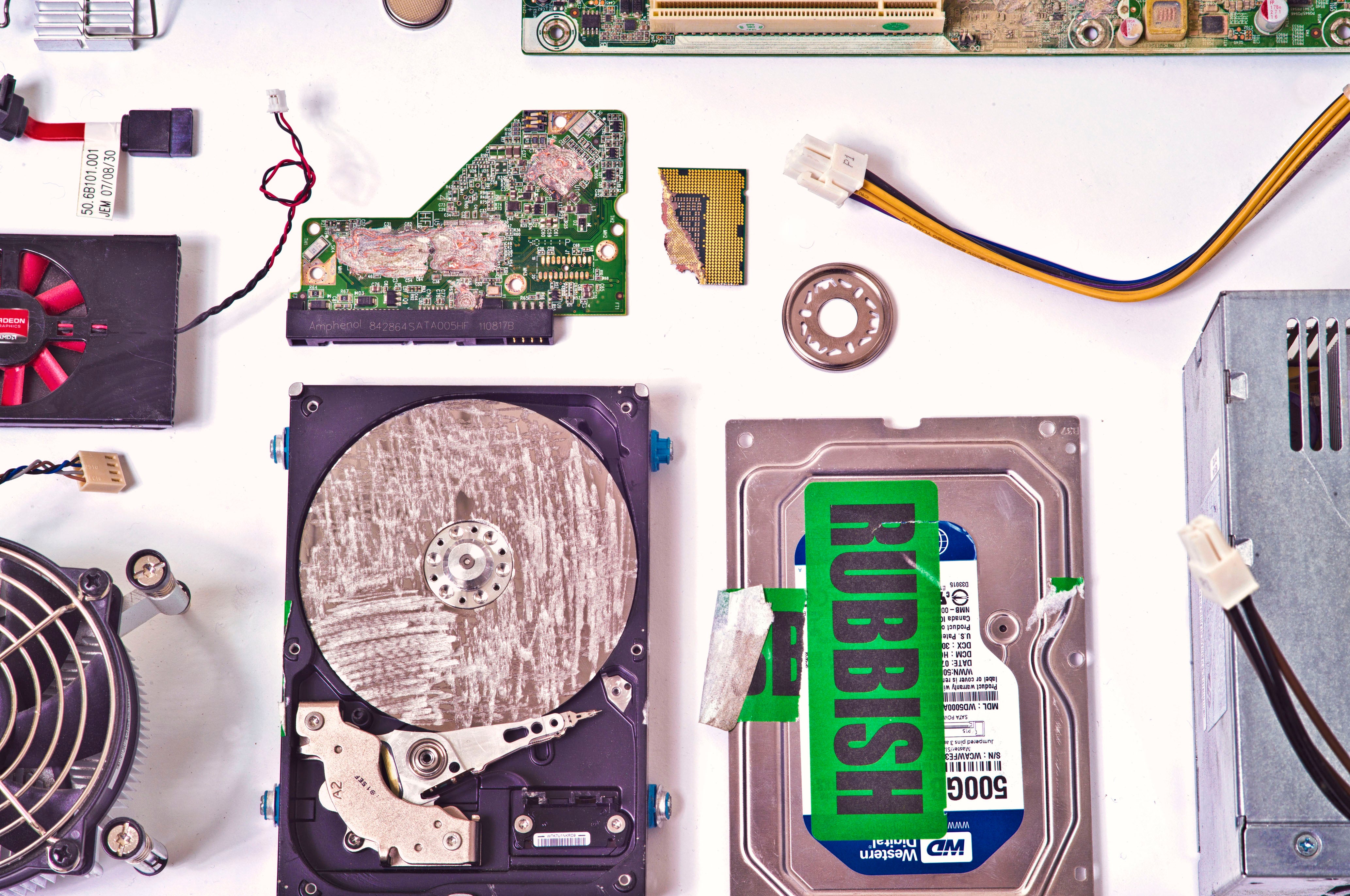لم يشهد العالم مثل هذا الاضطراب منذ جيل كامل، فالربيع العربي قد أخلى المكان للنزاع والقمع في كل مكان تقريباً. والمتطرفون الإسلاميون يرتكبون الفظائع الجماعية ويهددون المدنيين في أنحاء الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا وأفريقيا. والتوترات الشبيهة بتوترات الحرب الباردة عادت لتطل برأسها على أوكرانيا، لدرجة إسقاط طائرة ركاب مدنية من السماء. ويبدو الأمر أحياناً كما لو أن نسيج العالم يتفكك.
وقد استجابت حكومات عديدة للاضطرابات بالاستخفاف بحقوق الإنسان أو تجاهلها، فالحكومات التي تمسها القلاقل مباشرة تسارع في أغلب الأحيان لإيجاد الأعذار لقمع الضغوط الشعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي. أما الحكومات ذات النفوذ فإنها تجد راحتها في الاتكاء على علاقاتها المألوفة مع المستبدين، أكثر من التعامل مع الحكم الشعبي وخلوه من اليقين. وتواصل بعض تلك الحكومات إثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن أكثرها تبدو وكأنما خلصت إلى أن التهديدات الأمنية الخطيرة في عالم اليوم لها أسبقية حتمية على الحقوق، ولسان حالها يقول إن على حقوق الإنسان التراجع عن الصدارة، في هذه اللحظة الصعبة؛ فهي رفاهية تناسب أزمنة أقل ضيقا وتوتراً.
بيد أن نزع الأولوية عن الحقوق على هذا النحو ليس خطأً فقط، بل هو أيضاً من قبيل قصر النظر الذي يأتي بأثر عكسي، فقد قامت الانتهاكات الحقوقية بدور كبير في توليد معظم أزمات اليوم أو مفاقمتها، ومن شأن حماية الحقوق، وتمكين الناس من إبداء رأيهم في كيفية تصدي حكوماتهم للأزمة، أن يمثلا مفتاح الحل. إن حقوق الإنسان بوصلةٌ لا غنى عنها للتحرك السياسي، وبخاصة في أزمنة التحديات والخيارات الصعبة.
صعود داعش
لم يشهد العام الماضي تحدياً، انفجر على نحو درامي، كما فعله ظهور التنظيم المتطرف الذي لقب نفسه بالدولة الإسلامية، والمعروف أيضاً باسم داعش. ولا يسع المرء سوى أن يشعر بالترويع أمام إعدام داعش الجماعي للمحاربين الأسرى والمدنيين الذين لا يحظون برضى الجماعة. واستهدفت تلك الجماعة السنية المسلحة الإيزيديين والتركمان والأكراد والشيعة، بل وبعض السنة المعارضين لتفسيرها المتطرف للشريعة الإسلامية، وقام محاربوها باسترقاق سيدات وفتيات إيزيديات وتزويجهن قسراً واغتصابهن، وقاموا بقطع رؤوس صحفيين وعمال إغاثة في مشاهد مروعة صورتها كاميرات الفيديو. ونادراً ما جوبهت قوة مسلحة بهذا القدر من النفور والمعارضة واسعة الانتشار.
ومع ذلك فإن داعش لم تنشأ في فراغ، فهي نتيجة جزئية للحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق واحتلاله الذي بدأ في 2003، مما خلف، فيما خلف، فراغاً أمنياً، والانتهاكات بحق محتجزي سجن أبو غريب وغيره من مراكز الاحتجاز المُدارة أمريكيا ً. كما أن تمويل الجماعات المتطرفة من دول الخليج ومواطنيه لعب دوراً في هذا السياق. ومؤخراً، كانت السياسات الطائفية للحكومتين العراقية والسورية، وعدم الاكتراث الدولي بانتهاكاتهما الحقوقية الجسيمة، من العوامل المؤثرة. وإذا تُركت الظروف التي أدت إلى داعش على حالها، فإن الجماعة قد تحكم قبضتها على البلدين وتتمدد في لبنان والأردن وليبيا وما وراءها.
العراق
تدين داعش بأكبر الفضل في ظهورها في العراق للحكم الطائفي الحافل بالانتهاكات لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وما أدى إليه من تثوير للمجتمعات السنية. وبدعم إيراني، تولى المالكي شخصياً قيادة قوات الأمن العراقية، وأيد تشكيل مليشيات شيعية قام كثيرٌ منها باضطهاد الأقلية السنية. كما تم استبعاد السنة من مناصب حكومية منتقاة، واعتقالهم واحتجازهم تعسفياً بموجب قوانين جديدة فضفاضة، وإعدامهم ميدانياً، وقصفهم عشوائياً.
ومن الممكن قياس شدة الاضطهاد من آثاره، فقد هُزم التنظيم الذي سبق داعش، ألا وهو تنظيم القاعدة في العراق، بمعونة ائتلاف عسكري من القبائل السنية في غرب العراق يُعرف باسم مجلس الصحوات. إلا أن الكثير من القبائل التي هزمت لوحدها تنظيم القاعدة في العراق؛ استبد بها الخوف من الذبح والاضطهاد على أيدي قوات الأمن الموالية للحكومة حتى أنها، عند اندلاع نزاع جديد في 2014، وجدت أن محاربة تلك القوات تشعرها بالأمن أكثر من محاربة داعش.
وقد دأبت المنظمات الحقوقية على لفت الأنظار إلى حُكم المالكي الحافل بالانتهاكات، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، وفي لهفتها على تناسي تورطها العسكري في العراق، غضت الطرف عن هذا الحكم الطائفي ـ بل واسترضته بالسلاح.
وهناك اليوم إقرار واسع النطاق بأن التغاضي عن الفظائع في عهد المالكي كان خطأ. لقد عُزل المالكي بالقوة في النهاية، وحل محله حيدر العبادي، الذي تعهد بنبذ الإقصاء في الحكم. لكن مع استمرار تدفق المساعدات العسكرية الغربية إلى العراق، فإن الطائفية لم تنته. وما زال المالكي يشغل منصبا رسمياً كواحد من نواب الرئيس العراقي الثلاثة، أما الحكومة الضعيفة فقد زادت كثيراً من اعتمادها على المليشيات الشيعية، وسمحت بتجنيد ما يقرب من مليون مقاتل شيعي بدون إشراف أو تنظيم حكومي. بل إن المليشيات، بسبب اضطراب أحوال الجيش العراقي، هي القوة البرية الرئيسية التي تحارب داعش، رغم استمرارها في قتل السنة أو طردهم بدعوى التعاطف مع داعش. ولحين انتهاء هذه الفظائع، يُرجح قيام المليشيات الشيعية بما من شأنه تعزيز التجنيد لداعش، أكثر من دحرها في ميدان القتال.
وفي تلك الأثناء لم تضع الحكومة العراقية حداً لهجماتها العسكرية العشوائية عديمة التمييز على المناطق المدنية، ولا أفرجت عن أعداد ضخمة من المحتجزين بدون مذكرات قانونية أو بعد استكمال عقوباتهم. كما يظل القضاء الفاسد المسئ من دون إصلاح، وتظل مطالبة العبادي بإنهاء الحكم الإقصائي المسئ بغير تنفيذ. إن استكمال تلك الإصلاحات لن يقل أهمية على المدى الطويل عن العمليات العسكرية لحماية المدنيين من فظائع داعش.
سوريا
تدين داعش بصعودها في سوريا لعدة عوامل، تشمل الحدود الرخوة مع تركيا التي أتاحت تدفق المقاتلين المسلحين والممولين من حكومات أجنبية. وقد انضم كثيرون منهم إلى الجماعة المتطرفة. كما اكتسبت داعش الأموال عن طريق اقتضاء الفديات الباهظة و"الضرائب" من الأشخاص في ما تسيطر عليه من أراضي، إضافة إلى مبيعات النفط والآثار السورية.
وبهذه اللبنات، تمكنت داعش من تقديم نفسها بصفتها القوة الأقدر على التصدي لوحشية الرئيس بشار الأسد وقواته. فقد كانت قوات الأسد، في قسوة بالغة، تتعمد مهاجمة المدنيين الذين تصادفت إقامتهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة، بهدف إفراغ تلك المناطق من سكانها ومعاقبة المتعاطفين المفترضين مع المتمردين.
ومنذ قامت الحكومة السورية بتسليم أسلحتها الكيماوية، صار أشهر أدواتها هو القنبلة البرميلية، أي برميل النفط أو ما شابهه من الأوعية المحشوة بمواد عالية الانفجارية وشظايا المعادن. وتقوم القوات الجوية العراقية أيضاً باستخدام القنابل البرميلية، لكنها اكتسبت صيتها في سوريا حيث تقوم القوات الجوية عادة بإلقائها من مروحية تحوم على ارتفاعات عالية لتجنب النيران المضادة للطائرات. ومن ذلك الارتفاع يستحيل توجيه القنبلة البرميلية بأي قدر من الدقة، فهي تهوي إلى الأرض لا غير، مصدرة فحيحها المخيف فيما تتقلقل محتوياتها حتى تضرب الأرض وتنفجر.
إن القنابل البرميلية من انعدام الدقة حتى أن الجيش السوري لا يجرؤ على استخدامها قرب خطوط الجبهة، مخافة إصابة قواته، بل إنه يتوغل بها في الأراضي الخاضعة لسيطرة المتمردين، رغم علمه بأنها ستدمر بنايات سكنية ومستشفيات ومدارس وغيرها من منشآت الحياة المدنية. وقد جعلت تلك الأسلحة عديمة التمييز حياة الكثير من المدنيين من التعاسة لدرجة أن بعض الذين لم يغادروا البلاد اختاروا نقل عائلاتهم قرب خط الجبهة، مفضلين مواجهة القناصة والمدفعية على فظاعة القنابل البرميلية.
وحين قامت الحكومة السورية بالاعتداء على مدنيين بأسلحة كيماوية، مارس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضغط على الأسد للتوقف وتسليم أسلحته. ولكن بما أن الحكومة السورية قتلت مدنيين أكثر بكثير في هجمات عشوائية بأسلحة تقليدية مثل القنابل البرميلية، علاوة على الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والصواريخ غير الموجهة؛ فإن مجلس الأمن قام إلى حد بعيد بدور المتفرج. وقد أصدر عدد من الدول إدانة للمذابح، لكنها لم تفعل شيئاً يذكر لتوليد الضغط الكفيل بإنهائها.
واستغلت روسيا حق النقض الذي تتمتع به في مجلس الأمن لوقف الجهود الموحدة لإنهاء المذابح. كما رفضت روسيا وإيران استخدام نفوذهما الهائل في دمشق للضغط من أجل إنهاء الهجمات العشوائية، رغم مطالبات من مجلس الأمن، بما فيه روسيا، بوقف تلك الهجمات. أما إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتصدي للجرائم الدولية من جانب كافة الأطراف، وهي الخطوة التي أيدها 65 بلداً، فما زالت محرمة في نظر موسكو.
وقد تصدى ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة لداعش، لكن دولة واحدة ـ سواء كانت من الخصوم كالولايات المتحدة، أو المؤيدين كروسيا وإيران ـ لم تصعّد الضغط على الأسد لوقف ذبح المدنيين. والفصل السهل بين الاثنين غير ممكن، وغير جائز.
وقد كان هذا الانشغال الانتقائي هدية لمن يجندون لحساب داعش، ويقدمون أنفسهم على أنهم الوحيدون المستعدون والقادرون على التصدي لفظائع الأسد. ومن الواضح أن الاكتفاء بمهاجمة داعش لن يقضي على جاذبيتها، فهناك حاجة إلى انشغال أوسع بحماية المدنيين السورييين.
تصاعد القمع في مصر
في مصر سعى حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي تحول إلى رئيس إلى سحق التطلعات الديمقراطية لميدان التحرير. وكانت الانتفاضة التي خلعت الحكومة التسلطية للرئيس حسني مبارك قد منحت مصر أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، ففاز بها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي. لكن حكومة مرسي حكمت على نحو أشعر الكثيرين من المصريين بالخوف (سواء عن حق أو غير ذلك) من التكشف التدريجي لنظام إسلامي صارم، إلا أن إساءاته لم تقترب قط مما يتعرض له المصريون الآن على يد الحكومة التي يهيمن عليها الجيش والتي عزلت مرسي في 30 يونيو/حزيران 2013.
عمل الانقلاب العسكري بقيادة السيسي على تحطيم الإخوان ومؤيديهم، وفي 12 ساعة فقط يوم 14 أغسطس/آب 2013 قامت قوات أمنية يشرف عليها السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وعلى نحو ممنهج، بإطلاق النار وقتل ما لا يقل عن 817 شخصاً معظمهم من المتظاهرين السلميين في ميدان رابعة بالقاهرة، حيث كانوا قد أقاموا اعتصاماً استمر أسابيع للاحتجاج على عزل مرسي.
ادعت قوات الأمن أنها كانت تدافع عن نفسها، لكن حفنة الخسائر التي لحقت بها تشحب مقارنة بأعداد المتظاهرين الذين قتلهم القناصة وغيرهم من المسلحين، أثناء التماسهم المساعدة الطبية في حالة كثيرين منهم. وكانت السلطات المصرية قد خططت لفض الاعتصام بالقوة قبل أسابيع، وتوقعت حصيلة قتلى كبيرة. وكانت النتيجة أكبر مذبحة لمتظاهرين في التاريخ الحديث ـ والأكثر دموية على الأقل منذ قمع الصين لحركة ميدان تيانانمين المطالبة بالديمقراطية في 1989.
ومنذ الانقلاب قامت قوات أمن السيسي بسجن عشرات الآلاف من المشتبه في انتمائهم إلى الإخوان المسلمين، بدون اتهامات أو محاكمة في أحيان كثيرة، إضافة إلى العديد من النشطاء العلمانيين. وأصدرت المحاكم المصرية أحكام الإعدام بالمئات بعد محاكمات جماعية تخلو من أي تظاهر بالتثبت من الإدانة الفردية أو تقديم فرصة جادة للدفاع.
أما رد فعل المجتمع الدولي على هذا القمع غير المسبوق فقد اتسم بقصور مخجل. ففي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام 27 بلداً بالضغط على مصر للتحقيق في مذبحة ميدان رابعة، لكنها لم تحقق أغلبية داخل المجلس. ولا يوجد استعداد يذكر داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحكومات الأوروبية الرئيسية للنظر في انتهاكات الحكومة العسكرية. بل إن الولايات المتحدة ستقوم بتطبيق عقوبات انتقائية على مسؤولين في فنزويلا (وهو التحرك الذي يلقى تأييدنا) بسبب ردود قواتهم الأمنية الوحشية على المظاهرات ـ التي حصدت أرواح ما لا يزيد عن بضعة عشرات من المتظاهرين (رغم أنها اضطهدت كثيرين آخرين) ـ لكنها حاربت فرض العقوبات على مصر، رغم قيام الحكومة بقتل ما يقرب من ألف شخص في ميدان رابعة.
قام الكونغرس بقطع بعض المعونات العسكرية، رغم أن إدارة أوباما ترددت في تسمية الاستيلاء على الحكم بأنه "انقلاب" مخافة تداعيات أبعد بموجب القوانين الأمريكية. وتحدث وزير الخارجية كيري مراراً عن انتقال ديمقراطي يفترض أنه يتم في مصر رغم غياب الأدلة الداعمة. أما وقد أضاف الكونغرس الآن استثناءً جديداً يتعلق بالأمن القومي لشروط المعونات العسكرية المعمول بها فمن الأرجح أن تعيد الحكومة الأمريكية معظم دعمها العسكري للقاهرة، إن لم يكن كله، بدون أي تخفيف للقمع. إن هذا التعجل لإعادة فتح صنبور المساعدات مدفوع بأولوية تهيئة الجيش المصري لكبح جماح تمرد مسلح في سيناء، ودعم إسرائيل في حربها على حماس في غزة، ومساندة الحرب على داعش في سوريا والعراق، على حساب حقوق الشعب المصري. كما أن حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وغيرها في أوروبا لم تفعل شيئاً يذكر للتصدي لحملة السيسي القمعية غير المسبوقة.
وقد أبدت السعودية والإمارات حرصاً كبيراً على مساعدة مصر في سحق الإخوان المسلمين، فهما كدولتين ملكيتين تتذرعان بالإسلام لصالح شرعية الحكم فيهما، يبدو عليهما الذعر من حركة دينية تحكم باسم الإسلام ومع ذلك تعتنق الانتخابات الديمقراطية. وقد أنفقتا مليارات الدولارات في مشروع السيسي القمعي، وصنفتا الإخوان كجماعة إرهابية. كما طاردت الإمارات من تعتبرهم ممثلين لآراء الإخوان على أراضيها.
إن الدعم الدولي لحكومة السيسي القمعية لا يقتصر على كونه كارثة بالنسبة لآمال المصريين في مستقبل ديمقراطي، فهو يرسل رسالة مفزعة للمنطقة. وبوسع داعش الآن أن تزعم أن العنف هو سبيل الإسلاميين الوحيد إلى السلطة، لأنهم حينما طلبوا السلطة في انتخابات نزيهة وفازوا بها، تم خلعهم بغير احتجاج دولي يذكر. ومرة أخرى تعمل المصلحة قصيرة الأجل لبعض القوى المؤثرة ـ قمع الإخوان المسلمين ـ على التهديد بإخفاق طويل الأجل بالنسبة لمستقبل المنطقة السياسي.
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
شهد العام الماضي المزيد من البناء الاستيطاني من جانب إسرائيل، والمزيد من العنف الانتقامي في الضفة الغربية، وجولة أخرى من النزاع المسلح الدموي في غزة. قامت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة بإطلاق الآلاف من الصواريخ وقذائف الهاون العشوائية في اتجاه تجمعات سكنية إسرائيلية. وفي بعض الحالات قام حماس وحلفاؤها بتعريض مدنيين فلسطينيين للخطر دون داع من خلال القتال انطلاقاً من مناطق مأهولة، كما أعدموا خونة فلسطينيين مزعومين ميدانياً.
وكذلك فإن عشرات الآلاف من هجمات الصواريخ والقنابل والمدفعية الإسرائيلية، إضافة إلى تعريف فضفاض للأهداف العسكرية، والهجمات التي ليس لها هدف عسكري ظاهر، والتراخي في الاهتمام بخسائر المدنيين، قد خلفت كلها ما يقدر بـ1500 وفاة مدنية في غزة، ودماراً لم يسبق له مثيل للمنازل والبنى التحتية المدنية. وفي الضفة الغربية المحتلة، بخلاف التوسع الاستيطاني، واصلت إسرائيل عمليات هدم المنازل الفلسطينية التمييزية والعقابية، والاستخدام غير الضروري للقوة المميتة بحق فلسطينيين، فقتلت العشرات وبينهم أطفال.
ولدى إسرائيل سجل ردئ فيما يتعلق بمحاسبة قواتها على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، أما حماس فلم تدّع مجرد التحقيق في انتهاكات المقاتلين الفلسطينيين. ومن شأن إشراك المحكمة الجنائية الدولية أن يفيد في ردع الجانبين عن ارتكاب جرائم الحرب، بينما يمنح الضحايا فرصة الحصول على قدر من العدالة. إن فلسطين بوضعها كدولة مراقب في الأمم المتحدة مؤهلة للانضمام إلى المحكمة، وقد قامت بتدشين بداية العام الجديد بالانضمام للمحكمة فعلاً. ويشمل اختصاص المحكمة جرائم الحرب المرتكبة في أراض فلسطينية أو انطلاقاً منها، أي أن تفويضها سينطبق على طرفي النزاع.
ومع ذلك فقد حاولت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي منع حصول هذا التطور من خلال ممارسة ضغوط مُضللة على فلسطين كي لا تنضم إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وكان مبررهم أن إشراك المحكمة لن يفيد عملية السلام المحتضرة. إلا أنهم يتبنون الموقف المعاكس في أي وضع آخر من أوضاع جرائم الحرب واسعة النطاق، حيث يقرون بأن وضع حد للجرائم كثيراً ما يكون شرطاً مسبقاً لبناء الثقة اللازمة لمباحثات سلام مثمرة. كما لم يقدم أحد أي تبرير له مصداقية لاستثناء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من هذه القاعدة.
إن الدافع الحقيقي للحكومات الغربية هو حماية الإسرائيليين من الملاحقة المحتملة. وهذا النوع من التبني الانتقائي يقوض سلطة العدالة الدولية ومشروعيتها في أنحاء العالم، كما يشجع المنتقدين القائلين بأن العدالة الدولية محجوزة للأمم الضعيفة التي ليس لها حلفاء من الأقوياء.
فظائع بوكو حرام في نيجيريا
ولا تقتصر مشكلة تغليب القلاقل على الحقوق على الشرق الأوسط، فبواعث القلق الحقوقية في القلب من النزاع النيجيري، حيث تقوم الجماعة الإسلامية المتشددة بوكو حرام بمهاجمة المدنيين إضافة إلى قوات الأمن النيجيرية. وقد اشتهرت الجماعة بالقسوة في زرع القنابل في الأسواق والمساجد والمدارس وقتل آلاف المدنيين. وفي العام الماضي اختطفت بوكو حرام المئات من طالبات المدارس والفتيات في منطقة الشمال الشرقي. وأجبرت بعضهن على الزواج من مقاتلين كما تعرضن للعنف الجنسي. وفي أبريل/نيسان أدت عملية اختطاف جماعية إلى حملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "#أعيدوا_بناتنا" إلا أن هؤلاء الضحايا وكثيرات غيرهن ما زلن قيد الأسر.
والمفترض أن تتمكن نيجيريا الغنية بالنفط من حيازة جيش مهني يحترم الحقوق ويقدر على حماية النيجيريين من هذه الجماعة المسيئة، إلا أن قيادة البلاد تركت جيشها في حالة من سوء التجهيز ونقص الدافعية لصد هجمات بوكو حرام.
وحين تحرك الجيش فكثيراً ما جاءت تحركاته على نحو مُسئ؛ باعتقال المئات من الرجال والصبية المشتبه في تأييدهم لبوكو حرام، واحتجازهم في ظروف لاإنسانية، والإساءة البدنية إليهم أو حتى قتلهم. وقد اختفى الكثيرون من أفراد المجتمع قسرياً على أيدي قوات الأمن كما تردد المزاعم. وحينما فر بعض المشتبه في انتمائهم إلى بوكو حرام في مارس/آذار من مرفق احتجاز ذاع صيت انتهاكاته، ألا وهو ثكنة غيوا، ظهرت تقارير تفيد بأن قوات الأمن النيجيرية أعادت اعتقال المئات منهم وأعدمتهم ميدانياً.
أما غياب المحاسبة المستمر على هذه الفظائع فقد جعل من الصعب على حلفاء نيجيريا تزويدها بالمساعدات الأمنية مخافة تحولهم إلى متواطئين في الانتهاكات. كما أن إخفاق القيادة النيجيرية في كبح جماح قوات الأمن قد استعدى مجتمعات محلية كان يمكنها تقديم المعلومات الاستخبارية طواعية للسلطات. إن الفوز بـ"قلوب وعقول" السكان المدنيين سيتطلب إجراء الحكومة لتحقيق شفاف في انتهاكات الجيش ومعاقبة الجناة.
رد فعل كينيا المسئ على "الشباب"
وكما كان حال نيجيريا، شهدت كينيا بدورها تصاعداً كبيراً في الاعتداءات المتطرفة على المدنيين، الراجعة ولو جزئيا لردود أفعال القوات الأمنية المسيئة، فقامت جماعة الشباب الصومالية الإسلامية المتمردة بشن أبرز هجماتها على مجمع تجاري في نيروبي، وعلى إمبيكيتوني والقرى القريبة منها بطول ساحل كينيا، وفي شمال شرق مانديرا.
واتسم رد الفعل الكيني بالإساءة، فبدلاً من بناء الثقة الشعبية في قدرة قوات الأمن على مكافحة الاعتداءات، قامت عمليات قوات الأمن بتوليد الغضب والتوجس الشعبي. وفي أبريل/نيسان، بعد موجة من التفجيرات وهجمات القنابل اليدوية في نيروبي، نفذ الجيش والشرطة عملية "أوسالاما واتش" في حي "إيستلي" بالمدينة ـ وكانت حملة كاسحة تنطوي على انتهاكات حقوقية لطالبي اللجوء واللاجئين المسجلين، والصوماليين الذين لا يحملون وثائقاً وغيرهم من الأجانب، والكينيين من أصول عرقية صومالية. وكما في العمليات السابقة، قامت الشرطة الكينية باحتجاز عدة آلآف من الأشخاص تعسفاً، واستخدمت القوة المفرطة في مداهمة المنازل وابتزاز سكانها والإساءة البدنية إلى ذوي الأصول الصومالية.
وفي تلك الأثناء تراكمت الأدلة على قيام وحدات مكافحة الإرهاب الكينية بعمليات إخفاء قسري وإعدام ميداني للإرهابيين المشتبه بهم بدلاً من تقديمهم للمحاكم. وبدلاً من الرد على الاستنكار الشعبي، حاولت الحكومة تكميم الأفواه بالمزيد من الصلاحيات لقوات الأمن وتقوية الضوابط التشريعية المقيدة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني وغيرها من مصادر النقد المستقل. وتباطأت الدول المانحة، وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التي تقدم دعماً كبيراً لقوات الأمن الكينية في مجال مكافحة الإرهاب، تباطأت في الاستجابة لمتن الأدلة المتراكم على هذا السلوك المسئ.
روسيا والأزمة في أوكرانيا
مثل احتلال روسيا للقرم الأوكراني ومساعداتها العسكرية للمتمردين في شرق أوكرانيا تحديات سياسية وأمنية كبرى للحكومات الغربية. وينطوي لب النزاع على قضايا تتعلق بالسيادة وليس لـ هيومن رايتس ووتش أي انحياز فيها، إلا أن رد الفعل الغربي الضيق نسبياً على الانتهاكات الحقوقية المتزايدة والتي ظلت تختمر في روسيا على مدار العامين الماضيين يمكن أن يكون قد ساهم في مفاقمة الأزمة الأوكرانية.
لقد مارست الحكومات الغربية ضغوطات سياسية مكثفة على روسيا، بما فيها العقوبات المستهدفة، لتشجيعها على الانسحاب من القرم والتوقف عن تأييد المتمردين. ومع ذلك فقد بالغت تلك الحكومات إما في التهوين من الحكم السلطوي المتنامي في روسيا منذ عودة بوتين إلى الكرملين، أو تعثرت في الاستجابة له.
لقد شرع الكرملين في 2012، وبدافع الخوف من "ثورة ملونة"، في ما تحول إلى أشد حملة قمعية على المعارضة منذ الحقبة السوفييتية. وباستهداف المنظمات الحقوقية، والمعارضين، والصحفيين المستقلين، والمنتقدين على الإنترنت، قلصت الحكومة الروسية جذرياً من احتمالات وصول الأصوات الانتقادية إلى أعداد كبيرة من الناس. ومكن نظام المعلومات المغلق الناجم عن هذا، مكن الكرملين من قمع معظم النقد العلني لأفعاله في أوكرانيا. ومن اللازم أن تصبح صحة الحقوق السياسية في روسيا جزءاً مركزياً من أي جهد لحل النزاع الأوكراني، لكنها لم تكن كذلك.
وعلى نفس المنوال مال الغرب، العالق في ما يبدو أحياناً وكأنه حرب باردة جديدة مع روسيا بسبب أوكرانيا، مال إلى الانكفاء على عقلية الخير مقابل الشر، فالرغبة في تصوير أوكرانيا كضحية بريئة للعدوان الروسي جعلت الغرب يتردد في تحدي الجوانب المثيرة للانزعاج من سلوك أوكرانيا، سواء كانت استخدام "الكتائب التطوعية" التي تنتهك حقوق المحتجزين على نحو اعتيادي، أو إطلاق النار دون تمييز على المناطق المأهولة. وفي الوقت نفسه قامت القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا بانتهاك حقوق المحتجزين، وعرضت تجمعات سكانية مدنية للخطر بإطلاق الصواريخ من قلبها. وأدى التردد الغربي في التصدي للانتهاكات الأوكرانية إلى تسييس ما يجب أن يكون نداءً قائماً على المبادئ إلى الجانبين بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ـ وهو النداء الذي من شأنه إذا نجح أن يخفض درجات الحرارة ويرفع احتمالات التوصل إلى حل سياسي أوسع نطاقاً.
حملة الصين القمعية على الإيغور في شينجيانغ
يتمثل توجه الحكومة الصينية إزاء شينجيانغ، وهي المقاطعة الشمالية الغربية التي تؤوي أقلية الإيغور المسلمة، في الرد على الشكاوى من انتهاك حقوق الإنسان بالمزيد من انتهاك حقوق الإنسان وفرض المزيد من القيود. وتزعم بكين أن حملتها القمعية ضرورية لمحاربة النزعات الانفصالية والإرهاب، إلا أن تكتيكاتها تمثلت في فرض أشد السياسات قمعية وتمييزاً ضد الإيغور، بما فيها حظر إطلاق اللحى وارتداء الحجاب، وفرض القيود على الصوم، والتمييز الصريح فيما يتعلق بالتعليم الديني.
ولعل الهجمات الدموية المتصاعدة ضد المدنيين وقوات الأمن في شينجيانغ من أكبر بواعث القلق للحكومة، لكن سرعة الحكومة في نسبة العنف إلى "إرهابيي الإيغور" ـ مع ندرة إبراز أدلة وحرمان المشتبه بهم روتينياً من الحق في المحاكمة العادلة ـ توجد حلقة مفرغة يشعر فيها الإيغور المقموعون بالفعل بأنهم تحت حصار مستمر من الدولة. ومن المعلومات القليلة المتاحة للجمهور العام، يستحيل القيام بأي قدر من الثقة بتقييم لمدى مسؤولية من تتم إدانتهم والحكم عليهم في أحيان كثيرة بالإعدام عن العنف، وما إذا كانت إجراءات الحكومة القاسية لمكافحة الإرهاب تستهدف الأشخاص المطلوبين بالفعل.
وكما يتجلى في حكم السجن المؤبد، غير العادي في قسوته، الصادر في سبتمبر/أيلول على إلهام توختي، وهو باحث اقتصادي إيغوري معتدل، فإن الدولة تظل غير مستعدة للتمييز بين النقد السلمي والضلوع في العنف. إن الملاحقة القاسية للنقد السلمي، بحيث لا تكاد تترك مساحة للحرية الدينية أو الثقافية، والتوسع في استراتيجية اقتصادية يعجز الإيغور فيها عن التنافس مع المهاجرين الصينيين من عرقية الهان على قدم المساواة، هي وصفة لزيادة العنف.
حرب المكسيك على المخدرات الحافلة بالإساءات
بدءاً من 2007 شرعت حكومة رئيس الجمهورية آنذاك فيليبي كالديرون في "حرب على المخدرات" في المكسيك، فنشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة لمحاربة كارتيلات المخدرات العنيفة في البلاد. وكانت النتيجة وباءً من عمليات الإعدام الميدانية والاختفاء القسري والتعذيب بأيدي الشرطة والجيش، وعنف متصاعد وسط المنظمات الإجرامية المتنافسة، وكارثة في الأمن العام حصدت أرواح ما يزيد على 90 ألف مكسيكي. وقد عمل الرئيس الحالي إنريكي بينيا نييتو خلال العامين اللذين قضاهما في منصبه على تخفيف نبرة الخطاب، لكنه لم يحقق تقدماً يذكر في تقليص الفساد والإفلات من العقاب اللذين يسمحان بازدهار تلك الفظائع.
وقد أيدت واشنطن سياسات المكسيك في "الحرب على المخدرات"، بتوفير المساعدات لقوات الأمن في البلاد، مع تقديم الثناء المتكرر لجهودها في مواجهة الكارتيلات. لكن ما لم تفعله هو الجهر بذكر الانتهاكات المروعة التي ترتكبها تلك القوات، أو إنفاذ شروط حقوقية وضعها الكونغرس الأمريكي لقسم مما تحصل عليه من مساعدات. وبدلاً من إحراج حليف هام والمجازفة بالعلاقات الثنائية في مجالات مكافحة المخدرات وغيرها من الأولويات السياسية، فضلت إدارة أوباما التزام الصمت، فسهلت جهود المكسيك في التهوين من مشاكلها الحقوقية الجسيمة.
إلا أن بعض الولايات الأمريكية فعلت المزيد، من خلال إباحة الماريجوانا ومن ثم تقويض السوق غير المشروعة لهذا المخدر. وقد وافقت إدارة أوباما على هذه المبادرات إلا أنها لم تعتنقها، وهو ما يجب عليها فعله. فهي ليست التصرف الصحيح فحسب من وجهة نظر الحق في الخصوصية، لكنها أيضاً خطوة هامة لقطع الطريق على الأرباح التي تغذي تهريب المخدرات.
الولايات المتحدة: المخابرات المركزية تعذب بدون عقاب
اختتم العام بقيام لجنة المخابرات المنتقاة في مجلس الشيوخ بنشر ملخص منقح لتقريرها عن استخدام وكالة المخابرات المركزية للتعذيب بحق إرهابيين مشتبه بهم، في عهد إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
وقد اتخذ الرئيس أوباما موقفاً حازماً من التعذيب أثناء ولايته، فاستغل ثاني يوم له في المنصب لحظر "أساليب الاستجواب المشددة"ـ وهو تعبير مخفف للتعذيب ـ التي استعانت بها إدارة بوش، وإغلاق كافة مقرات الاحتجاز السرية التابعة للوكالة حيث تمت معظم وقائع التعذيب. ومع ذلك فقد رفض أوباما تماماً التحقيق في التعذيب في وكالة المخابرات في عهد بوش، ناهيك عن ملاحقته، رغم أن اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدقت عليها الولايات المتحدة في 1994، تشترط هذا.
وهناك أسباب مختلفة محتملة لرفض أوباما السماح بالملاحقات، فلعله خشي أن تثير انقسامات سياسية تقوض دعم مؤيدي بوش في الكونغرس الأمريكي لأجندته التشريعية، رغم ندرة هذا التعاون فيما سبق. أو لعله شعر بأن الملاحقات لن تكون عادلة بعد أن حكم مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل بأن "أساليب الاستجواب المشددة" قانونية، رغم أن تقرير الشيوخ قد بيّن علم وكالة المخابرات بأنها ترقى إلى مصاف التعذيب، وبحثها عن مشورة حكومية قانونية تبرر ما لا يمكن تبريره. أو لعله شعر بأن التهديد الأمني الخطير الناشئ بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 قد جعل اللجوء إلى أشكال الاستجواب المتطرفة مفهوماً، رغم أن تقرير الشيوخ يظهر أنها لم تؤد إلى معلومات استخباراتية يمكن البناء عليها، بينما قوضت من مكانة أمريكا في العالم وعرقلت جهود مكافحة الإرهاب.
إن رفض أوباما السماح بالملاحقة يعني أن الحظر الجنائي الأساسي المفروض على التعذيب ما زال غير نافذ في الولايات المتحدة، وهذا يمكن الرؤساء الأمريكيين في المستقبل، الذين سيواجهون تهديدات أمنية خطيرة لا محالة، من معاملة التعذيب على أنه خيار سياسي. كما أنه يضعف إلى حد كبير من قدرة الحكومة الأمريكية على الضغط على بلدان أخرى لملاحقة ممارسي التعذيب فيها، فيضعف صوتاً هاماً لحقوق الإنسان في لحظة تمس فيها الحاجة إلى الدعم المبني على المبادئ.
كما أن ما تكشف عنه تقرير الشيوخ يتطلب التحرك في أوروبا، وخاصة في البلدان التي استضافت مقرات الاحتجاز التابعة لوكالة المخابرات أو تواطأت في عمليات التسليم غير العادي وما نتج عنها من تعذيب. إن إيطاليا، حتى اليوم، هي البلد الأوروبي الوحيد الذي لاحق أشخاصاً لتورطهم في انتهاكات وكالة المخابرات. كما اعترفت بولندا أخيراً باستضافة أحد المواقع السوداء، لكن التحقيق الجنائي معطل. أما رومانيا وليتوانيا فهما في حالة إنكار.
والتحقيقات الجنائية جارية في المملكة المتحدة، لكن حكومتها تراجعت عن وعودها بإجراء تحقيق قضائي مستقل فعلياً في تورط بريطانيا في التسليم والتعذيب. والمحاسبة الجدية على دور أوروبا في هذه الانتهاكات هي ضرورة لازمة لمحاسبة المسؤولين ولمنعها من التكرر في المستقبل.
خلاصة: الدور المركزي لحقوق الإنسان
يمكن لواضعي السياسات في جميع تلك الحالات السابقة أن يتذرعوا بأسباب وجيهة للتهوين من شأن حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان تتطلب ضبط النفس الذي يبدو مناقضا لموقف "القيام بكل ما يلزم" السائد عادة في وجه التحديات الأمنية الخطيرة. إلا أن السنوات الأخيرة تبين كم يمكن لهذا التصرف الآلي أن يتسم بقصر النظر. لأن شرارة تلك التحديات الأمنية اشتعلت في أحيان كثيرة بسبب انتهاكات حقوقية، وتفاقمت بفعل استمرار الانتهاكات.
فحقوق الإنسان ليست مجرد قيود تعسفية مفروضة على الحكومات، بل هي تعكس قيماً أساسية، مشتركة على نطاق واسع والإيمان بها عميق، تضع حدوداً لسلطة الحكومات وضمانات ضرورية لحفظ كرامة الإنسان واستقلاله. ونادراً ما يسفر التنكر لهذه القيم عن خير. ومجابهة التحديات الأمنية لا تتطلب احتواء بعض الأفراد الخطرين فحسب، وإنما أيضاً إعادة بناء النسيج الأخلاقي الذي يرتكز إليه النظام الاجتماعي والسياسي.
إن المكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض هذه القيم الجوهرية وما تعكسه من حكمة أساسية نادراً ما تساوي الثمن الآجل الذي لا بد من دفعه. ومن ثم فإن الأجدر بواضعي السياسات، بدلاً من معاملة حقوق الإنسان كقيد خانق على حريتهم في التحرك، هو أن يعترفوا بها كمرشد أخلاقي فضلا عن أنها التزام قانوني. والأرجح أن تكون النتائج هي التصرف الصحيح، والأكثر فعالية أيضاً.
كينيث روث هو المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش.