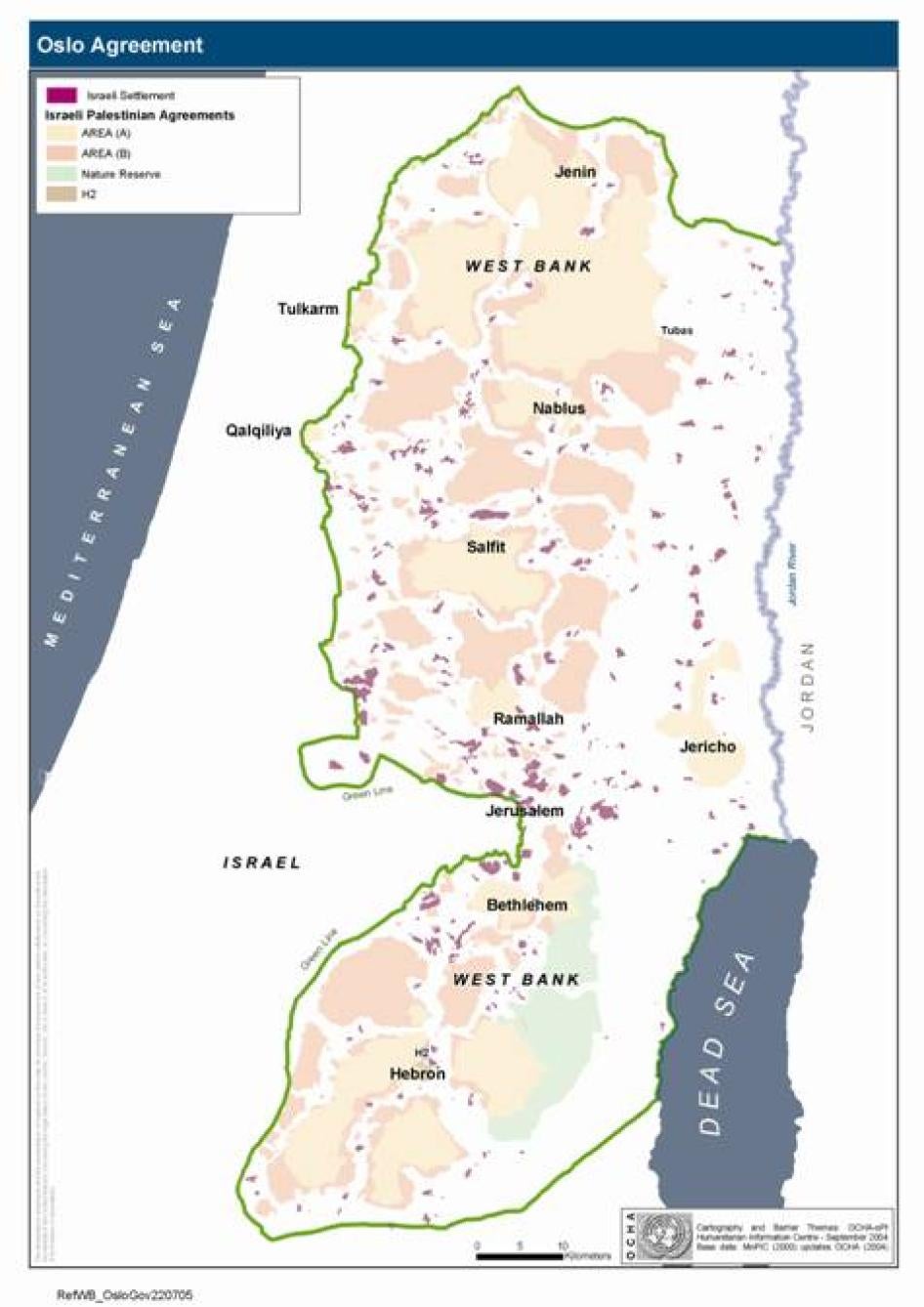مسألة أمن
العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات
خريطة (أ)
المناطق الجغرافية في الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو © 2005 مكتب تنسيق الشؤون الاجتماعية – الأراضي الفلسطينية المحتلة
خريطة (ب)
مناطق الضفة الغربية وغزة
© 2005 مكتب تنسيق الشؤون الاجتماعية – الأراضي الفلسطينية المحتلة
الملخص
ثمة عددٌ كبير من نساء وفتيات الأراضي الفلسطينية المحتلة يقعن ضحيةً للعنف من قبل أفراد العائلة أو شركائهن في العلاقات الحميمة. ورغم الإدراك المتزايد لوجود هذه المشكلة وإشارة بعض مسئولي السلطة الفلسطينية لتأييدهم إبداء رد أكثر حزماً إزاءها، فإن الخطوات المتخذة لمعالجة هذا الإساءات على نحوٍ جدي، قليلةٌ جداً. وفي الواقع فإن نسبة العنف تزداد في وقتٍ تشهد فيه وسائل المعالجة المتاحة للضحايا مزيداً من التراجع.
وعادةً ما يبرر المدافعون عن الوضع القائم والمتمثل بامتناع السلطة الفلسطينية عن اتخاذ تدابير أكثر حزما،ً بالتذرع بكثرة المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه السلطة الفلسطينية؛ وهي مشاكل تزداد تفاقماً بفعل الوضع الذي أعقب فوز حماس الانتخابي في يناير/كانون الثاني 2006. ورغم صحة ما يقال من أن الاحتلال الإسرائيلي (منذ اندلاع الانتفاضة الحالية في سبتمبر/أيلول 2000 ومهاجمة مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية ورفض إسرائيل مؤخراً تسليم الإيرادات الضريبية للسلطة، وغير ذلك) أضعف قدرات السلطة الفلسطينية إلى حدٍّ كبير، فليس من الجائز اعتبار ذلك عذراً لعدم فعل شيء. فثمة الكثير مما يمكن لمسئولي السلطة فعله لإنهاء العنف ضد المرأة داخل الأسرة (لكنهم لا يفعلونه). ويطرح هذا التقرير اقتراحاتٍ ملموسة من أجل التغيير، وهو يركز على بعضها في التوصيات الواردة في نهاية هذا القسم.
قليلةٌ هي المعلومات المفصلة والشاملة عن العنف ضد النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المعالم الأساسية لهذه المشكلة جليةٌ تماماً. فالدراسات والإحصائيات الكثيرة التي جمعها مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني والمجموعات النسائية الفلسطينية تسجل نسبة عالية من العنف الذي يرتكبه أفراد العائلة والشركاء الحميمون. ويزداد هذا العنف شدةً في أوقات العنف السياسي. كما أن المعلومات المستقاة من العاملين الاجتماعيين والأكاديميين ورجال الشرطة حول انتشار العنف الأسري وسفاح القربى و"جرائم الشرف" الفعلية أو التي يجري التهديد بها تشير أيضاً إلى أن معدلات العنف المبلَّغ عنها لا تعكس المستوى الحقيقي لانتشار هذا العنف. وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش، أثناء إعداد هذا التقرير، إلى عشرات النساء من ضحايا العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أكدت رواياتهن خطورة المشكلة واتساع نطاقها وتناولها أموراً تمتد من الإساءة إلى الزوجة والأطفال وصولاً إلى الاغتصاب وسفاح القربى و"جرائم الشرف".
ولأن من المعروف تماماً أن العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة يمثل مشكلةً خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان الهدف الأول لبحثنا هو تقييم الأسباب الكامنة خلف السماح لهذا الوضع بالاستمرار وتقصي السبب الذي يحمل السلطة الفلسطينية على مواصلة امتناعها عن اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذا العنف. ولهذه الغاية تحدث باحثونا إلى عشرات المسئولين الفلسطينيين، ومن بينهم ضباط شرطة ومسئولي سجون وقضاة في المحاكم المدنية والشرعية ونواب عامين ومخاتير، إضافةً إلى ممثلين عن وزارات الصحة والعدل والشئون الاجتماعية، والرئيس السابق لمعهد الطب الشرعي الفلسطيني. كما تحدثوا إلى قرابة خمسين محامياً وأخصائياً اجتماعياً وطبيباً، إضافةً إلى ناشطات حقوق المرأة وأعضاء في المنظمات غير الحكومية وبعض العاملين في منظمات الأمم المتحدة.
واستناداً إلى هذه المقابلات وغيرها من الدراسات التي يرد ذكرها لاحقاً، وجدنا أن ثمة عقبتين رئيسيتين تعترضان سبيل تحسين سوية حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من العنف الأسري، حيث تتمثل العقبة الأولى في القوانين التمييزية التي تتغاضى عن هذا العنف وتعمل على إدامته، في حين تتجلى العقبة الثانية في الغياب الفعلي للسياسات المؤسساتية الهادفة إلى منع العنف ومساعدة الضحايا ومحاسبة المرتكبين.
ولا يفرض كل من قانوني العقوبات الأردني والمصري النافذين في الضفة الغربية وغزة (على التوالي)، حظراً فعلياً على العنف ضد النساء والفتيات، ولا يتضمنان إنزال عقوبات كافية بحق مرتكبيه. كما يتضمن القانونان أحكاماً تسمح بتخفيض عقوبة الرجل الذي يقتل قريبته التي ترتكب الزنا، أو يهاجمها؛ ويسمحان بإعفاء المغتصب من الملاحقة الجزائية إذا وافق على الزواج من ضحيته. ويسمح القانونان للأقارب الذكور وحدهم بتقديم الادعاء بسفاح القربى نيابةً عن القاصرات. ولطالما أدت انقسامات المشرّعين حول القضايا السياسية، إضافةً إلى بطء عملية إقرار التشريعات الجديدة خلال سنوات الانتفاضة الست، إلى عرقلة الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تغيير هذه القوانين الموروثة وسن قانون عقوبات فلسطيني موحد وقانون موحد لشؤون الأسرة. والنتيجة هي إفلات مرتكبي العنف الأسري من العقاب، وبقاء العقبات في وجه الضحايا الذين يبلغون عن الإساءات.
ويفتقر ضباط الشرطة الفلسطينيون إلى الخبرة المتخصصة في معالجة شكاوى العنف الأسري بما تستوجبه من حساسيةٍ وخبرة مهنية لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، مما يجعلهم يلجئون إلى الإجراءات غير الرسمية في معظم الأحوال بدلاً من دراسة الشكاوى ومعالجتها على نحوٍ جدي. وقد قابلت هيومن رايتس ووتش ضباط شرطة فلسطينيين، بينهم ذوي رتب عالية، ممن قللوا من شأن العنف ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشككوا في الحاجة إلى مساهمة الشرطة في نشر وتعميم المعلومات التي من المحتمل أن تنقذ حياة الضحايا. وقال أحدهم: "من الصعب علينا أن ننشر إعلانات. فسوف نبدو وكأننا نشجع النساء على التوجه إلى الشرطة. فالقول بأن العنف ضد المرأة جريمة هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات النسائية". كما عبر كثيرٌ من ضباط الشرطة الفلسطينيين عن مواقف متحيزة تجاه ضحايا العنف من النساء، وقالوا أنهم لا يصدقون الضحايا اللواتي يبلغن عن العنف. وهم ميالون إلى اعتبار العنف الجنسي ضمن الأسرة أمراً يتم على نحوٍ توافقي في معظم الأحوال.
وليس لدى وزارة الصحة إجراءات أو تعليمات طبية لإرشاد موظفي الوزارة أو العاملين الصحيين لديها أثناء معالجة حالات العنف الأسري. وبالنتيجة فإن الأطباء يفتقرون إلى التدريب والإرشاد المتخصص في مجال معالجة ضحايا العنف وحفظ الأدلة على وقوعه، إلى جانب الحفاظ على السرية. وقد تحدث عاملون اجتماعيون فلسطينيون عن عددٍ من الحالات التي كشف الأطباء فيها معلومات سرية عن ضحايا العنف دون موافقتهن مما عرض حياة هؤلاء لمزيدٍ من الخطر.
كما أن الآليات الوقائية التي تتخذها السلطة الفلسطينية أو تشرف عليها من أجل إيواء ضحايا العنف غير كافيةٍ وغير متيسرةٍ في معظم الأحوال. وفي وقت زيارة هيومن رايتس ووتش إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يكن فيها سوى اثنين من الملاجئ المخصصة لضحايا العنف، حيث خصص أحدهما للراشدات والآخر للقاصرات. وتوجه المنظمات النسائية غير الحكومية نقدها لملجأ النساء الراشدات بسبب طول إجراءات القبول التي تفرضها وزارة الشئون الاجتماعية ورفضها لبعض المتقدمات بطريقةٍ تحول أحياناً دون قبول نساء يحتجن إلى حمايةٍ عاجلة. على أن هناك خطةً لافتتاح ثلاثة ملاجئ إضافية؛ أحدهما للفتيات، وآخر للحالات الطارئة قصيرة المدى، والثالث للنساء والأطفال. وأثناء كتابة هذا التقرير، أبلغتنا منظمات نسائية غير حكومية أن ملجأ الحالات الطارئة قد اكتمل وبدأ عمله، وأن العمل في الملجأ العائلي شارف على الانتهاء، وأن ملجأ الفتيات جاهزٌ لكنه بحاجةٍ إلى تمويل من الحكومة. أما في غزة فلا توجد ملاجئ لضحايا العنف مما يؤدي إلى نقص خطير في حمايتهن. و أبدت بعض الناشطات النسائيات المحليات قلقهنً من صعوبة حفظ سرية الملجأ في غزة، وصعوبة أن يبقى مكاناً آمناً بالنتيجة.
وتجد النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يبلغن السلطات عن العنف أنفسهن في مواجهةٍ نظامٍ يضع سمعة الأسرة ضمن المجتمع في المقام الأول على حساب معيشتهن وحياتهن. وبالنتيجة فإن ضباط الشرطة ووجوه العشائر يقومون باستمرار "بالتوسط" في هذه القضايا و"حلها". وعادةً ما يكون ذلك بإعادة الضحية إلى "عهدة ورعاية" من هاجمها دون عرض الأمر على القضاء أو السماح للمرأة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية وغير الاجتماعية التي قد تكون بحاجةٍ إليها. وهكذا فإن ضحايا العنف الجسدي والجنسي هن أساساً من يدفع ثمن الإساءة التي يتعرضن لها، بينما يفلت مرتكبو العنف من العقاب عادةً. وقليلةٌ هي حالات العنف الجنسي التي تعرض أمام القضاء في الضفة الغربية وغزة. ويقول مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أن المحاكم الفلسطينية أدانت شخصاً واحداً بجرم الاغتصاب عام 2004 في قطاع غزة، بينما لم تسجل أي إدانة في الضفة الغربية. وهذه الأرقام غير منسجمةٍ مع ما هو معروفٌ عن مستوى حوادث الاغتصاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و تدرك هيومن رايتس ووتش العقبات الشديدة التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام السلطة الفلسطينية. فقد ألحقت الهجمات العسكرية الإسرائيلية والحواجز وحالات إغلاق الأراضي المحتلة ضرراً مادياً ووظيفياً كبيراً بنظام العدالة خلال فترة الانتفاضة الثانية. ونتيجة ذلك لم يترك للسلطة الفلسطينية سوى مجال محدود تستطيع فيه ممارسة سلطاتها الحكومية على نحوٍ فعال. ومنذ أداء الحكومة التي تقودها حماس اليمين في مارس/آذار 2006، قطعت إسرائيل جميع علاقاتها الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، وعلقت تسليم الإيرادات الضريبية التي تعتمد عليها الموازنة الشهرية للسلطة، وقامت عدة مرات بإغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل، واحتجزت عدداً من وزراء السلطة ونوابها إضافةً إلى عددٍ من المسئولين الحكوميين من حركة حماس. كما أوقف كثيرٌ من المانحين الدوليين تمويلهم المباشر للسلطة، وقطعت الولايات المتحدة العلاقة الدبلوماسية مع المسئولين التابعين لحماس.
ورغم كل هذه المعوقات، تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية النهائية عن حماية الضحايا ومحاسبة المرتكبين. وتؤكد أبحاث هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن السلطة امتنعت عن اتخاذ كثير من المبادرات العملية القابلة للتنفيذ كالرصد الكافي لمعدل العنف ضد المرأة، وإقامة ملاجئ إضافية وخطوط هاتفية ساخنة تشرف عليها الحكومة، وتزويد الشرطة (والجهات الخدمية) بتوجيهاتٍ أساسية حول كيفية التعامل مع شكاوى العنف ضد المرأة، وبذل الجهود لتثقيف الجمهور بهدف تقليل العنف الذي يستهدف النساء.
ويبدو أن كثيراً من المسئولين الفلسطينيين، الذين احتفظوا بمناصبهم بعد انتخابات يناير/كانون الثاني 2006، ينظرون إلى الأمن ضمن السياق المتعلق بالاحتلال فقط، ويتجاهلون تماماً المشكلة الأمنية الحقيقية التي تواجه النساء داخل بيوتهن. وعلى هذا النحو تمتنع السلطة الفلسطينية عن اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع العنف ضد المرأة والتحقيق في حوادثه وإنزال العقاب بمرتكبيه مما يضع حياة النساء وصحتهن موضع الخطر. لا بل تنكر السلطة على الضحايا ما يقرره القانون الدولي لحقوق الإنسان من حقهن في عدم التمييز وفي المعالجة القضائية الفعالة للإساءات التي تصيبهن.
إن أسلوب تعامل السلطة الفلسطينية مع العنف ضد النساء والفتيات يلحق أثراً ضاراً بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويضر كثيراً باحترام القانون والإيمان به. ومن الضروري جداً أن تعتبر السلطة العنف ضد النساء والفتيات قضيةً ذات أولوية على جدول أعمالها الأمني، وأن تعمل الآن بفعاليةٍ على اعتماد تدابير لمعالجة انتهاك حقوق المرأة، وذلك كجزءٍ لا يتجزأ من استجابتها خلال مرحلة بناء الدولة. وثمة حاجةٌ ملحة لا للإصلاحٍ القانونيٍّ فقط بل لاعتماد سياسات على جميع المستويات الحكومية وعلى مستوى نظام العدالة الجزائية من شأنها معالجة العنف ضد النساء والفتيات.
التوصيات الرئيسية
تدعو هيومن رايتس ووتش السلطة الفلسطينية، وكمسألةٍ ذات أولوية ملحة، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، والمحاسبة على جرائم العنف عبر التحقيق الفعال والملاحقة القضائية. وعلى السلطة سن قوانين تجرّم جميع أشكال العنف الأسري وإلغاء الأحكام القانونية التي تعمل (قصداً أو عن غير قصد) على إدامة العنف ضد النساء والفتيات أو التسامح تجاهه.
وعلى السلطة أيضاً تدريب جميع الموظفين الحكوميين (بمن فيهم رجال الشرطة والأطباء والمخاتير والأطباء الشرعيين) ممن هم على صلة بضحايا العنف الجسدي والجنسي على كيفية التعامل السليم مع هذه الحالات. وعليها كذلك أن تضع توجيهات واضحة للتدخل في هذه الحالات بما ينسجم مع المعايير الدولية. إن كثيراً من هذه المواد التدريبية موجودةٌ ومجرّبةٌ من قبل المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، ويجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار وأن تدعمها بما يتوفر لها من تمويل.
وثمة ضرورة أيضاً على المدى البعيد للعمل على تغيير المواقف والقناعات التي تقبل العنف ضد النساء والفتيات، سواءٌ كانت هذه القناعات نابعةً من العادات العشائرية أو من تفسيراتٍ معينة للقواعد الدينية، أو من أية مصادر أخرى. وأفضل من يمكن لهم قيادة هذه الجهود هم المدافعون المحليون عن حقوق المرأة الذين يعيشون ويعملون ضمن المجتمع ويستحقون تلقي المساندة العلنية والتشجيع من جانب السلطة الفلسطينية والعالم.
ملاحظة حول المنهجية
يعتمد هذا التقرير على أكثر من مائة مقابلة أجريناها في القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس والخليل وطولكرم وأريحا وغزة في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2005. ويعتمد أيضاً على ما أعقب هذه المقابلات من اتصالاتٌ إضافية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني مع كثيرٍ ممن تمت مقابلتهم، إلى جانب بضع مقابلات جديدة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2006، إضافةً إلى دراسة ما يتصل بالموضوع من قوانين ودراسات أكاديمية وتحليلات واستطلاعات، وغير ذلك من المواد المنشورة. وقد جرى تغيير أسماء جميع النساء والفتيات اللواتي يناقش التقرير حالاتهن بغية حماية خصوصيتهن وضمان سلامتهن. وفي بعض الحالات، حُجبت معلومات أخرى من شأنها تحديد هوية المعنيات، وذلك للأسباب عينها.
خلفية عامة
يعرض هذا القسم نظرةً عامة إلى الظروف المحددة التي جرت فيها كتابة هذا التقرير والأبحاث الخاصة به، إضافةً إلى مساهمة حركة النساء الفلسطينيات في تطور المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية.
لا تشكل الأراضي الفلسطينية المحتلة دولةً ذات سيادة، كما أن السلطة الفلسطينية لا تمثل حكومةً ذات سيادةٍ كاملة حتى الآن. لكن السلطة نجحت في إيجاد نظام عدالة جزائية خلال عقد السنوات الماضية. ويدرس هذا القسم نشوء هذا النظام وتكونه ونواقصه. وفي وقتٍ يعاني فيه جميع الفلسطينيين من نواقص نظام العدالة الحالي، تدفع النساء بوجهٍ خاص ثمناً باهظاً جراء نظامٍ غالباً ما يكون عاجزاً عن، أو غير مستعد للاستجابة الكافية للعنف الذي يستهدفهن. ومع أن وجود نظام عدالة جزائية حسن الاستجابة ليس بالعنصر الضروري الوحيد من أجل المعالجة الفعالة للعنف ضد المرأة، فإنه أحد العوامل الأساسية في سياق جهد أكثر اتساعاً لوقف الإساءات ومحاسبة المرتكبين. وسوف تدرس الأقسام اللاحقة من هذا التقرير دور نظام العدالة غير الرسمي في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.
الوضع السياسي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة
أدت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1949 واتفاقية الهدنة عام 1949 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة (سوريا ولبنان ومصر والأردن) إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الانتداب إلى: إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وفي فترة 1948 – 1967، خضعت الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الإدارة الأردنية التي ضمت هذه المناطق رسمياً عام 1950، بينما وضعت مصر قطاع غزة تحت إدارةٍ عسكرية. وقام كلٌّ من الأردن ومصر بإنفاذ قوانينه على المناطق الواقعة تحت سيطرته.
ونتيجةً لحرب 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة (وهي المناطق التي نشير إليها من الآن فصاعداً باسم الأراضي الفلسطينية المحتلة). وفي عام 1980 ضمت إسرائيل القدس الشرقية وأعلنت القدس عاصمةً أبديةً موحدة لها بموجب قانون أساسي اسمه "قانون القدس"، وأخضعت سكان القدس الشرقية الفلسطينيين إلى القوانين الإسرائيلية. ولم يعترف المجتمع الدولي بالقدس الشرقية كجزءٍ من دولة إسرائيل. وبعد حرب 1967 أقامت إسرائيل إدارةً عسكرية لحكم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان حجر الزاوية في الإدارة العسكرية الإسرائيلية نظامٌ يضم أكثر من 2,500 أمر عسكري إسرائيلي حكمت جميع جوانب الحياة المدنية وفرضت عليها قيوداً جديدة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التنظيم.[1] وقد أضاف هذا النظام مجموعة جديدة من القوانين إلى المزيج المعقد الموجود أصلاً والمتكون من القوانين العثمانية والبريطانية والمصرية والأردنية.[2]
وفي ديسمبر/كانون الأول 1987، قام سكان الأراضي المحتلة الفلسطينيون بانتفاضةٍ شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي عرفت باسم الانتفاضة الأولى.[3] وبعد فشل المفاوضات السلمية في مدريد وواشنطن عام 1993، بدأت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية[4] مفاوضاتٍ سرية في أوسلو أدت إلى توقيع إعلان مبادئ في حديقة البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 1993. ويعرف إعلان المبادئ هذا مع ما تلاه من اتفاقياتٍ إسرائيلية فلسطينية باسم اتفاقيات أوسلو[5] التي استندت إلى مبدأ الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير ونصت على فترةً انتقاليةً من خمس سنوات تنسحب خلالها إسرائيل من أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة ويقيم الفلسطينيون حكماً ذاتياً في هذه المناطق، بما يتضمنه ذلك من ممارسة مهام الشرطة تجاه السكان. وكان من المفترض أن تؤدي الفترة الانتقالية إلى مفاوضات "الوضع النهائي" عام 1999، وذلك فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع القدس ورسم الحدود النهائية وتقاسم الموارد المائية.
ومنذ فشل مفاوضات الوضع النهائي في كامب ديفيد[6] واندلاع الانتفاضة الثانية[7] عام 2000، دخلت عملية أوسلو في سبات طويل. وبعد ذلك قامت إسرائيل بعدة إجراءات من جانبٍ واحد كانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005، وبناء السور الإسمنتي والحديدي (نشير إليه من الآن فصاعداً باسم "الجدار") الذي يقع أساساً في أراضي الضفة الغربية، والذي يتوقع أن يفضي إلى إلحاق قرابة 10% من الضفة الغربية بما في ذلك كبرى المستوطنات الإسرائيلية، وذلك كأمرٍ واقع.[8]
وبنتيجة اتفاقيات أوسلو، أقامت منظمة التحرير السلطة الفلسطينية المؤلفة من رئيس السلطة ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية. وفي يناير/كانون الثاني 1996 جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المؤلف من 88 مقعداً.
أما منصب رئيس السلطة الفلسطينية ففاز به ياسر عرفات رئيس حركة فتح ومنظمة التحرير، وذلك في انتخاباتٍ رئاسية ترافقت مع فوز فتح بغالبيةٍ ساحقة من مقاعد المجلس التشريعي. وكان ذلك فاتحةً لعشرة سنوات من حكم الحزب الواحد. وقد تمثلت النساء بنسبة 3.7 % من المرشحين وفزن بخمسة مقاعد (5.6%) في أول مجلس تشريعي فلسطيني.[9] وكانت معظم الفصائل السياسية الفلسطينية قد رفضت المشاركة في انتخابات 1996 احتجاجاً على اتفاقيات أوسلو التي عارضتها لأسبابٍ مختلفة منها أن هذه الاتفاقيات لم تضع نهايةً للاحتلال الإسرائيلي ولم توقف بناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت حماس (حركة المقاومة الإسلامية)، وهي جماعةٌ مسلحة نشأت كفرعٍ للإخوان المسلمين في غزة عام 1987 وهي مسئولة عن كثيرٍ من الهجمات التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين منذ عام 1993، من بين المنظمات التي قاطعت الانتخابات. وما لبثت هذه الحركة أن تحدت الاحتكار السياسي الذي تمارسه فتح بأن كونت لنفسها قاعدةً لجماهيرية عبر نشاطاتها التعليمية والثقافية والاجتماعية.[10]
تقسم اتفاقيات أوسلو الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مناطق ثلاث (انظر الخريطة على الصفحة 2). وهي تمنح السلطة الفلسطينية سيطرة أمنيةً ومدنية في المنطقة "أ" (التي تضم أكبر المدن الفلسطينية لكنها لا تمثل إلا 17% من أراضي الضفة الغربية)، وسيطرةً مدنية في المنطقة "ب" (المراكز السكانية الفلسطينية الصغيرة خارج المدن)، بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية في المنطقة "ب". كما احتفظت إسرائيل بالسيطرة المدنية والأمنية معاً في المنطقة "ج"، وهي ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة (وتضم بعض التجمعات السكانية الفلسطينية الصغيرة)، وكذلك بسيطرتها على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية والطرق التي تربط المستوطنات بإسرائيل، إضافةً إلى احتياطي كبير من الأراضي. وتشكل المنطقة "ج" التي أبقت إسرائيل لنفسها سيطرةً حصريةً عليها 60% من الضفة الغربية. وبسبب الطبيعة الجغرافية غير المستمرة للمناطق الثلاث، فإن المنطقة "ج" تجزئ المناطق الواقعة ضمن الفئتين "أ" و"ب".[11] وهذا الاستقلال الذاتي المجزأ والمحدود يجعل من الصعب جداً على السلطة الفلسطينية ممارسة حكم فعال، الأمر الذي تفاقم منذ بدء الانتفاضة الثانية.
ولعل أهم ما في الأمر بالنسبة لموضوع البحث هنا هو أن لنظام العدالة الجزائية الفلسطيني ولايةً قانونيةً محدودة في الضفة الغربية. فالمحاكم الفلسطينية غير قادرةٍ على النظر إلا في القضايا المقامة في المنطقتين "أ" و"ب"، ولا يحق للشرطة الفلسطينية تنفيذ القرارات القضائية في المنطقة "ج". وتقول مها أبو ديّة شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن نظام الولاية القانونية المجزأ هذا يعتبر أخطر العقبات التي تعترض الإدارة الفعالة للعدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[12]
وخلال الانتفاضة الثانية أعادت إسرائيل احتلال المنطقة "أ" في الضفة الغربية وفرضت على سكانها الفلسطينيين حظر التجول والإغلاق لفتراتٍ زمنية طويلة، وقامت بعملياتٍ عسكرية محدودة في مناطق مكتظة بالسكان. ومع أن هذه العمليات كانت في الظاهر تستهدف المقاتلين الفلسطينيين الذين يشنون الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي، فإن الهدف الفعلي كان في الغالب مؤسسات السلطة الفلسطينية وعامليها، بما في ذلك الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك لأن إسرائيل تدعي أن السلطة الفلسطينية لم تقم بما فيه الكفاية لوقف هجمات المقاتلين الفلسطينيين.[13]
وفي أوقات تصاعد الانتفاضة الثانية في فترة 2001 – 2003، كان لعودة الاحتلال العسكري الإسرائيلي وللقيود المفروضة على الحركة وللعمليات العسكرية أثرٌ ضار على أجهزة الحكومة الفلسطينية. فلم يكن المجلس التشريعي قادراً على الاجتماع إلا عن طريق عقد المؤتمرات الهاتفية المرئية. ولم تستطع المحاكم العمل إلا على نحوٍ متقطع إذ لم يكن القضاة والمحامون والمُدٌعون والمُدٌعى عليهم بقادرين على اجتياز نقاط التفتيش والوصول إلى المحاكم، كما لم يعد الناس قادرين على تحمل رسوم المحاكم. ولم يكن هناك من ينفذ القرارات القضائية، حيث توقف عمل الشرطة الفلسطينية إلى حدٍّ بعيد بفعل تدمير الإسرائيليين لمخافر الشرطة والسجون واستهداف العاملين فيها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، وضعت إسرائيل ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك، تحت الإقامة الجبرية الفعلية داخل مقر الرئاسة المدمر جزئياً والمحاصر في رام الله. وقد بقي هناك حتى سفره للعلاج ثم وفاته في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
وفي فبراير/شباط 2005، اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقفٍ فضفاض لإطلاق النار مثّل نهايةً لأكثر الفترات عسكرةً خلال الانتفاضة. وبدأت إسرائيل منذ ذلك الوقت تعيد نقل السيطرة الأمنية في بعض أجزاء المنطقة "أ" إلى السلطة الفلسطينية. وراحت الشرطة الفلسطينية تعمل بقدرٍ أكبر من العلنية والانتظام، لكن كثرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى استمرار محدودية حركة الشرطة، وبالتالي محدودية فعاليتها.
وبعد وفاة الرئيس عرفات، نظمت السلطة الفلسطينية انتخاباتٍ جديدة في يناير/كانون الثاني 2005، وأصبح محمود عباس (وهو رئيس الوزراء سابقاً، وعضوٌ في فتح) الرئيس الفلسطيني الثاني. وكان برنامج عباس الانتخابي إنهاء الهجمات العسكرية الفلسطينية ضد إسرائيل وإجراء إصلاح حكومي. ورغم نجاحه في إجراء تغييرات مهمة (شملت المالية والأجهزة الأمنية)، فإن ما حققه لم يكن كافياً لاستعادة الثقة والتأييد الشعبي المتضائل لحركة فتح ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
وجرت الانتخابات الثانية لعضوية المجلس التشريعي في ظل السلطة الفلسطينية يوم 25 يناير/كانون الثاني 2006، وأسفرت عن فوزٍ ساحقٍ لحركة حماس التي قررت إنهاء مقاطعتها للانتخابات وكانت تستعد لدور حزب المعارضة الرئيسي. حيث فازت الحركة بنسبة 44% من أصوات الناخبين وأحرزت 56% من مقاعد المجلس التشريعي، أو 74 من أصل 132 مقعداً.[14] وارتفع تمثيل النساء في المجلس الجديد إلى 17 مقعداً، أي 13% (تمثل فتح وحماس وعدد من الأحزاب الأخرى). وكان ذلك جزئياً بفضل الحصة الجديدة التي خصصت للنساء.[15] وأقسمت الحكومة الجديدة بقيادة حماس اليمين الدستورية في 29 فبراير/شباط 2006. لكن إسرائيل والقسم الأكبر من المجتمع الدولي قطعا جميع العلاقات بالسلطة الفلسطينية احتجاجاً على رفض حماس المستمر الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.[16] كما أوقفت إسرائيل تحويل إيرادات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ 50 – 60 مليون دولار شهرياً. وقطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان جميع المساعدات المباشرة المقدمة إلى السلطة الفلسطينية.
وبحلول سبتمبر/أيلول 2006، أصبحت السلطة متأخرة ستة أشهر عن دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 165,000 شخصاً (بينهم 70,000 في الأجهزة الأمنية). وتوقف كثيرٌ من الموظفين عن الذهاب إلى العمل، ولم يعد بمقدور كثيرٍ منهم تحمل نفقات المواصلات حتى مكان العمل. وقد بدأ كثيرٌ من المعلمين والعاملين في الصحة إضراباً مفتوحاً منذ 2 سبتمبر/أيلول. وتقول منظمات الأمم المتحدة ومصادر دولية أخرى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة أضحت على حافة انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية.[17]
وكانت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح، وبعد توليها الحكم عام 1996، قد فقدت قدراً كبيراً من التأييد الداخلي بفعل الفساد الشديد وسوء الإدارة وعدم قدرتها على حماية المدنيين الفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي أو على فرض القانون والنظام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك بسبب فشلها في تحقيق أي قدرٍ ملموس من التحسن الاقتصادي والاجتماعي كنتيجة للعملية السلمية. وفي عام 1999، أي بعد انقضاء الموعد المحدد لمفاوضات الوضع النهائي، تزايد السخط الشعبي الفلسطيني تجاه القيادة. وتتجه يعض التحليلات إلى تقييم هذا الوضع على النحو التالي:
مع زيادة الاستياء من تواصل الاحتلال، بدأ الفلسطينيون يولون اهتماماً أكبر لنواقص مؤسسات الإدارة الفلسطينية. فقد كان التغاضي عن انعدام استقلالية القضاء أمراً سهلاً عندما يعتقد المرء أن الاستقلال قريبٌ جداً، لكنه لا يغدو كذلك عندما لا يعود المرء واثقاً من اقتراب الحرية، وعندما يبدأ النظام القائم بتقييد حقوقه زيادةً على ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من قيودٍ شديدة على الحريات الشخصية. وقد بدأ الفلسطينيون يخضعون عمل مؤسساتهم إلى مزيدٍ من التدقيق.[18]
وحتى في ذروة الانتفاضة عندما تكاتف الفلسطينيون من جديد حول رئيسهم المريض والسجين، ظهرت دعواتٌ داخليةٌ كثيرة إلى الإصلاح. ففي مايو/أيار 2002 أصدر المجلس التشريعي "إعلاناً عن المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل إصلاح وتطوير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية". ودعت تلك الوثيقة إلى الفصل بين السلطات الثلاث وإلى مزيدٍ من الشفافية والمحاسبة، وكذلك إلى تطبيق جميع القوانين والقرارات التي يتخذها المجلس التشريعي، وإلى الإصلاح الإداري وخفض عدد أفراد الأجهزة الأمنية وتوحيدها ضمن عددٍ أقل من الأجهزة ووضعها تحت كل من سلطة وزارة الداخلية ومراقبة المجلس التشريعي، إضافةً إلى بناء الموارد البشرية والمادية لدى السلطة القضائية، وإكمال العمل التشريعي لضمان استقلالية القضاء، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.[19]
وكان من المظاهر الواضحة لفشل السلطة الفلسطينية تزايد حالة الفوضى وانعدام القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والواقع هو أن السلطة الفلسطينية لم تتمتع يوماً باحتكار استخدام القوة في الأراضي المحتلة. وهذا عائدٌ إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، وإلى كثرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية ومحدودية صلاحيات السلطة الفلسطينية في الأمور الأمنية من ناحيةٍ أخرى؛ وهو عائدٌ أيضاً إلى العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة التابعة لمختلف الفصائل السياسية وهي أفضل تسليحاً من قوات الأمن الفلسطينية نفسها.[20] وفضلاً عن هذا، فإن معظم أجهزة الأمن الفلسطينية (وعددها عشرة)[21] لا تملك تسلسلاً عسكرياً واضحاً؛ وثمة تداخلٌ في وظائفها. فقد وضع عرفات نظاماً يكون قادة الأجهزة الأمنية فيه مسئولين أمامه مباشرة. ويعتمد مقدار رعايته لهم على ولائهم، فهم في حالة تنافسٍ مستمر ولا يمكن لأيٍّ منهم أن يملك ما يكفي من القوة لتحدي حكمه.
ونتيجةً لانهيار عمل الشرطة الرسمية منذ بدء الانتفاضة الحالية في سبتمبر/أيلول 2000، تزايد لجوء الفلسطينيين إلى الوسائل التي كانوا يتبعونها لتسوية نزاعاتهم في الماضي. ونشبت اشتباكات في الشوارع بين الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة تضمنت إصابة عابري السبيل واقتحام مقرات الحكومة واغتيال الخصوم السياسيين أو الموظفين الحكوميين، وكذلك اختطاف أجانب يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[22] وقد أفضى هذا الوضع إلى مزيدٍ من التدهور في ثقة الناس بقوات الأمن الفلسطينية، وإلى ازدياد مصادرة وظائف الأمن من قبل قيادات العشائر[23] الأقوياء، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة. وبعد قيام حكومة حماس في مارس/آذار 2006، ومع إنشاء قوة أمنية جديدة تخضع لنفوذ الحركة في مايو/أيار، ازدادت الصدامات بين الأجهزة الأمنية، وخاصةً في شوارع غزة، موقعةً عدة إصاباتٍ أسبوعياً في شهر سبتمبر/أيلول 2006.
نظام العدالة الجزائية الفلسطيني
"ليس لدينا قانون ولا احترامٌ لأي قانون. ونحن لا نكتفي بالمطالبة بتغيير القانون وأصول المحاكمات الجزائية، بل نطالب بتغيير يطال النظام القضائي كله"
- المحامية حليمة أبو صلب، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رام الله، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
الشرطة الفلسطينية
سمحت اتفاقيات أوسلو بإقامة شرطة مدنية فلسطينية في المنطقتين "أ" و"ب" لحفظ النظام العام وإنفاذ القانون وإجراء أعمال البحث الجنائي. وتلقت الشرطة المساعدة والتدريب من المانحين الدوليين، وكانت تتمتع بقدرٍ جيدٍ من الاحترامٍ في التسعينات. وأثناء تصاعد الانتفاضة الثانية، دمر الجيش الإسرائيلي كثيراً من مخافر الشرطة الفلسطينية وسياراتها وأجهزة وشبكات الاتصال وإمدادات الأسلحة ومراكز الاحتجاز في الضفة الغربية وغزة، بما في ذلك مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية عام 2002. وخلال هذه الفترة صارت الشرطة في حالة شلل من الناحية العملية. ورغم استمرارها في تلقي الرواتب من السلطة الفلسطينية (بشكلٍ عام)، فقد انضم بعض أفرادها إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش الإسرائيلي علناً. وشهد الوضع بعض التحسن بعد وقف إطلاق النار عام 2005، لكن إسرائيل أوقفت كافة أشكال التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية منذ أن تولت حكومة حماس مهامها في مارس /آذار 2006. ولم يعد بمقدور الشرطة الفلسطينية أو النيابة العامة الحصول على موافقة إسرائيل لدخول أراضي المنطقة "ج".[24]
وطبقاً لتقييمٍ لأجهزة الأمن أعدته مبادرة التقييم الاستراتيجية عام 2005، فإن الشرطة تفتقر إلى القدرات الفنية وتشكو من تواضع قدراتها العملياتية في غزة وضعفها في الضفة الغربية. وهي غالباً لا تستطيع ملاحقة الهاربين واعتقالهم، إضافةً إلى ضعف اختصاصاتها القانونية، مما أدى إلى ظهور نظام عدالة بديل تحل فيه العائلات والعشائر محل الشرطة المدنية من جوانب عدة. وفي الضفة الغربية الآن 6,800 رجل شرطة إضافةً إلى 12,000 في غزة، وذلك رغم أن سكان الضفة يزيدون سكان غزة بمقدار الضعف.[25]
ويمثل البحث الجنائي واحداً من أكبر نقاط الضعف الفنية لدى الشرطة الفلسطينية. فقد قال لنا مدرب شرطة في أكاديمية الشرطة بأريحا، وقد تلقى تدريباً على البحث الجنائي في الهند:
لا تكاد الشرطة الفلسطينية تملك أية قدرات في البحث الجنائي. فعدد الباحثين الجنائيين المدربين قليلٌ جداً. أما من تلقوا تدريباً فلا يكلفون بالتحقيق والبحث الجنائي لسببٍ ما. كما أننا لا نملك تقريباً أية معداتٍ أو تجهيزات تكنولوجية: فليس لدينا معدات رفع البصمات، ولا مخبر للمقذوفات النارية، كما أن قدراتنا في الطب الشرعي ضعيفة جداً وهذا ما يجعل المحققين يعتمدون كثيراً على الاعترافات بدلاً من الأدلة المادية المأخوذة من مكان الجريمة. لقد حاولت مرةً تعليم طلابي رفع البصمات. ولما لم تكن لدي التجهيزات اللازمة، فقد استعرت من زوجتي فرشاة التجميل المصنوعة من وبر الجمل، إضافةً إلى بعض المساحيق. أعلم أن الأمر يبدو سخيفاً، لكن ما هي الخيارات التي أمامنا؟[26]
ورغم وجود وحدة شرطة نسائية في مقر الشرطة بمدينة غزة، فقد قالت لنا المنظمات النسائية غير الحكومية أن هذه الوحدة معطلة حالياً إلى حدٍّ كبير.[27] ويوجد عددٌ قليل من الشرطيات في مخافر الشرطة (عدة شرطيات في كل مخفر عادةً)، لكنهن غالباً لا يرتدين لباس الشرطة، وهن يقمن بمهامٍ إدارية بدلاً من المهام الشرطية. ويقول مدير أكاديمية الشرطة في أريحا أن استقطاب النساء للخدمة في الشرطة، وكذلك الاحتفاظ بهن، شديد الصعوبة بسبب القيود الاجتماعية والعائلية المفروضة على المرأة.[28]
النيابة العامة والمدعون العامون
وفقاً للقانون الفلسطيني، يمكن للنيابة العامة فتح تحقيق في القضايا الجنائية والإشراف على هذا التحقيق، ويمكنها تقديم القضية إلى المحكمة إذا تمكنت من جمع أدلةٍ كافية. ويرأس النيابة العامة نائب عام يعاونه أربعة نواب (اثنان في الضفة واثنان في غزة). ويشرف أفرادٌ من النيابة العامة على التحقيقات التي يجريها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون عادةً. ولدى السلطة الفلسطينية 105 من رؤساء النيابة والمدعين العامين ومساعدي المدعين العامين (منهم 69 في غزة و36 في الضفة الغربية، رغم أن عدد سكان الضفة أكبر من عدد سكان غزة). وتعاني النيابة العامة من الخلافات بين وزارة العدل وبين النائب العام، وهي خلافات ناجمة عن عدم وضوح الأنظمة التي تحكم تقسيم العمل بين الجانبين.[29]
وكثيراً ما توجه المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين نقدها إلى النيابة العامة بسبب امتناعها عن التحقيق في كثير من حالات قتل فلسطينيين على يد فلسطينيين آخرين بسبب الشك في تعاملهم مع الإسرائيليين. كما تنتقدها أيضاً لعدم قيامها بزياراتٍ تفقدية منتظمة للسجون ومراكز الاحتجاز وامتناعها على ضمان إطلاق سراح من احتجزوا بشكلٍ غير قانوني.[30]
القضاء الفلسطيني
بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، ورثت هذه السلطة نظاماً قضائياً مفككاً وشبه عاجز جراء ما عاشه من إهمال خلال 30 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي.[31] ويحتفظ النظام القضائي بعناصر من الأنظمة القضائية الأجنبية المتعددة التي فرضت على الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال القرون الماضية، وهي النظم القضائية العثمانية والبريطانية والمصرية والأردنية والإسرائيلية. كما يعاني هذا النظام من تجزؤ ولايته القانونية والإقليمية وفق ما جاء في اتفاقيات أوسلو حيث يمكن للمحاكم الفلسطينية النظر في القضايا الجنائية المقامة في المنطقتين "أ" و"ب" فقط، وليس في المنطقة "ج". كما لم تمنح اتفاقات أوسلو المحاكم الفلسطينية ولايةً على المدنيين الإسرائيليين (أي المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، ولا على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي عام 2001، تحدث تقرير أعدته هيومن رايتس ووتش عن فشل السلطة الفلسطينية في إقامة سلطة قضائية مستقلة وفاعلة خلال التسعينات. وجاء في التقرير: "[فشلت] السلطة الفلسطينية في منح القضاء ما يكفي من الصلاحيات والاحترام والموارد المالية وغيرها. ويعاني القضاء من قلة عدد القضاة والافتقار إلى القضاة المؤهلين، إلى جانب نقص تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين القضائيين".[32]
ويورد التقرير أيضاً تفاصيل عن حالات تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة وعزلهم، إضافةً إلى حقيقة تجاهل الأجهزة الأمنية المتواصل لأوامر المحكمة العليا بإطلاق سراح المحتجزين على نحوٍ تعسفي. وقد شهد هذا الوضع بعض التحسن في السنوات الأخيرة بعد أن سن المجلس التشريعي قانون إنشاء مجلس القضاء الأعلى.[33] كما توقف عمل محكمة أمن الدولة العليا[34] سيئة الصيت منذ عدة سنوات، لكن الرئيس لم يصدر حتى الآن المرسوم الرئاسي اللازم لحل هذه المحكمة بصورةٍ رسمية.[35] وكما تقول المادة الوثائقية في تقرير هيومن رايتس ووتش، اشتهرت هذه المحكمة بالمحاكمات التي لا تستغرق إلا ساعاتٍ قليلة حيث يدان المتهم استناداً (فقط، أو على نحو رئيسي) إلى اعترافاته أثناء الحجز الانفرادي.[36]
وفي فترة تصاعد الانتفاضة الثانية توقف النظام القضائي عن العمل فعلياً. ولم يكد يبدأ استعادة نشاطه إلا عام 2005. وقد قالت لنا إحدى المحاميات: "إن المحاكم الآن أحسن حالاً بقليل، لكن عدد القضاة في محكمة رام الله مازال أقل بكثير مما يحتاجه عدد السكان، ولا يستطيع القضاة النظر في جميع القضايا. وعادةً ما أصل إلى المحكمة في الثامنة والنصف صباحاً لحضور إحدى الدعاوى لأجد أن الجلسة قد أجلت ستة أشهرٍ أخرى".[37] وفي أواخر 2005، حضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الاستماع الأولى في دعوى اغتصاب في رام الله، وكانت القضية مجمدةً منذ خمس سنوات.
ويتألف النظام القضائي الفلسطيني من المحاكم العادية (التي تنظر في القضايا المدنية والجزائية) ومن المحاكم الشرعية/الدينية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية (المحكمة الشرعية للمسلمين والمحاكم الروحية للجماعات غير الإسلامية المعترف بها).[38]
ويتألف نظام المحاكم العادية من درجتين، إضافةً إلى محكمة التمييز. وتضم الدرجة الأولى محاكم الصلح التي تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لا تتجاوز عقوبتها حداً معيناً أو التي لا يتجاوز حجم الضرر فيها قدراً معيناً. وفي محاكم الصلح العشرين (ستة في غزة و14 في الضفة الغربية) 35 قاضياً، وهي تعاني مشكلةً مزمنة تتمثل في تراكم الدعاوى.[39] ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 كانت 1591 قضية وشكوى تنتظر الدراسة في محكمة صلح قلقيلية التي تضم قاضياً واحداً.[40]
وتعمل محاكم البداية إما بوصفها محاكم درجة ثانية بالنسبة لأحكام محاكم الصلح التي يجري استئنافها أمامها، أو كمحاكم درجة أولى بالنسبة للقضايا المدنية والجزائية التي تتجاوز اختصاص محاكم الصلح. وتوجد 12 محكمة بداية (ثلاثة في غزة وتسعة في الضفة الغربية) يعمل فيها 50 قاضياً. وتعاني هذه المحاكم نفس مشكلة تراكم الدعاوى التي تعانيها محاكم الصلح.[41] ويمكن استئناف القضايا التي تفصل فيها محاكم البداية أمام محكمة الاستئناف (استئناف قرارات محكمة البداية). وثمة محكمتين استئنافيتين، واحدة في الضفة الغربية وواحدة في غزة. ويبلغ مجموع القضاة فيهما 15 قاضياً.[42]
وتعمل المحكمة العليا إما كمحكمة تمييز (المحكمة النهائية التي تنظر في استئناف قرارات المحاكم الأدنى في القضايا المدنية والجنائية والتجارية) أو كمحكمة عدل عليا تنظر في الدعاوى الإدارية. وعلاوةً على هذا، تعمل المحكمة العليا حالياً كمحكمةٍ دستورية ريثما يتم إنشاء الأخيرة كما ينص القانون الأساسي.[43] وللمحكمة الدستورية صلاحية النظر في التشريعات وتقرير مدى دستوريتها، لكنها لم تقم بهذا الدور إلا مرةً واحدة، وذلك عند مراجعة قانون السلطة القضائية المعدل في عام 2005. والقدس هي المقر الرسمي للمحكمة العليا، لكنها تنعقد مؤقتاً في موقعين اثنين: غزة ورام الله. وتتألف هذه المحكمة من 21 قاضياً. وتواجه جميع المحاكم (بما فيها محكمة العدل العليا) مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية، وخاصةً الأجهزة الأمنية. وتقول المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين التي بعثت إلى وزارة العدل والمجلس التشريعي الفلسطيني كثيراً من الرسائل بشأن هذا الأمر: "إن بعض الأجهزة الأمنية، وخاصةً المخابرات العسكرية، مازال يمتنع عن تنفيذ بعض قرارات محكمة العدل العليا".[44]
أقامت السلطة الفلسطينية محاكم خاصة مثل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ومحاكم من أجل أمور أخرى كالضرائب والانتخابات. ومن المفروض أن تقام كل هذه المحاكم بموجب القانون، كما يرد في القانون الأساسي الفلسطيني، لكن إنشاء معظمها جاء عن طريق مراسيم رئاسية.[45]
ورغم أن القانون الأساسي (2002) وقانون استقلال القضاء (2002) ينصان على استقلالية السلطة القضائية وعلى إنشاء مجلس القضاء الأعلى لكي يتولى تعيين القضاة والإشراف على عملهم وتدريبهم ونقلهم وعزلهم، فإن الصراع على النفوذ بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ما يزال مستمراً حتى الآن. ويعود ذلك (جزئياً على الأقل) إلى انعدام وجود إجراءات وأنظمة محددة تحكم وظائف كل من الجهتين.
ومع ازدياد حالة الفوضى وانعدام القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ازداد تعرض القضاة إلى الهجمات وأعمال التخويف من جانب الجماعات المسلحة والعشائر القوية. ففي 21 فبراير/شباط 2005، بعث المعاون السابق لرئيس محكمة الاستئناف في الضفة الغربية القاضي زهير بشتاوي رسالة إلى الرئيس عباس تحمل 12 توصيةً لتحسين أداء السلطة القضائية. وكان من أبرز انتقاداته الافتقار إلى الأمن، وتعيين قضاة غير أكفاء، والافتقار إلى المراقبة والإشراف الحقيقيين على القضاء، إضافةً إلى تسييس القضاء. وهو يقول:
يتعرض المحامون للتهديد والقضاة للابتزاز. ويتجاوز الناس حدودهم مع القضاة والمحامين ولا تحرك الشرطة ساكناً. ولم تعد ظروف عملنا آمنةً بسبب تدخل الجماعات المسلحة التي تدخل قاعة المحكمة للتدخل في مداولتنا. وقد صار ذلك أمراً شائعاً في كثيرٍ من المحاكم. وفقد كثيرٌ من الناس ثقتهم بالقضاء وبقدرته على الفصل في النزاعات القانونية، وراحوا يستعينون بأفراد العصابات.[46]
وفي أبريل/نيسان 2005، أغار ثلاثة أشخاص، أحدهم يحمل مسدساً، على مكتب البشتاوي طالبين من القاضي ومساعده التنحي عن إحدى الدعاوى. وبعد عدة أشهر، دعت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى إضرابٍ لمدة يوم واحد وأصدرت بياناً ينتقد ظروف العمل غير الآمنة في مهنة القانون، وتزايُد ميل الناس إلى أخذ القانون بأيديهم، وفشل الفرعين التشريعي والتنفيذي في السلطة الفلسطينية في حماية النظام القضائي.[47]
وفي حالة النظر القضائي الفعلي يجب أن تقام دعاوى جزائية أمام المحاكم العادية في جميع قضايا العنف على أساس الجنس، كسوء المعاملة المنزلية وسفاح القربى والاغتصاب وقتل الفتيات والنساء باسم "شرف العائلة". ويمكن للمرأة أيضاً أن تدّعي أمام المحاكم الشرعية ضد زوجها بإساءة معاملتها في المنزل، لكن ذلك لا يكون إلا بقصد تبرير طلب التفريق بينهما استناداً إلى الضرر الذي يصيبها وليس بقصد توجيه اتهامات جنائية إلى الزوج.
القوانين النافذة
تعتبر القوانين النافذة اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة مزيجاً من القوانين الموحدة التي سنها المجلس التشريعي منذ عام 1996[48] ثم صادق عليها الرئيس، ومن القوانين المصرية والأردنية التي مازالت ساريةً في غزة والضفة الغربية على الترتيب، وذلك في المجالات التي لم يجر فيها سن قانون فلسطيني موحد بعد. وفي المجالين الأوثق صلةً بهذا التقرير، وهما قانون العقوبات وقانون الأسرة، مازال القانونان الأردني والمصري نافذين حتى الآن، رغم وجود مشروعي قانون العقوبات وقانون الأسرة الفلسطينيين الموحدين، ورغم أنهما خضعا لنقاشٍ واسع في دوائر المجتمع المدني كما نرى في فصولٍ لاحقة من هذا التقرير. لكن عدداً من أحكام هذين القانونين يُبقي على عدم مساواة المرأة الفلسطينية.
إن قانون الأحوال الشخصية الأردني (1976) وقانون حقوق الأسرة المصري (1954) يحكمان جميع ما يتعلق بقانون الأسرة بالنسبة لسكان الضفة الغربية وغزة من المسلمين. وهذان القانونان تمييزيان من حيث حقوق الرجل والمرأة في الأسرة. ويحدّ كلاهما من قدرة المرأة الفلسطينية على اتخاذ قرار حر بشأن زواجها من خلال الشروط التي يضعانها مثل موافقة أحد أوليائها الذكور. وهما يسمحان للزوج بتطليق زوجته شفهياً، بينما يشترط على المرأة الحصول على قرار قضائي بالتفريق. ولا تستطيع المرأة الفلسطينية المطالبة بالتفريق إلا استناداً إلى الأذى الذي يلحقه الزوج بها (التفريق لعلة الشقاق). وتفقد المرأة المطلقة حقها في حضانة الأطفال عند وصولهم سن البلوغ.
إن أحكام قانون العقوبات في كلٍّ من الضفة الغربية وغزة تمييزيةٌ بحق النساء أيضاً.[49] ولا يوجد قانونٌ محددٌ يجرّم العنف الأسري أو الجنسي داخل الأسرة. وحتى يتمكن القضاة من النظر في هذه الجرائم فهم يطبقون أحكام قانون العقوبات ذات الصلة بالقضية. ويصنف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 العنف الجنسي (الاغتصاب وسفاح القربى معاً) ضمن الجرائم الواقعة "ضد الأخلاق العامة"، لا كجرائم واقعة ضد السلامة الجسدية للفرد. وتميز القوانين الخاصة بالاغتصاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ضحايا العنف الجنسي استناداً إلى كونهن عذراوات أو غير عذراوات، وهي تقضي بإنزال العقوبة الأشد عندما تكون الضحية عذراء. وتجرّم هذه القوانين أيضاً الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، فهي تجبر ضحايا العنف الجنسي على استمرار الحمل حتى الولادة. والأسوأ من ذلك هو أن القوانين النافذة في الضفة الغربية وغزة تعفي المغتصب من أية ملاحقةٍ قضائية إذا تزوج من الضحية. ولا يعترف كل من قانوني العقوبات المصري والأردني النافذين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعنف الجنسي المرتكب ضمن الزواج. وتنص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني (16/1960)، وهو نافذٌ في الضفة الغربية، على تخفيف عقوبة "جرائم الشرف". وبموجب هذه المادة يعفى من العقوبة كل رجل يقتل أو يهاجم زوجته أو قريبةً له أثناء ارتكابها الزنا. كما يمكن تخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل امرأةً وجدها في "فراش غير شرعي".
أما قانون العقوبات المصري النافذ في غزة فهو يفرض أيضاً عقوبةً أشد على المرأة الزانية. فهو يحكم عليها بالحبس سنتين،[50] بينما يحكم على الرجل بالحبس لمدةٍ أقصاها ستة أشهر.[51] وتختلف الأدلة المطلوبة لإثبات الزنا بين الرجل والمرأة. ففي حين يمكن معاقبة المرأة لارتكابها الزنا أينما كان، لا يمكن اعتبار الفعل الذي يقوم به الرجل جريمة زنا يعاقَب عليها إلا إذا تمت في بيت الزوجية.[52] ويعتبر قتل الزوجة (وليس الزوج) في حالة التلبس بالزنا ضمن فئة الظروف المخففة (العذر المخفف)؛ وهذا ما يخفض جريمة القتل العمد إلى مستوى جنحة.[53]
وعلى الرغم من تقديم المجلس الوطني الفلسطيني مشروعاً جديداً لقانون العقوبات من أجل القراءة الأولى في 14 أبريل/نيسان 2003، فإن المشرعين لم يتوصلوا إلى اتفاقٍ على النص، وما زال المشروع مجمداً منذ ذلك الوقت. وقد تعرض إلى انتقادات المحامين والناشطين الفلسطينيين لعدم أخذه بالمعايير الدولية ولانطوائه على عددٍ من الأحكام البالية المختلف عليها في قانون العقوبات المصري لعام 1937 النافذ حالياً.[54] أما بالنسبة للقانون الحالي النافذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن القانون المقترح يتضمن أحكاماً مخففة بحق مرتكبي "جرائم الشرف"، وهو يميز على نحوٍ تعسفي بين اغتصاب الأطفال تحت سن 15 وبين اغتصاب الأطفال بين 15 و18 سنة؛ بل إن العقوبات الأشد التي يفرضها على اغتصاب الأطفال الأصغر سناً هي أخف من العقوبات التي يفرضها القانون الأردني الحالي.[55] ويتضمن مشروع القانون الذي طرحه المجلس التشريعي الفلسطيني أحكاماً غامضةً وعمومية في المادة 58 التي لا تجرّم باقي الأفعال غير القانونية المرتكبة "بما يتفق مع الشريعة"[56]، ومن غير الواضح كيف سيتم تفسير هذه المادة وتطبيقها.
وضع المرأة الفلسطينية
رغم بعض التحسن في وضع المرأة الفلسطينية خلال العقود القليلة الماضية، فإنها تظل أسوأ حالاً من الرجل من جميع النواحي تقريباً. فما زالت فرص العمل في قطاع العمالة الرسمي قليلةً جداً أمام المرأة. وفي عام 2005، بلغت نسبة المشتغلات رسمياً فوق 15 سنة 14.1%، وذلك بالمقارنة مع 67.8% من الرجال ضمن نفس الفئة العمرية.[57] ومن بين النساء العاملات، يعمل قرابة النصف في قطاع الخدمات ذي الأجور المتدنية.[58] وتنال المرأة في جميع القطاعات أجراً أقل من الرجل مقابل نفس العمل. فالأجر الوسطي اليومي للرجل هو 78.1 شاقلا (17.35 دولار) بالمقارنة مع 63.1 شاقلا (14 دولار) للمرأة الفلسطينية.[59]
ويحظر قانون العمل الفلسطيني الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000 على المرأة الاشتغال "بالأعمال الخطرة والقاسية كما يحددها الوزير، وكذلك العمل لساعات إضافية أثناء الحمل ولستة أشهر بعد الولادة، إضافةً إلى المناوبات الليلية إلا ما يحدده مجلس الوزراء".[60] ومع أن للمرأة حقاً قانونياً في امتلاك الأراضي والعقارات والتصرف بما يملكنه، فنادراً ما تمارس هذا الحق. وقد خلصت دراسةٌ أجرتها "فريدم هاوس" عام 2005، واستشهدت بدراسةٍ لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن نسبة الفلسطينيات اللواتي يملكن بيتاً أو عقاراً هي 7.7% فقط، وأن 1% منهن فقط لديهن سيارات خاصة.[61] وبينت الدراسة أيضاً أن 20% فقط من النساء يعتقدن بحقهن في نيل نصيبٍ من إرث العائلة.[62] وفي عام 2002، بلغت نسبة الفقر في الأسر التي تعيلها امرأة 30 % بالمقارنة مع 20% لدى عموم السكان.[63]
ولا يوظف نظام العدالة الجزائية النساء إلا على نحوٍ هامشي، فهن يمثلن 9% من مجموع القضاة و12.2% من المدعين العامين.[64] ولا توجد قاضيات في المحاكم الشرعية، كما لا توجد نساء في مواقع القضاة غير الرسميين ضمن نظام العدالة غير الرسمي. وتشكل النساء 31.2% من مجموع المحامين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[65]
ويقول مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أنه، رغم كون نسبة الأمية بين النساء أعلى منها بين الرجال (12% مقابل 2.3%[66])، فإن هذا الميل آخذٌ في التغير مع الجيل الحالي لأن عدد البنات المسجلات في المدارس الرسمية يفوق عدد الأولاد، سواءٌ في التعليم الابتدائي (93.6% من البنات مقابل 92.8% من الأولاد) أو الثانوي (75.7% من البنات مقابل 67.6% من الأولاد).[67] ورغم وجود تسرب للبنات من المدرسة في سن المراهقة من أجل الزواج، فإن الأولاد أكثر ميلاً لترك المدرسة في سنٍّ مبكرة بغية تحقيق دخل للأسرة، وخاصةً في فترات اشتداد الفقر والبطالة كما هي الحال أثناء الانتفاضة الثانية.[68] ويكاد يتساوى تمثيل النساء والرجال في مؤسسات التعليم العالي، لكن هذا الواقع لم يُترجم بعد إلى وجود مزيدٍ من النساء في المواقع المهنية، وذلك ما يلحظه تقرير التنمية البشرية الفلسطينية لعام 2004.[69]
ومن التطورات الإيجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة زيادة عدد النساء في المراكز المنتَخبة. ويعود معظم الفضل في هذا الإنجاز إلى الناشطات النسائيات اللواتي عملن من أجل حصة نسائية تضمنها قانون الانتخابات الذي سنه المجلس التشريعي عام 2004 (للانتخابات المحلية) وعام 2005 (للانتخابات التشريعية الوطنية).[70] ومنذ ذلك الوقت، جرت أربع جولات انتخابات محلية من أصل خمس جولات في الضفة الغربية وغزة وهي أول انتخابات من نوعها منذ 28 عاماً. وقد حازت فيها النساء عدداً مهماً من المقاعد، حيث شاركت 139 امرأة في الانتخابات البلدية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2004، وفازت 52 منهن بعضوية المجالس المحلية أي قرابة 17% ممن تم انتخابهم.[71] كما حققت النساء نتائج مماثلة في الجولات اللاحقة من هذه الانتخابات. ومنذ عام 1994 كانت السلطة الفلسطينية تعين المجالس المحلية، لكن نسبة النساء لم تتجاوز أبداً 5% من تلك التعيينات.[72] وكما ذكرنا أعلاه فقد ازداد تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية الثانية إذا فازت النساء بـ 17 مقعداً، أو 13% من المقاعد.
ومازال تمثيل النساء هامشياً في الحكومة الفلسطينية، فهناك امرأة واحدة بين 24 وزيراً، وهي د. مريم صالح العضو المنتخب عن حماس في المجلس التشريعي، وهي من رام الله وتشغل حالياً منصب وزيرة شئون المرأة. وكان أكبر وجود نسائي بين وزراء السلطة الفلسطينية خلال العامين التاليين لتشكيل أول حكومة فلسطينية عام 1996 حيث شغلت النساء كلاً من منصب وزير التعليم العالي ومنصب وزير الشئون الاجتماعية.
ويؤدي وضع المرأة ضمن الصف الثاني في الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية إلى ضعف قدرتها على صنع القرار في الأسرة، وذلك حتى في أكثر الأمور التصاقاً بحياتها الخاصة. وغالباً ما يتولى الأقارب الذكور (الآباء عادةً) أمر ترتيب زواج الفتيات الفلسطينيات، وذلك قبل بلوغهن أحياناً. وفي استبيان شمل 1446 امرأة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وجد مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أن نسبة من اخترن أزواجهن لم تتجاوز 56.5%.[73] أما في المناطق الريفية، فكانت النسبة 36% من أصل 460 امرأة شملهن هذا الاستبيان.[74]
حركة حقوق المرأة الفلسطينية
تتميز حركة حقوق المرأة في فلسطين بتاريخ طويل، حيث لعبت دوراً هاماً في النضال من أجل حق تقرير المصير للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[75] وغالباً ما واجهت هذه الحركة خيارات استراتيجية صعبة حول كيفية الموازنة بين الالتزام بالكفاح الوطني والكفاح النسائي.[76] وقد هاجمت الفصائل السياسية والجماعات الإسلامية حركة المرأة الفلسطينية في مناسباتٍ كثيرة متهمةً إياها بأنها جزءٌ من مؤامرةٍ غربية لتخريب الأسرة الإسلامية والقيم الاجتماعية ومشككةً في التزامها بالقضية الوطنية.[77] كما تحدثت كثيرٌ من الناشطات في المنظمات غير الحكومية ممن قابلتهن هيومن رايتس ووتش عن تعرضهن إلى مواجهاتٍ ومضايقاتٍ ومحاولات تخويف أثناء عملهن.[78]
وفي التسعينات، أي بعد الانتفاضة الأولى واتفاقيات أوسلو، ركزت الناشطات النسائيات على المساواة بين الجنسين في المؤسسات الجديدة وفي القوانين الجديدة التي تضعها السلطة الفلسطينية.[79] وفي 1994، صاغت نساءٌ فلسطينيات "مذكرة حقوق المرأة" وقدمنها إلى السلطة الفلسطينية.[80] وتبنت هذه المذكرة الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما شددت على الحاجة إلى العدالة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في هيكلية الدولة الفلسطينية الوليدة.[81]
وفي عام 1994، أطلقت المنظمات النسائية وحلفاؤها عمليةً طموحة من خمس سنوات سميت "برلمان النموذج النسائي وإصلاح قانون الأحوال الشخصية" لتعديل قانوني الأحوال الشخصية المصري والأردني النافذين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتراح تغييرات تنطلق من المساواة بين الجنسين. ثم استخدمت هذه المنظمات التوصيات النهائية للبرلمان النموذجي لكسب تأييد أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.[82] لكن الحركة النسائية انقسمت بين من ينادون بقانون مدني للأسرة وبين من يرون أن أفضل فرصة للتأثير في صياغة أحكام قانون الأسرة الفلسطيني الموحد الجديد تتمثل في السعي نحو تفسيرٍ تقدميٍّ للشريعة.
وقالت لنا ناشطات نسائيات في المنظمات غير الحكومية أنهن تمكن من إقناع قاضي القضاة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بإدخال ضمانات هامة في مشروع القانون[83] الذي يصيغه، ومن بينها: تحديد السن الأدنى لزواج المرأة والرجل بـ18 عاماً؛ وتقييد (وليس إلغاء) حق الرجل في تعدد الزوجات؛ وتسهيل حصول المرأة على الطلاق من خلال "الخلع"؛ وأسباب إضافية للطلاق من بينها "الخلاف الذي لا سبيل لإصلاحه"، واعتبار العقم سبباً للطلاق من الجانبين؛ والقسمة المتساوية للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج؛ والتعويض على المرأة التي تثبت أن زوجها طلقها تعسفاً؛ وإقامة صندوق حكومي لإعالة المرأة والأطفال بعد الطلاق. وقدم قاضي القضاة مشروع قانون الأسرة إلى وزارة العدل عام 2002، لكن الوزارة لم تطرح المشروع على المجلس التشريعي حتى الآن.
وكان للنساء الفلسطينيات نشاطٌ فاعل على مستوى الشبكات الإقليمية والدولية. ففي عام 1995، شارك وفد فلسطيني في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين. وانطلاقاً من المعايير التي وضعها قرار مجلس الأمن رقم 1325 من أجل إشراك المرأة في العملية السلمية،[84] أسست المنظمات النسائية غير الحكومية في يوليو/تموز 2005 "الهيئة الدولية للنساء من أجل سلام فلسطيني-إسرائيلي عادل ودائم" التي تهدف إلى إشراك النساء الفلسطينيات والإسرائيليات ونساء العالم في جميع مباحثات السلام في المستقبل.[85] وفي أوائل 2005، أنشأت شبكةٌ من خمس منظمات نسائية في لبنان ومصر والأردن والضفة الغربية وغزة مجموعةً أطلق عليها اسم "سلمى" تهدف إلى إطلاق حملةٍ لتجريم العنف الأسري.[86] وصاغت هذه المجموعة مشروع قانون حماية الأسرة وبدأت أعمال التدريب والتثقيف الاجتماعي حول قضايا العنف في الأسرة.[87]
إضافةً لما سبق، أطلقت المنظمات النسائية غير الحكومية عام 2002 منتدى العنف ضد النساء في فلسطين، وهو شبكة تضم 13 منظمة غير حكومية تتعاون على محاربة العنف المستند إلى النوع الاجتماعي. ولدى كثير من هذه المنظمات خطوط هاتفية ساخنة، وهي تقدم خدمات قانونية واجتماعية لضحايا العنف. كما أقامت المنظمات من خلال هذا المنتدى خدمة استشارية غير رسمية تُمكّن الضحايا من الحصول على خدمات واستشارات تخصصية. ويضغط هذا المنتدى على السلطة الفلسطينية لكي تقيم نظام خدمةٍ استشاريةٍ حكومي. ويشارك أعضاء المنتدى في المظاهرات ومناسبات الخدمات الاجتماعية ونشاطات التوعية، إضافةً إلى تقييم مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة.[88]
ومن الإنجازات الأخرى للحركة النسائية الفلسطينية إحداث وزارة شئون المرأة عام 2003، وقد تولتها حتى وقتٍ قريب ناشطة نسائية بارزة هي زهيرة كمال. إضافةً إلى إقامة مكاتب خاصة بقضايا النوع الاجتماعي في وزاراتٍ كثيرة. وتشمل مهام وزارة شئون المرأة مراقبة التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين التي يقررها القانون الأساسي، وذلك من خلال "بناء القدرات على جميع مستويات الحكومة، وتطوير السياسات الحكومية والقوانين والتشريعات، واعتماد الخطط اللازمة لضمان التزام الحكومة بإدخال النوع الاجتماعي في خططها التنموية، واعتماد وتنفيذ سياسات تمييز لصالح المرأة".[89]
وتملك الوزارة صلاحية إعادة النظر في مشاريع القوانين واقتراح قوانين جديدة. لكن أفراد كادر هذه الوزارة والمنظمات النسائية غير الحكومية يشتكون من أن السلطة الفلسطينية لا تهتم غالباً بتوصيات الوزارة ولا تمنحها إلا دعماً مالياً قليلاً.[90] فعلى سبيل المثال، لم يتجاوز نصيب الوزارة من موازنة الحكومة لعام 2005 نسبة 0.02%.[91]
العقبات الاجتماعية والقانونية أمام الإبلاغ عن العنف وطلب التعويض
نادراً ما تقوم النساء والفتيات الفلسطينيات بإبلاغ السلطات عن العنف. ويصح هذا سواءٌ كانت الجريمة عنفاً زوجياً أو إساءةً إلى الأطفال أو اغتصاباً أو سفاحاً بين المحارم أو "جرائم شرف". وتدل قلة حالات الإبلاغ عن هذه الجرائم على أهمية العقبات الاجتماعية والقانونية التي مازالت تعترض سبيل منع العنف ذي الأساس الجنسي ومعالجته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطبقاً لاستطلاع أجراه مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني في ديسمبر/كانون الأول 2005 ويناير/كانون الثاني 2006 وشمل 4212 أسرةً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تحاول إلا نسبة صغيرة من ضحايا العنف التماس الإنصاف لدى المؤسسات الفلسطينية.[92] وهناك 23% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع ممن تعرضن للعنف الجسدي، بينما تعرضت 61.7% إلى العنف النفسي، وتعرضت 10.5% إلى عنفٍ جنسي من جانب الزوج. ولم تتقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة ضد الزوج إلا نسبة 1.2% من النساء المستطلعات اللواتي تعرضن لعنفٍ منزلي؛ كما لم يحاول سوى أقل من 1% منهن الحصول على المشورة والحماية لدى الشرطة.
وتعزو المنظمات النسائية غير الحكومية انخفاض نسبة الإبلاغ عن العنف إلى جملةٍ من العوامل مثل: قناعة النساء بعدم جدوى التماس العدالة؛ والوصمة الاجتماعية التي قد تنتج عن شكايا العنف الأسري أمام السلطات؛ والخطر المحتمل على حياة من تبلغ عما يصيبها من إساءة؛ وحقيقة كون مرتكب العنف معيلاً وحيداً في الأسرة أغلب الأحيان.[93]
وليست النساء وحدهن من يقع ضحية العنف الأسري بطبيعة الحال، لكن وحتى عندما تكون الضحية أحد الأقارب الذكور، فإن المرأة لا تستطيع أن تفعل شيئاً. وتصف عبير خير (اسم مستعار)، 20 عاماً، المزيج المكون من الخوف والضغوط الاجتماعية والوصمة الاجتماعية الذي منعها من شكايا إساءة والدها وأعمامها إلى السلطات:
ذات مرة خلال عطلة العيد، ضرب والدي أخي على ركبته بمصراع النافذة. وخيّل لي أن أخي سيصاب بنوبةٍ قلبية لشدة ألمه؛ فقد راح يهلوس من الألم. وأراد الطبيب إبلاغ الشرطة، لكن أسرتي لم تسمح بذلك. ولدي شعورٌ بالذنب لأنه ربما كان من واجبي أن أذهب إلى الشرطة آنذاك. ولعل ذلك كان يجعل الأمر يسير بشكلٍ أفضل. لقد فكرت بالذهاب إلى الشرطة في مراتٍ كثيرة، لكنه يظل والدي. فما الذي يقوله الناس عندما تشكو فتاةٌ والدها إلى الشرطة؟ إنه من لحمي ودمي. وأنا آمل أن يحاول معالجة نفسه، لا أن تجبره الشرطة على ذلك. ليس من المعيب أن تحاول الحصول على مساعدة في مشاكلك، لكن الأمر يغدو معيباً إذا كان للشرطة علاقةٌ به. سأحاول إقناع والدتي باستدعاء الشرطة عندما تلم بوالدي نوبةٌ قادمة من العنف، وذلك من أجل والدتي ومن أجل الأسرة، بل من أجل والدي أيضاً. وأنا لا أستطيع النوم عندما يثير والدي المشاكل في البيت، وأظل ساهرةً طوال الليل.[94]
وتبين استطلاعات الرأي العام أيضاً أن المجتمع الفلسطيني يتغاضى عن العنف ضد النساء إلى درجةٍ كبيرة ولا يشجع النساء على الإبلاغ عن سوء المعاملة. وقد وجد استطلاع شمل 1133 امرأةً وقامت به عام 2002 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع المركز الفلسطيني للرأي العام في بيت ساحور، أن 53.7% ممن شملهن الاستطلاع يجدن من غير الملائم أن تتدخل الشرطة عندما يعتدي رجلٌ على زوجته؛ ورأت 55.5% منهن أنه يجدر بمن يضربها زوجها أن لا تتحدث بالأمر مع أحدٍ باستثناء والديها.[95] وعندما سألنا من تعرضن للعنف عن سبب عدم تركهن الزوج المسيء، قالت 70% منهن أنهن رفضن مغادرة المنزل بسبب الخشية من فقدان حضانة الأطفال. ورأت 50% تقريباً أن الطلاق وصمة اجتماعية كبيرة جداً، بينما قالت 21.9% أنه لا يوجد مكانٌ يذهبن إليه إذا غادرن المنزل.
وفي مدينة الخليل مشاكل خاصة تعترض كلاً من عناصر الشرطة والضحايا اللواتي يحاولن الإبلاغ عن تعرضهن للإساءة. والخليل واحدةً من أكثر مدن فلسطين تقليديةً ومحافظةً حيث يعتبر أي تدخلٍ خارجي في "مشاكل الأسرة" أمراً غير مقبول. وقال مدير الشرطة لنا أنه "يمكن أن تُفقأ عين المرأة في الخليل، ثم تظل شديدة الخوف من المجتمع لدرجة تجعلها لا تبلغ الشرطة بالأمر".[96] وتزداد الصعوبات التي تواجهها نساء الخليل تفاقماً بفعل حقيقة استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على جزء من المدينة (يدعى H2) وعدم قدرة الشرطة الفلسطينية على دخول هذا الجزء دون تصريح.[97] ويقول عوني السماري، مدير شرطة الخليل، أن الشرطة تواجه صعوبةً كبيرة في توقيف مرتكبي الجرائم لأن "كل من يهربون من القانون الفلسطيني يذهبون إلى هذه المناطق [التي هي خارج صلاحيتنا]".[98] كما يصعب على نساء المنطقة H2 الوصول إلى مخفر الشرطة لأنه يقع خارج تلك المنطقة.
وهناك أيضاً تقارير من مدن أخرى يتولى الجيش الإسرائيلي الأمور الأمنية فيها تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات يترددن بشكلٍ خاص حيال شكايا الإساءات التي يتعرضن لها إلى سلطات الاحتلال.[99] ففي هذه المدن لا يؤدي الجيش الإسرائيلي وظيفة الحماية الخاصة بعمل الشرطة (ولم يحاول ذلك أبداً)، وهذا مخالفٌ لواجباته بوصفه قوة محتلة.
وعلاوةً على هذه العقبات القانونية والاجتماعية، لا يلعب التشريع التمييزي النافذ في الضفة الغربية وغزة والمذكور أعلاه دور الرادع في وجه العنف، كما لا ينصف الضحايا من الإساءة التي يتعرضن لها. والواقع أن قوانين العقوبات خاصةً، وطريقة تفسيرها وتنفيذها من الناحية العملية، تؤدي إلى إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات من العقاب.[100]
العنف الزوجي
وكما تمت الإشارة في بداية هذا الفصل، خلص استطلاعٌ نشره مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أوائل عام 2006 إلى أن 23.3% من النساء المتزوجات في الضفة الغربية وغزة قمن بالإفادة بتعرضهن للعنف المنزلي في عام 2005، بينما قالت 61.7% أنهن تعرضن للعنف النفسي خلال ذلك العام.[101] وتتحدث عدة منظمات نسائية فلسطينية عن زيادةٍ في وتيرة العنف (المرتفعة أصلاً) ضد النساء عقب الانتفاضة الثانية. وطبقاً لاستطلاعٍ أجراه مشروع موارد النساء اللاجئات عام 2002، فإن قرابة 90% من المشاركين في الاستطلاع قالوا أن العنف ضد المرأة "ازداد، أو ازداد بشكلٍ كبير، نتيجةً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في الأراضي الفلسطينية".[102] وثمة أدلةٌ أيضاً على أن الاغتصاب الزوجي منتشرٌ في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويكشف استطلاع أجراه مركز شئون المرأة في غزة عام 2001 أن 46.7 % من أصل 670 امرأة جرت مقابلتها تحدثن عن استخدام أزواجهن "القوة والوحشية" أثناء الجماع؛ وقالت 17.4% منهن أن أزواجهن يضربونهن من أجل ممارسة الجنس؛ وقالت 35.9% أن أزواجهن يهددونهن ويخوفونهن للحصول على طاعتهن.[103]
إن أمام المرأة الفلسطينية التي تعيش زواجاً عنيفاً أو خطراً على حياتها خيارين اثنين: اتهام الزوج بالإساءة إليها، أو طلب الطلاق بسبب الأذى الجسدي. ويتطلب هذان الحلان أدلةً على العنف الشديد ويلقيان بعبء الإثبات الفادح على عاتق الضحية. ولا يعترف قانون العقوبات الأردني أو قانون العقوبات المصري النافذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعنف الجنسي المرتكب ضمن إطار الزواج.
وبسبب عدم وجود تشريع يختص بالعنف الأسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتوجب على ضحايا العنف من الراشدين الاعتماد على أحكام قانون العقوبات العام الخاصة بالاعتداء عندما يريدون توجيه الاتهام إلى مرتكب العنف. ولا يقدم هذان القانونان عونٍا كبيرا للضحايا إلا إذا كانت الأذية اللاحقة بهم كبيرةً جداً. وتعتمد العقوبات التي تفرضها المادة 33 من قانون العقوبات الأردني (المطبق في الضفة الغربية) على عدد الأيام التي تمضيها الضحية في العلاج.[104] وكما في جميع قضايا الاعتداء، يمكن للقاضي عدم النظر في القضية واعتبارها "مخالفة بسيطة" إذا احتاج علاج الضحية أقل من 10 أيام.[105] وفي هذه الحالات تحاول النيابة العامة أيضاً المصالحة بين الطرفين بدلاً من توجيه الاتهام.[106] ويسمح القانون للقاضي بفرض عقوبة أشد قليلاً عندما يتطلب علاج الضحية 10 – 20 يوماً. وطبقاً للقانون، لا تكون الملاحقة القضائية إلزاميةً إلا عندما يتطلب علاج الضحية أكثر من 20 يوماً.[107] وبما أن ضحية العنف الأسري يمكن أن تذهب إلى المستشفى عدة مرات لمعالجة إصاباتها دون أن تكون لديها نية تقديم اتهام رسمي، فقد لا يكون لديها أوراق طبية تثبت ادعاءها وبوقوع إساءة تتطلب علاجاً مديداً إذا ما قررت فيما بعد توجيه هذا الاتهام بغية الحصول على الطلاق.
ويمكن للمرأة أيضاً أن تطلب الطلاق استناداً إلى إساءة الزوج إليها. لكن قانون الأحوال الشخصية الحالي يفرض وجود شاهد عيان حتى يتم قبول طلب المرأة؛ وهذا أمرٌ صعبٌ إن لم يكن مستحيلاً في معظم الأحوال. وحتى يستطيع القاضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منح المرأة الطلاق استناداً إلى العنف الأسري (تفريق لعلة النزاع والشقاق)، فإن القانون يفرض على المرأة الفلسطينية تقديم شاهدين وتقرير طبي صادر عن مستشفى عام لإثبات دعواها.[108]
وقد قال لنا بعض المحامين أن ضرورة وجود شاهد عيان تمثل عائقاً رئيسياً أمام طلب الطلاق استناداً إلى الأذى الجسدي. وقالت إحدى المحاميات: "عندما تُضرب امرأةٌ في بيتها فمن يستطيع أن يكون شاهداً؟".[109] ومما يزيد هذه الصعوبة هو أن القانون لا يقبل شهوداً من أقارب طالبة الطلاق.[110] وعادةً ما يطلب القاضي شهادة الزوج أيضاً. ويقول المحامي علاء البكري أن الزوج يستطيع تحت القسم أن ينكر ببساطةٍ إساءته إلى زوجته إذا لم تستطع تقديم الدليل الكافي على الأذى اللاحق بها، فيقوم القاضي بإسقاط التهمة.[111] "وأحياناً ترى شقيقة الزوجة ما يصيبها من إساءة، لكن هذا غير كافٍ. إننا بحاجةٍ إلى شاهدين؛ وإذا أقسم الزوج أنه لم يفعل ذلك فالأمر منتهٍ والقضية مقفلة".[112] ويقول رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي يوسف الديس أن القضاة يردون 50% من دعاوى الطلاق التي تقيمها الزوجات بسبب نقص الأدلة.[113]
ولا تلجأ إلى القضاء إلا النساء الفلسطينيات اللواتي يعانين درجةً شديدةً من الإساءة. وتقول إحدى المحاميات أن "المرأة [ضحية العنف] تفكر مائة مرة قبل أن تذهب إلى المحكمة. فهي تظن أنها تجلب الفضيحة لنفسها لا غير. وفي جميع الأحوال، لابد من معاودة الإساءة حتى يقتنع القاضي؛ فمرةٌ واحدة غير كافيةٍ أبداً".[114]
وعلاوةً على العوائق القانونية، غالباً ما تنشأ عوائق مالية واجتماعية يكاد يستحيل التغلب عليها تعمل على منع المرأة الفلسطينية من ترك الزوج المسيء إليها. ويقول عددٌ من الأخصائيين الاجتماعيين أن كثيراً من النساء اللواتي يستفدن من خدماتهم يبقين في كنف أزواج يمارسون العنف بحقهن لأن الأهل لا يرغبون أو لا يستطيعون تحمل الكلفة المالية المترتبة على إعالة أطفال الضحية. ومع انخفاض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل، تكون معظم النساء غير قادراتٍ على إعالة أنفسهن وأطفالهن. ولا ترغب المرأة بترك أطفالها مما يجعلها لا ترى أمامها خياراً إلا أن تبقى عرضةً للعنف كما هي. وقد تحدثت امرأةٌ لهيومن رايتس ووتش عن صعوبة الاختيار بين البقاء مع زوجٍ يسيء إليها جسدياً وجنسياً وبين فقدان أطفالها:
لدي أربع بنات وصبي. وقد واصلت العيش في ذلك الوضع المرعب لأنني أخاف أن أذهب إلى أهلي وأخسر أطفالي. لذا قررت أن أبقى وأتحمل العذاب، فلا خيار لدي غير ذلك.
وقد وصفت فيما بعد كيف ذكرها زوجها بورطتها: "قال زوجي أنني إذا طلبت الطلاق فسأفقد أطفالي ولن يقبل بي والدي".[115]
دفع اليأس بعض النساء الفلسطينيات إلى قتل أزواجهن الذين يسيئون إليهن. وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى كثيرٍ من النساء اللواتي يشعرن أن ما من سبيلٍ أمامهن للخلاص من المعاناة إلا قتل أزواجهن. وقالت لنا إحداهن، وهي مريم إسماعيل (اسم مستعار)، 35 عاماً، أنها كانت مجبرةً على فعل ذلك بعد أن تحملت الإساءات الجسدية والجنسية لسنواتٍ طويلة:
كان يضربني في كل مكان. ولم أذهب إلى المستشفى قط، بل لم أخبر أهلي أبداً. كنت أشكر الله لبقائي حيةً. لكن العنف ازداد جسدياً وجنسياً. كان يجلب أشخاصاً آخرين ليمارسوا الجنس معي ويسيئون إلي. وكان يمسك بي أثناء إساءتهم لي... ولو كنت أرى فرصةً بنسبة 1% لتغيير الوضع بأي شكل لما قتلته أبداً.
سألتني الشرطة لماذا لم أذهب إلى أهلي فقلت لهم أن عائلتي كانت ستقتلني على الأرجح لأنني نمت مع أشخاصٍ آخرين. وهي لا تصدقني حتى الآن. وقد أطلعت الشرطة أهلي على التقارير التي تبين كيف أُجبرت على معاشرة رجالٍ آخرين. والشرطة نفسها تقول أنها لا تلومني لقتله بعد ذلك كله. لكن أهلي فوجئوا بالتقرير ولم يصدقوه.[116]
وعند إجراء هذه المقابلة، كانت مريم في سجن نابلس تنتظر محاكمتها بتهمة القتل.
الإساءة إلى الأطفال
إن الأطفال الفلسطينيين، وخاصةً البنات، معرضون للعنف الجسدي والجنسي ضمن الأسرة كما هي حال الأطفال في العالم كله. وثمة حاجةٌ إلى القوانين الملائمة التي تحميهم. وقد وجد استطلاعٍ نشره مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني عام 2005 أن 51.4% من الأمهات يعتقدن أن واحداً على الأقل من أطفالهن (من 5 إلى 17 سنة) يتعرض للعنف. وكانت الغالبية الساحقة من حالات العنف هذه (93.3%) من قبل أفراد العائلة.[117] وفي دراسةٍ أخرى قالت 80% من البنات الفلسطينيات بين 5 و 17 عاماً أنهن يتعرضن إلى العنف في المنزل.[118]
وروت لنا فتاةٌ من غزة كيف أصاب عنف والدها الأسرة منذ بدء الانتفاضة:
كان الوضع هكذا خلال السنوات الخمس الماضية. أما قبلها فكان الأمر على ما يرام. كان أبي يعمل في إسرائيل ويكسب مالاً. لقد كان شخصاً عنيفاً، لكنه كان في تلك الأيام يغيب عن المنزل معظم الوقت وكانت شجاراته تجري مع أشخاصٍ آخرين. لكن، ومنذ بدء الانتفاضة صار عاطلاً عن العمل وموجوداً في المنزل. وهو يثير المشاكل هنا كلما صار يمضي وقتاً طويلاً في المنزل.[119]
وقد هربت كريمة أحمد (اسم مستعار)، وهي فتاةٌ أخرى تبلغ 19 عاماً، إلى أحد الملاجئ عندما كان عمرها 17 عاماً للخلاص من عنف والدها وزوجته. وحاولت الانتحار عدة مرات أثناء وجودها في الملجأ. وقد قالت لنا:
تزوج والدي بعد 40 يوماً من وفاة والدتي. وكانت [زوجة أبي] تضربني وتضرب أخواتي وتعاملنا معاملة سيئة. كما حاول والدي الإساءة إلي [جنسياً] عندما كنت في السادسة تقريباً. لقد فعل ذلك معي ثم مع أختي. وهي في الثامنة عشرة الآن. لقد وددت أن أخبر الجميع بذلك وأن أصرخ. لماذا يفعلون بنا هذا؟.[120]
وبما أن كريمة لم تخبر الشرطة بما تعرضت له، وبما أن والدها وزوجته لم يلاحقا قضائياً، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستجري محاسبتهما على ما فعلاه بالنظر إلى الثغرات الخطيرة في القانون الفلسطيني فيما يتعلق بالإساءة إلى الأطفال. وفي حين يحظر الدستور الفلسطيني (أو القانون الأساسي) العنف ضد الأطفال،[121] فإن قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية يسمح للوالدين بتأديب الأطفال عبر استخدام العنف الجسدي. وتقول المادة 62 من هذا القانون: "لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. ويجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام".[122] وتنكر المادة 286 من هذا القانون على الأطفال الذين يقعون ضحية سفاح القربى حق توجيه الاتهام بالإساءة الجنسية. ولا يمنح القانون حق توجيه الاتهام بسفاح القربى نيابةً عن القصّر إلا لأحد أفراد الأسرة، وقد يكون هو من ارتكب ذلك الفعل.[123] وفي عام 2004، قالت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال/قسم فلسطين "إن النظام القانوني الحالي، وهو خليطٌ من خمسة أنظمة قانونية على الأقل، لا يفتقر إلى الوحدة وتلبية المعايير الدولية فحسب، بل هو قاصر بشكل خطير عن حماية مصلحة الطفل".[124]
سنت السلطة الفلسطينية قانون الطفل في يناير/كانون الثاني 2005،[125] وكانت تلك خطوةً باتجاه عدم التسامح مع الإساءة إلى الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعدد القانون الحقوق الأساسية الاجتماعية والثقافية والصحية التي يضمنها لأطفال فلسطين داخل الأسرة والمجتمع الفلسطينيين؛ وهو يذكر أيضاً التدابير والآليات الوقائية المتاحة لهم. ومن أبرز سمات هذا القانون إنشاء آلية للإبلاغ عن العنف من خلال إحداث مديرية حماية الطفولة في وزارة الشئون الاجتماعية. وهذه المديرية مسئولة عن "ضمان عدم تعرض الأطفال إلى العنف في الأماكن العامة والخاصة، وعن الإشراف على رعاية الأطفال الذين تعرضوا للعنف".[126] ويتضمن القانون أيضاً حكماً عاماً ينص على أن الأطفال "يملكون حق الحماية من جميع أشكال العنف والأذى الجسدي والنفسي والجنسي، وكذلك من الإهمال والتشرد وأي شكلٍ آخر من سوء المعاملة أو الاستغلال". لكن، ومن غير إلغاء ما يتضمنه قانون العقوبات من أحكامٍ لا تسمح لغير الأقارب الذكور بتقديم تهم السفاح نيابةً عن القصّر، فإن ضمانات الحماية التي يحملها قانون الطفل تفقد مغزاها إلى حدٍّ كبير. وقد انتقدت المنظمات غير الحكومية التعريف الحصري الوارد في القانون لـ "الحالات الصعبة" التي تستحق حمايةً خاصة،[127] وانتقدت امتناعه عن التحديد الدقيق للجهة الحكومية المسئولة عن تطبيق تدابير الحماية الواردة في القانون، إضافةً إلى أنه لا ينص على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل.[128]
العنف الجنسي
يقع عددٌ غير معروف من النساء والفتيات الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضحية الإساءة الجنسية كل سنة. ويقول العاملون الاجتماعيون الفلسطينيون أن عدداً قليلاً منهنّ يبلغن السلطات أو الأسرة عن هذا العنف. كما يصل عددٌ أقل إلى النيابة العامة بسبب الوساطات التي تحدث أحياناً بين الضحية والمغتصب، أو بين الأسرتين.[129] وقد قال لنا نائبٌ عام عمل لأكثر من ست سنوات في الخليل وبيت لحم أنه لم يتعامل إلا مع قضيتي عنف جنسي طوال هذه الفترة.[130]
وإضافةً إلى خوف الضحية من لوم الأسرة، أو من أذاها، نتيجةً لما تعرضت له،[131] فإن عدداً من العقبات القانونية تعترض سبيل الضحية التي تقصد القضاء الفلسطيني سعياً وراء العدالة في حالات العنف الجنسي. ومن هذه العقبات الطبيعة التمييزية والمسيئة للقوانين التي تمنع القصّر من تقديم الاتهام بالسفاح وتسمح للمحاكم بوقف تنفيذ الحكم بحق المغتصب الذي يوافق على الزواج من ضحيته. كما يمثل غياب الخبرات والأدوات الضرورية للبحث الجنائي في قضايا العنف الجنسي عقبةً إضافية. وطبقاً لما قاله المدعي العام الذي سبق ذكره فإن "المشكلة الأولى في فلسطين هي أنه يصعب جداً إجراء هذا النوع من البحث الجنائي لأننا لا نملك القدرة الفنية على جمع الأدلة أو إجراء الفحوصات المخبرية".[132]
تلحق وصمةً عار اجتماعي بضحايا العنف الجنسي في فلسطين. فالنساء والفتيات اللواتي يبلغن عن اغتصابهن أو تعرضهن لسفاح القربى يتعرضن لخطرٍ كبير يتمثل في وقوع اعتداءاتٍ جديدة، بل في قتلهن أيضاً على يد أفراد العائلة الساعين إلى إزالة هذه "اللطخة" عن سمعة العائلة. وتقول إحدى العاملات الاجتماعيات أن حالات السفاح تشهد "... ضياع صوت الضحية أو إسكاته دون أن يسمعه أحد في خضم كثرةٍ من الاعتبارات المتعلقة بثقافة المجتمع".[133] وعادةً ما تلقي الأسرة باللائمة على ضحية الاغتصاب أو السفاح متسائلةً عن سلوكها ولباسها وكيفية تصرفها، إذ تعتقد أن ذلك هو ما حرّض المهاجم على فعلته. وتقول إحدى ناشطات حقوق المرأة انطلاقاً من خبرتها: "في حالات الاغتصاب والمضايقات الجنسية، يعتبر الجميع أن الذنب يقع على المرأة. وهم يقولون: 'لو لم تكوني راضيةً لما فعل بك ذلك'".[134]
وتقول إحدى العاملات الاجتماعيات أن أفراد الأسرة يمنعون كثيراً من الفتيات اللواتي يقعن ضحية الاغتصاب والسفاح من إتمام تعليمهن، ويجبروهن على الزواج المبكر لتغطية الأمر.[135] وغالباً ما تؤدي هذه الزيجات إلى استمرار دورة العنف والإساءة واشتدادها. والواقع كما نرى لاحقاً هو أن الزواج يعفي المغتصب من الملاحقة القضائية على فعلته. وتقول إحدى ناشطات حقوق المرأة:
تعامل قضايا الاغتصاب معاملةً خاصة في مخافر الشرطة. وفي معظم الأحيان تكون النتيجة أنهما [المغتصب والضحية] يتزوجان على أساس تجنب الفضيحة. ونادراً ما تصل قضايا الاغتصاب إلى المحكمة... وفي جميع هذه القضايا تحاول الشرطة إيجاد حل للأمر ضمن الأسرة دون توثيق الواقعة.[136]
ويعترف القضاة بأن هذا الوضع يمثل مشكلةً. ويقول القاضي هاني الناطور: "ثمة كثيرٌ من حالات الاغتصاب، لكن ما يصل منها إلى القضاء ليس إلا نسبةً محدودة. فالناس تخاف الفضيحة، وهذا ما يجعل النسبة محدودةً. كما أن قضايا السفاح قليلةٌ جداً، إذ لا يبلغ عنها إلا من كان شديد الشجاعة وعارفاً بالقانون".[137]
إن التصنيف القانوني للجرائم الجنسية في قانون العقوبات في الضفة الغربية مشبعٌ بالمشاكل أيضاً. فقانون العقوبات الأردني (16/1960) يصنف العنف الجنسي (الاغتصاب والسفاح معاً) ضمن الجرائم "المخلة بالأخلاق والآداب العامة". وهذا لا يعكس طبيعة الجريمة على نحوٍ صائب.[138] يجب اعتبار جميع الاعتداءات الجنسية جرائم واقعة ضد الفرد أساساً، وذلك بمعزلٍ عن كونها جرائم ضد قيمٍ أو معاييرَ بعينها.
الاغتصاب
لقد فشلت السلطة الفلسطينية في إيجاد البيئة القانونية التي تحمي المرأة من الاغتصاب وتشجع الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم أو التي تردع المغتصب. وتميز قوانين الاغتصاب السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ضحايا العنف الجنسي العذراوات وغير العذراوات. وهي تفرض عقوبات أشد عندما تكون الضحية عذراء. وفي هذه القوانين ثغرات تؤدي في النهاية إلى إعفاء المغتصب من العقوبة وتمتنع عن الاعتراف بالعنف الجنسي الواقع ضمن الزواج. تجرّم هذه القوانين أيضاً الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، فهي تجبر ضحايا العنف الجنسي على استمرار الحمل حتى الولادة.
ويعكس التعامل القانوني مع الاغتصاب مدى الاهتمام الاجتماعي بعذرية الأنثى. وتنص المادة 301 من قانون العقوبات الأردني (16/1960) المطبق في الضفة الغربية على زيادة عقوبة الاغتصاب "بمقدار الثلث أو النصف" إذا فقدت الضحية عذريتها نتيجةً الاغتصاب.[139]وباعتبار اغتصاب العذراء ظرفاً مشدداً للعقوبة، يبعث القانون برسالةٍ مفادها أن شدة عقاب المرتكب تعتمد على التاريخ الجنسي للضحية.
أما ما يثير قدراً أكبر من القلق، فهو أن القوانين النافذة في الضفة الغربية وغزة تعفي المغتصب الذي يتزوج ضحيته من الملاحقة الجزائية. وتسمح المادة 308 من قانون العقوبات الأردني للمحكمة بإغلاق القضية أو تعليق الحكم على المغتصب "إذا تم عقد زواج صحيح" بين المغتصب والضحية.[140] ولا يخضع المغتصب للمحاكمة ثانيةً إلا إذا طلّق الضحية "من غير سبب" قبل انقضاء أقل من 5 سنوات.[141] وتنص المادة 291 من قانون العقوبات المصري النافذ في غزة على إعفاءٍ مماثل للمغتصب الذي يوافق على الزواج من الضحية.[142]
وتنكر القوانين النافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضحايا العنف الجنسي الحق في الإجهاض بشكلٍ قانوني من خلال حظر الإجهاض في جميع الأحوال تقريباً.[143] وقد قاد تجريم إجهاض ضحايا العنف الجنسي دون استثناء بعض المراقبين إلى استنتاجٍ مفاده أن "النسوة يصبحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تجهض الجنين بوسائلها الخاصة، وهذا ما يعرض حياتها وسلامتها إلى الخطر؛ أو أن تكمل حملها وتتحمل الأعباء الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الحمل والولادة بشكل 'غير شرعي'".[144]
وثمة فارقٌ كبير بين عدد قضايا الاغتصاب التي تبلغ الشرطة الفلسطينية بها وبين عدد الأحكام الصادرة فيها. وطبقاً لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، لم تدن المحاكم الفلسطينية عام 2004 إلا شخصاً واحداً بجريمة الاغتصاب في غزة، وشخصاً واحداً في الضفة الغربية.[145] وفي عام 2005 لم يكن في السجون إلا 27 شخصاً يمضون أحكاماً تلقوها بسبب الاغتصاب.[146] ولا تتفق هذه الأرقام مع عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى سبيل المثال، سجل مكتب الإحصاء المركزي عام 2003 ما مجموعه 85 حالة اغتصاب ومحاولة اغتصاب (60 في الضفة و25 في غزة)،[147] بينما تمت إدانة شخص واحد فقط بجرم الاغتصاب في ذلك العام.[148]
وأخيراً، فإن قوانين الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تعترف بإمكانية وقوع الاغتصاب ضمن الزواج. لكن المادة 292 من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية تمنح حالات الجنس غير الرضائي ضمن الزواج استثناءً خاصاً من العقوبات الجزائية، ولا تنزل العقوبة إلا بالرجل الذي "واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها".[149] كما أن القوانين النافذة تجرّم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى مجبرةً ضحايا العنف الجنسي على الاحتفاظ بالجنين حتى الولادة.[150]
سفاح القربى
"عندما يتلوث شرف الفتاة يبصق الجميع عليها".
-ريم حمد (اسم مستعار)، إحدى ضحايا السفاح، نابلس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005
يفرض النظام القضائي الفلسطيني قدراً مرهقاً من أعباء الإثبات والإجراءات القانونية على ضحايا السفاح، وهذا ما يغلق الباب عملياً أمام إمكانية تقديم شكوى. فبموجب قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، لا يحق إلا لأفراد الأسرة الذكور رفع دعوة السفاح نيابةً عن القصّر.[151] ولا يحق للأقارب من الإناث ولا لمؤسسات الخدمة الاجتماعية رفع الدعوة نيابةً عنهم. وتقول المادة 286 خاصةً: "يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة".[152] ومعنى هذا هو أن الأقارب من الدرجة الأولى (الأب والجد) والثانية (الإخوة والأعمام) والثالثة (الأخوال) والرابعة (الأصهار) هم المخولون وحدهم بتقديم الشكاوى.[153] ولا توجد أحكامٌ من هذا النوع في قانون العقوبات المصري النافذ في غزة. وتتحدث المحامية حليمة أبو صلب عن غرابة هذا الوضع قائلةً: "من الذي يهاجم النساء؟ إنهم الرجال. لكنهم وحدهم من يحق لهم ملاحقة الأمر قضائياً".[154]
ويؤكد رئيس نيابة الخليل أن قضايا السفاح نادراً ما تصل إلى النيابة. وقد قال لهيومن رايتس ووتش:
عند الاعتداء الجنسي على القصّر تحاول الأسرة تغطية الأمر لأسبابٍ تتعلق بالتقاليد. وخلال الأشهر الخمسة الماضية من عملي في الخليل سمعت أن هناك حوادث كثيرة من هذا النوع لكننا لا نعرف الكثير عنها لأن تغطيتها تتم قبل أن تصل إلى النيابة... فالعائلة والشرطة يتعاونون لتحقيق نوع من المصالحة.[155]
أما بعض ضحايا السفاح اللواتي يكشفن ما أصابهن للآخرين أملاً في المساندة فقد يصبحن عرضةًُ لمزيدٍ من الإساءة والاستغلال. كانت حنان الشريف (اسم مستعار)، 20 عاماً، في السابعة عشرة عندما حاول والدها اغتصابها. وهي تقول: "كانت والدتي تطبخ في الطابق السفلي. ولم يكن أحدٌ يستطيع مساعدتي. حاولت والدتي إيقاف الأمر، لكنه ضربها هي أيضاً، ولم تستطع فعل شيء". لقد اعتدى الوالد على حنان عدة مرات خلال ثلاث سنوات. وتتابع حنان: "عندما كبرت فهمت أنه يستغلني... فقد كنت أظن ذلك نوعاً من الحنان عندما كنت صغيرة". وفي النهاية هربت حنان من منزلها وذهبت للعيش مع شقيقها الأكبر، لكن ذلك لم يكن نهاية ما يصيبها من إساءة.
ذهبت إلى أخي. وقد ساعدني قليلاً، لكنه لم يلبث أن حاول اغتصابي أيضاً. وتكرر الأمر مراتٍ كثيرة. كان يضربني ثم ينام معي. ولم يكن يسمح لي برؤية أحد. كان ينزع ملابسي ويقول: 'أنت لا تساوين شيئاً ولا يستطيع أحدٌ من إخوتك [الآخرين] مساعدتك فأين تذهبين؟ إذا عدت إلى المنزل فسوف يضربك والدك أكثر من قبل لأنك هربت من المنزل دون إذنه'.
أمضت حنان عاماً ونصف عند شقيقها قبل أن تشكو أمرها إلى الشرطة. لكن الشرطي الذي تحدثت معه لم يصدقها أول الأمر. "قالوا: 'مستحيلٌ أن يفعل أبٌ ذلك بابنته'. لم يصدقوني. وحتى العاملة الاجتماعية [في مخفر الشرطة] لم تصدقني أيضاً".[156]
كما وصفت ندى عمر (اسم مستعار)، 30 عاماً، وضعها لهيومن رايتس ووتش:
بدأت مشكلتي مع أسرتي. فقد هاجمني أخي .. هاجمني جنسياً عندما كان عمري 12 سنة... كان في الرابعة والعشرين، وكان يضربني. وكان جميع من في الأسرة يعرف بالأمر. مات والدي عندما كنت صغيرة ولم يعد لدي من يحميني. كان أخي يضرب أمي أيضاً. لم أبلغ الشرطة بالأمر لأنه لم يكن هناك من يحميني. لم أستطع إخبار الشرطة. ولم يكن مسموحاً لي حتى بمغادرة المنزل. التقيت شاباً عام 2002، وأحببته. وقد عقدت خطوبتنا. وأخبرته أن أخي كان يهاجمني، فلم أكن أستطع إخفاء الأمر عنه. قال لي: 'لا توجد مشكلة، سأعتبرك كأنك مطلقة'. لكنه بدأ يعاملني معاملةً سيئة أثناء الخطبة. وقال لي أنني إذا رفضت النوم معه فسوف يخبر أسرتي أنني لم أنم مع أخي بل مع أشخاصٍ آخرين. وبعد ذلك مارسنا الجنس وحبلت منه.[157]
قتل النساء بما يسمى "الشرف"
"توفيت أنثى تبلغ 18 عاماً نتيجةً خنقها باليد من قبل أفراد أسرتها. وادعى الذين قتلوها أنها انتحرت بتناول سائل سام (جلبوا إلى المشرحة مع الجثة زجاجة تحوي مبيداً حشرياً من الفوسفور العضوي)".
-مقتطف من تقرير التشريح في ما يسمى "جريمة شرف" أعد في معهد الطب الشرعي بجامعة القدس.[158]
يمثل قتل القريبات من الإناث تحت اسم "شرف" العائلة خطراً مادياً كبيراً على النساء الفلسطينيات في الضفة وغزة. وتصبح حياة الفلسطينية معرضةً للخطر إذا ما شك أحدٌ في قيامها بسلوك تعتبره عائلتها أو المجتمع محرما، مثل التحدث مع شخصٍ ليس زوجاً أو قريباً لها (حتى في مكانٍ عام)، أو رفض إخبار أحد الأقارب الذكور أين كانت ومع من، أو الزواج من أحدٍ ما دون موافقة العائلة. وباختصار، فإن الخطر يحدق بها إذا فعلت (أو إذا اشتُبه بأنها فعلت) ما يعتبر مسيئاً لشرفها وشرف عائلتها.
إن هذه الجرائم هي من أكثر العواقب والمظاهر المأساوية للتمييز بين الجنسين الذي يضرب جذوره عميقاً في المجتمع. وفي ظل انعدام وجود أرقام ملموسة عن هذه الجرائم نظراً لعدم وجود جهة حكومية تتولى جمع هذه المعلومات، فإن جماعات حقوق المرأة الفلسطينية تقول أنها كثيراً ما تصادف حالاتٍ لنساء وفتيات تعرضن لتهديد أفراد الأسرة، وبعض هؤلاء يتعرضن للقتل على يد أفراد الأسرة فيما بعد. ويدعي الناشطون المحليون أنه لا يجري الإبلاغ عن معظم حالات القتل هذه، وأن من الصعب جداً قياس الحجم الكامل لهذه المشكلة.[159] وتصف بعض ناشطات حقوق المرأة الفلسطينيات هذه الجرائم بأنها جرائم "قتل النساء" لا "جرائم شرف"، وذلك تعبيراً عن مدى خطورة الإساءات واستمرار العنف الذي يستهدف حياة النساء وسعياً لنفي الصلة بين هذه الجرائم وبين أي مفهومٍ صحيح للشرف.[160]
وفي بعض الأحوال، تقتل النساء في ما يسمى "جرائم الشرف" لا لأنهن تجاوزن القواعد الأخلاقية طوعاً، بل لأنهن وقعن ضحية العنف الجنسي الذي يعتبر "عاراً" على العائلة بحد ذاته.[161] ويكون بعض مرتكبي هذه الجرائم مغتصبين يقتلون ضحيتهم للحيلولة دون انكشاف أمرهم، وخاصة إذا حملت الضحية. وفي حالاتٍ أخرى، يقتل أفراد الأسرة المرأة أو الفتاة التي كانت ضحية العنف الجنسي بدلاً من السعي خلف الإنصاف القضائي لمحاسبة المعتدي.
ويصعب وجود استجابةٍ فعالةٍ في هذه الحالات لأن إعلان الأمر على الملأ يمكن أن يدفع الأسرة إلى قتل الفتاة أو المرأة. وقد قالت لنا إحدى ناشطات حقوق المرأة: "إن الضغط الاجتماعي هو ما يجعل الأسرة تقتل [ابنتها]. ويمكن لإبقاء القضية ضمن إطار الأسرة الصغيرة أن ينقذ حياة المرأة".[162] وفي إحدى الحالات، حملت فتاة من رام الله تبلغ 16 عاماً بعد اغتصابها مراراً من قبل شقيقيها.[163] ويعتقد أن حملها وحبس شقيقيها بتهمة السفاح قد ألحق العار بالعائلة إلى درجةٍ حملت المحافظ على مطالبة العائلة بوعدٍ بعدم إيذائها.[164] لكن والدة الفتاة قتلتها في نهاية المطاف.
وفي هذه الحالة، عُلم أن الشرطة كانت على معرفةٍ مسبقة بأن الفتاة في خطر، لكنها لم تستطع الوصول إلى المكان في الوقت المناسب. وتقول منظمة العفو الدولية والتقارير الصحفية أن الجنود الإسرائيليين استوقفوا الشرطة الفلسطينية عدة ساعات عند حاجز عسكري إسرائيلي يفصل بين رام الله وقرية أبو قاش التي تقطنها الأسرة.[165] ويقول العاملون في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منزل القتيلة في الوقت المناسب لكي يحاولوا إنقاذ حياتها بسبب القيود على الحركة بين القدس والضفة الغربية.[166] وقالت لنا مها أبو دية شماس من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:
كانت المنطقة تحت حظر التجول، وكما نعلم جميعاً كان الإسرائيليون يفرضون حظر التجول أثناء الانتفاضة عن طريق إطلاق النار بقصد القتل على كل من يتحرك. وعند تلك المرحلة من الانتفاضة كانت الشرطة قد توقفت عن العمل بزيّها الرسمي خوفاً من استهداف الجيش الإسرائيلي لها. ومازالت الشرطة تمارس مهامها بأقصى ما تستطيع، ومازالت لديها سلطة أخلاقية تمكنها من أداء مهمتها في إنفاذ القانون. لكن عليهم التحرك بملابس مدنية. وفي تلك الحادثة حاولت الشرطة دخول القرية بالملابس المدنية فقد كان هناك حظرٌ للتجول، لكن الإسرائيليين أطلقوا النار عليهم.[167]
تسهل بعض القوانين في الضفة والقطاع ارتكاب ما يسمى "جرائم الشرف". ويمنح بعضها أحكاماً مخففة وإعفاءاً من العقوبة للرجال الذين يهاجمون قريباتهن المتهمات بالزنا[168]، أو يسمح للقاضي بتخفيض عقوبة المرتكب إلى النصف إذا أسقطت أسرة الضحية حقها.
وتنص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني (16/1960) النافذ في الضفة الغربية على إعفاء الرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى قريباته عند ارتكابها الزنا من العقوبة. ويمكن تخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل المرأة التي يضبطها في "فراش غير شرعي".[169] وتقضي المادة 98 من القانون عينه بتخفيف عقوبة الفاعل (من الجنسين) الذي يرتكب جريمته في "ثورة غضب" نشأت بسبب فعل خطير أو غير مشروع من جانب الضحية.[170] ولا تشترط المادة ضبط المرأة متلبسةً، كما لا تشترط دليلاً ثابتاًً على خروجها عن الآداب. وفي غزة، ينص قانون العقوبات المصري أيضاً على تخفيف عقوبة قتل المرأة على يد زوجها في حالة الزنا. وهو يصنف قتل الزوجة (وليس الزوج) في حالة الزنا ضمن خانة الظروف المخففة مما يخفض عقوبة جريمة القتل إلى مجرد جنحة.[171]
لقد شرح لنا أحد النواب العامين أن القانون يسمح للقضاة الفلسطينيين بتخفيض عقوبة الرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى قريباته إذا ضبطها في "فراش غير مشروع" بمقدار يتراوح بين الثلث والثلثين.[172] وهو يقول: "يمكن للقاضي طبعاً أن يأمر بالعقوبة كاملةً إذا أراد. فالأمر عائدٌ لتقديره".[173] لكن النيابة العامة الفلسطينية تقول أن أفراد الأسرة وبعض أفراد المجتمع المحلي يقومون بتخويف القضاة أحياناً للحصول إلى أحكام مخففة في قضايا لا تستفيد من الأعذار المخففة بغير ذلك. وفي هذه الحالات، كما يقول أحد قضاة النيابة:
تأتي العائلة والعشيرة والمجتمع معاً للادعاء بأن المسألة "جريمة شرف" وأن المتهم يجب أن ينال حكماً مخففاً، وأن هناك أعذاراً مخففة. وفي النهاية، ينحني القضاة أمام الضغط، وقد يفرجون عن المشتبه فيه بكفالةٍ قبل المحاكمة، أو قد يجدون مادةً في قانون العقوبات يمكن تطبيقها لمنحه حكماً مخففاً... وفي بعض الأحيان تقوم العائلات بجمع التواقيع من القرية كلها ومن بعض الشخصيات البارزة للقول بأن القرية لا تريد تقديم اتهامات بحق مرتكب الجريمة وأنها لا تعارض تلقيه العقوبة الدنيا.[174]
ويقول قاضٍ لم يشأ الكشف عن اسمه أنه في بعض الحالات "إذا ارتكبت الجريمة في سورة غضب، يخلى سبيل المتهم فوراً". ويضيف: "وفي ذلك تشجيعٌ للجريمة". وهذا ما دفع إحدى المراقبات للقول أن "قتل النساء يلقى التسامح إن لم يلق التشجيع أيضاً من جانب النظام القانوني القائم".[175]
وكما هي الحال في معظم القضايا الجزائية، فإن للقاضي صلاحية تخفيض الحكم إلى النصف إذا "أسقطت" أسرة الضحية حقها في الادعاء بجرم القتل.[176] وفي ما يسمى "جرائم الشرف" تسقط الأسرة حقها بالادعاء في جميع الأحوال تقريباً لأنها تكون متواطئةً في الجريمة. وهكذا يمكن أن ينال مرتكبو هذه الجرائم أحكاماً لا تتجاوز ستة أشهر. وإذا كان القاتل قد أمضى تلك الفترة في السجن منتظراً صدور الحكم، فقد يخفف القاضي الحكم بحيث يطابق المدة الفعلية التي أمضاها القاتل في السجن. وفي دراستها لهذه القضايا، وجدت د. ناذرة شلهوب كيفوركيان أن:
الأدلة المبنية على الشائعات وتناقل الكلام لعبت دوراً رئيسياً في قرار المحكمة في معظم قضايا قتل المرأة الست هذه. وتبرر القيم الثقافية والتقليدية هذه الأساليب، فهي قيمٌ ترتبط بطهارة المرأة وعفتها وتعتبر أن ما يشاع عن سلوكها يسيء إلى الشرف كما لو كانت قد سلكت ذلك المسلك فعلاً، وهي لا تأخذ الظروف بعين الاعتبار (كأن تكون الضحية حبلى بسبب اغتصابها، أو أن يكون دافع هرب المرأة من البيت هو محاولة الخلاص من أبٍ أو زوجٍ يسيء إليها).[177]
وفي مايو/أيار 2005، سارت في الساحة الرئيسية برام الله مظاهرةٌ ضمت نحو 300 امرأة فلسطينية ودعت إلى تعديلاتٍ تشريعية تحمي النساء من ما يسمى "جرائم الشرف" بعد أن شهد أسبوعٌ واحد قتل ثلاث نساء.[178] وتقول مقالة صحفية أن رجلاً قتل شقيقتيه في القدس الشرقية في مثالٍ واضح على ما يسمى "جرائم الشرف"، كما أن أباً مسيحياً في رام الله اعترف بقتل ابنته البالغة 23 عاماً لأنها أرادت أن تتزوج مسلماً من غير موافقته.[179] وقد دعت المتظاهرات إلى اعتماد تشريع يحمي النساء من القتل.[180]
وسرعان ما أصبحت الضحية البالغة 23 عاماً، وهي فاتن حبش، رمزاً لفشل السلطة الفلسطينية في حماية النساء من القتل. فقد أكدت قضيتها على أن جميع النساء والفتيات الفلسطينيات معرضات للخطر بصرف النظر عن دينهن. وتقول الأنباء الصحفية[181] أن فاتن، وبعد أن رفض والدها الموافقة على زواجها، حاولت مرتين الفرار مع من تحبه إلى الأردن. لكن كاهن العائلة الأب إبراهيم حجازين اتصل بالأمن الفلسطيني الذي منع فاتن من عبور الحدود وأعادها إلى بيتها. ولم تزودها الشرطة بأية حمايةٍ عند عودتها إلى المنزل. وبعد عودتها بفترةٍ وجيزة، أقدم عمها على ضربها. وقد كُسر حوضها إما لأنها رُميت من النافذة أو لأنها قفزت منها محاولةً الهرب. وقد منعت الشرطة المنظمات النسائية من زيارتها في المستشفى. وأثناء علاج فاتن في المستشفى التمس خطيبها المساعدة من عشيرة الدواهيك البدوية التي وافقت على التوسط بينها وبين والدها بالتعاون مع محافظ رام الله. ثم عادت فاتن إلى بيتها عقب خروجها من المستشفى بعد أن وعد والدها العشيرة البدوية بعدم إيذائها. لكنه، وبعد أسبوعٍ من ذلك ضربها بقضيبٍ حديدي حتى ماتت. ومع أن السلطات الفلسطينية اعتقلته بعد ذلك، فقد أطلق سراحه بكفالة ولم يصدر حكم بحقه حتى بعد مرور سنة على الجريمة. لكن أحداً من المسئولين أو من زعماء العشيرة البدوية ممن توسطوا لعودتها إلى البيت لم يخضع لأي تحقيق أو لوم بسبب الامتناع عن حمايتها.
وثمة حالات قتل نساء فلسطينيات على أيدي أشخاص من خارج الأسرة بسبب الادعاء "بسلوكهن غير الأخلاقي". ففي أبريل/نيسان 2005 قام خمسة مسلحين يقال أنهم من حماس بقتل يسرى عزامي البالغة 20 عاماً عندما كانت في نزهةٍ مع خطيبها.[182] وبعد الجريمة، وزعت حماس منشوراتٍ في بلدة بيت لاهيا تعتبر فيها أن القتل كان من قبيل الخطأ وتعد بمعاقبة القتلة.[183] لكن إدانة حماس لفعل قتل المرأة توقفت عند اعتباره خطيئةً، ولم تعتبر أن قتل أحد لمجرد الادعاء بلا أخلاقية سلوكه ليس إلا جريمةً. وقال متحدثٌ باسم حماس للصحفيين: "كان الإخوة الذين فعلوا ذلك مخطئين، فقد كان هناك شكٌّ في وجود سلوك غير أخلاقي".[184]
قصور الرد المؤسساتي على العنف ضد النساء والفتيات
"أعتقد أن اهتمام المجتمع والمؤسسات بالعنف ضد المرأة يتزايد شيئاً فشيئاً، ويحاول بعض الوزراء أن يكونوا متعاونين... لكننا نفتقر إلى الأنظمة التي تسمح بتطبيق تدابير الحماية الأساسية الموجودة في القانون".
-سعاد أبو دية، رئيسة الوحدة الاجتماعية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005
فشلت السلطة الفلسطينية في إيجاد إطار مؤسساتي فاعل لمنع العنف ضد النساء والفتيات ولمعاقبة مرتكبي الإساءات عند حدوثها وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن أفعال العنف وحمايتهن من التعرض له مجدداً. كما وتفتقر الشرطة الفلسطينية إلى الخبرة (وإلى الإرادة أيضاً كما هو واضح) في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بطريقةٍ فعالةٍ تتحسس حاجات الضحايا وتحترم خصوصيتهن. كما أن غياب إرشادات طبية مخصصة للأطباء يؤثر تأثيراً خطيراً على جودة المعالجة المقدمة لضحايا العنف من الإناث.
أما القلة من النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يقررن إبلاغ السلطات بما يتعرضن له من إساءة فيجدن أنفسهن أمام عقباتٍ مؤسساتيةٍ جدية تضع سمعة العائلة في المجتمع في المقام الأول على حساب صحة الضحايا وأرواحهن. وقد علمت هيومن رايتس ووتش أن أحد أهداف نظام العدالة الجزائية الفلسطينية فيما يخص قضايا العنف الأسري هو تفادي "الفضيحة العامة" مهما يكن الثمن. ورغم حقيقة أن الدعاية غير المرغوبة يمكن أن تزيد من الشعور بالعار لدى الأسرة، مما يمكن أن يدفعها إلى مزيدٍ من العنف، فإن الرد المناسب هو تمكين الضحية من تقديم الاتهام مع احترام الطبيعة السرية للقضية. وبدلاً من ذلك، غالباً ما يقوم رجال الشرطة "بالتوسط" و"حل" هذه القضايا في مخافر الشرطة، وهم يقترحون تزويج الضحية كحلٍّ لحالات الاغتصاب. والمعتقد الشائع الذي يدعم هذا السلوك هو أنه لا "أذى" ولا "عار" في الاغتصاب إذا ما عمل المغتصب على استعادة "شرف" ضحيته وأسرتها من خلال زواجه بها. أما عدد حالات الاغتصاب والسفاح التي "تحلها" الشرطة كل عام في الأراضي الفلسطينية المحتلة فهو غير معروف. وقد أخبرتنا إحدى ناشطات حقوق المرأة أن الشرطة لا تسجل هذه الحالات ولا تبلغ المحاكم بها.[185]
وضحايا العنف الجنسي خاصةً هن من يدفعن باستمرار ثمن الإساءة التي يتعرضن لها. وفي تشويهٍ كاملٍ للعدالة، يمكن أن تجبر المرأة التي تبلغ أسرتها أو السلطات بما تعرضت له من إساءةٍ، على الزواج من مغتصبها أو من أي غريب "لإزالة" الضرر قبل انكشاف الأمر على الملأ. وتقول إحدى المراقبات أن هذه الزيجات القسرية "تعفي المجتمع من مسؤولية التعامل مع هذه الجرائم".[186] وعلى جميع المستويات الحكومية الفلسطينية، حتى عندما تكون الدولة في موقع الوصي على القاصر كما هي الحال في بيت الفتيات ببيت لحم (يرد الحديث عنه أدناه)، يُطرح الزواج كحلٍّ لمشكلة الاغتصاب.[187]
إن من يقدمون الخدمات الاجتماعية من خلال العمل في المنظمات غير الحكومية يتعرضون لخطر العنف أيضاً. وتقول كثير من الأخصائيات الاجتماعيات في هذه المنظمات (ممن فضلن عدم الكشف عن هوياتهن) أن أفراد أسر زبائنهن يقومون أحياناً بتهديدهن وتخويفهن، بل ويمارسون العنف ضدهن أيضاً. وتتحمل الأخصائيات الاجتماعيات مخاطرةً شخصيةً كبيرة عندما يساعدن النساء والفتيات على الهرب من الأسر التي تسيء إليهن وعندما يواجهن مرتكبي هذه الإساءات. وقد تحدث مع هيومن رايتس ووتش عددٌ من ناشطات حقوق المرأة عن فشل السلطة الفلسطينية لا في حماية ضحايا العنف فقط، بل في حماية الناشطات أنفسهن بوصفهن من مقدمي الخدمات الاجتماعية. وتقول إحدى العاملات الاجتماعيات: "لا يوجد قانونٌ يحمي ضحايا العنف من النساء أو يحمينا بوصفنا عاملات اجتماعيات. إنهم [مرتكبو العنف] يهددوننا ويخوفوننا دون أن يحمينا القانون منهم".[188]
وتصف عاملةٌ اجتماعيةٍ أخرى كيف حاولت أسرة إحدى الضحايا (وهي من ضحايا العنف الأسري) تخويفها لمنع تدخلها: "لقد اتصلوا بي [أسرة الضحية] وأتوا إلى منزلي. وقالوا أنهم سيشعلون النار في المنزل، وأنهم سيختطفونني مع أطفالي... شعرت بالخوف كثيراً. لقد دعوا أنفسهم باسم سرايا القتل". وعندما قامت بإبلاغ الشرطة بهذه التهديدات، وضعت الشرطة هاتفها المحمول تحت المراقبة لكنها لم تكد تفعل شيئاً غير ذلك. "تصرفت الشرطة ببرود. كانوا يلعبون بمشاعري. وقالوا: 'أنت عاملةٌ اجتماعية ولك الحق بأن تخافي'. لم أشعر أنهم يحمونني".[189]
دور الشرطة
"يتعاون بعض رجال الشرطة معنا حقيقةً. لكن المشكلة هي أننا لا نعمل مع الشرطة كلها، فهؤلاء مجرد أفراد. وليس لدينا أشخاصٌ متخصصون بالتعامل مع ضحايا العنف [المستند إلى النوع الاجتماعي] ولا وحدات خاصة بذلك. ويمكن أن يعرف الجميع [بالقضية]، فليس هناك مجالٌ [محدد] يجري الحفاظ على السرية ضمنه".
-سعاد أبو دية، رئيسة الوحدة الاجتماعية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005
أثبتت الشرطة الفلسطينية عدم قدرتها، أو عدم استعدادها للتعامل الفاعل مع قضايا العنف ضد المرأة. ومع أن وزارة الداخلية وضعت تعليمات أساسية تضمن وجود شرطية أثناء قيام الضحية بإبلاغ الشرطة عن العنف الذي تعرضت له، فإن ثمة غياباً كاملاً للخبرة التخصصية التي تضمن التعامل الصائب مع شكاوى العنف الأسري. ونتيجةً لذلك غالباً ما تلجأ الشرطة إلى التوسط بين الطرفين (وذلك بالتعاون أحياناً مع نظام العدالة غير الرسمي ومع المخاتير وزعماء العشائر النافذين) من أجل "حل" المشكلة. وفي حالاتٍ كثيرة تقوم الشرطة بإعادة المرأة إلى أسرتها حتى عند وجود خطر حقيقي من تعرضها إلى مزيدٍ من العنف.[190] وليس من الواضح مقدار ما تملكه المرأة من سلطة اتخاذ القرار في هذه العملية، إن كان لها أن تقرر شيئاً.
إن تحيز الشرطة ضد ضحايا العنف المستند إلى النوع الاجتماعي، وكذلك افتقارهم لخبرة التعامل مع هذه الحالات، يدفع بكثيرٍ من الأخصائيات الاجتماعيات إلى مرافقة الضحايا إلى مخفر الشرطة للتأكد من تحرير المحضر بصورة سليمة. وقد قالت لنا سعاد أبو دية من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي: "إنهم غير مدربين [على التعامل مع العنف ضد المرأة]. وليست لديهم تعليمات بهذا الخصوص. وهكذا فهم يميلون إلى الطريقة العشائرية [التنسيق مع زعماء العشائر] فليس لهم ما يلجئون إليه غيرهم. وهذا ما سوف يفعلونه إذا لم نكن حاضرين".[191]
وقد أكد كثيرٌ من مقدمي الخدمة الاجتماعية الذين قابلناهم أنه من المعروف عن الشرطة عدم احترام خصوصية المرأة أو الفتاة. وقالت إحدى العاملات الاجتماعيات لنا: "نعرف أن الفضيحة واقعة لا محال عندما نذهب إلى الشرطة. ثمة أزمة ثقة مع الشرطة. لا توجد سريةٌ في مخافر الشرطة، فسوف يستمع 15 شخصاً لما يجري".[192] وتقول عاملةٌ اجتماعيةٌ أخرى أن امرأة عمرها 35 عاماً حملت من غير زواج فأجبرت على الهرب إلى الأردن بعد أن تحدث رجل شرطة عن حالتها على الملأ. "عندما ذهبت المرأة إلى مستشفى الرفيدي [في نابلس] محاولةً الحصول على الإجهاض، شعر الأطباء بالخوف واتصلوا بالشرطة. لكن شرطياً كان موجوداً هناك لحمايتها أخبر كل من في البلدة [عن حالتها]".[193] وقد عاشت امرأةٌ أخرى، هي مريم إسماعيل (اسم مستعار)، حالة واضحة من انعدام السرية. وهي تقول:
لم أشأ أبداً أن أذهب إلى الشرطة لأنني لم أكن أرغب بأن تعرف عائلتي بالإساءة الجنسية التي تعرضت لها. وكان أملي أن تحتفظ الشرطة بسرية الأمر بعد الاستجواب. لكن القصة انتشرت في اليوم التالي وعرف الجميع أن زوجي كان يجبرني على النوم مع رجالٍ آخرين.[194]
وبعد يومٍ واحد من ذهاب مريم إلى الشرطة نشرت الصحف أخبار قضيتها بطريقةٍ كشفت عن هويتها.
ويقر قائد شرطة الضفة الغربية وغزة أن السرية تمثل مشكلةً: "يصعب ضبط الوضع ضمن الظروف الراهنة، ويصعب الحفاظ على سرية القضايا".[195] لكن السلطات لم تعاقب إلا عدداً قليلاً من عناصر الشرطة بسبب كشفهم عن معلومات سرية. ولم يسمع مدير كلية الشرطة في أريحا إلا عن ستة أو سبعة عناصر شرطة جرى اتخاذ تدابير تأديبية بحقهم خلال السنوات التسع الماضية بسبب إفشائهم معلومات سرية تتعلق بإحدى القضايا، إضافةً إلى طرد شرطي واحد.[196]
كما أشار المحامون والعاملون الاجتماعيون إلى أن زعماء العشائر النافذين وأفراد النخبة السياسية وأصحاب الرتب العالية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية هم "فوق القانون"، وهم قادرون على إغلاق محاضر الشرطة التي تشير إلى تورطهم في سلوكٍ غير قانوني. وقال لنا أحد المحامين: "عندما يرتكب أحدا أفراد عائلة قوية جريمةً ما، يفكر أفراد الشرطة مائة مرة في ما قد يصيبهم قبل أن يشرعوا بمتابعة القضية".[197] وقالت لنا عاملةٌ اجتماعية أنها لم تجد ما تفعله إزاء قضيةٍ كان فيها أحد الرجال النافذين يغتصب ابنته (وهي طالبة جامعية) إلا أن تطلب من جدتها أن تنام معها في نفس الغرفة لمنع الأب صاحب العلاقات السياسية القوية من مواصلة الإساءة إلى الفتاة.[198]
لكن ضباط الشرطة، ومن بينهم ضباط كبار في الشرطة المدنية، يقللون من أهمية العنف ضد النساء. وقد قال لنا مدير كلية الشركة في أريحا:
القانون والعدالة أهم من العنف ضد النساء. وإذا كان هناك مريض مصاب بالسرطان ولديه ثؤلول أيضاً، فلن تهتم بالثؤلول إذ أن هناك ما هو أهم منه... وعندما نعالج المشكلة الكبيرة ونحلها يمكننا التحول إلى معالجة المشاكل الأبسط والأسهل.[199]
كما شكك أيضاً في الحاجة إلى قيام الشرطة بنشر معلومات لمساعدة ضحايا العنف على الإبلاغ عن الإساءات التي تصيبهن: "لا نستطيع أن نمارس الدعاية. فهذا صعبٌ علينا. وسوف يجعلنا ذلك نبدو وكأننا نشجع المرأة على الذهاب إلى الشرطة. أما القول بأن العنف ضد المرأة جريمة فهو دور وزارة الشئون الاجتماعية والمنظمات النسائية".[200]
ولم يكن ضباط الشرطة أقل حماسةً في التماس الأعذار لمحاولتهم التوسط وتشجيعهم على حل الأمر بالزواج في حالات الاغتصاب. ويقول علاء حسني، قائد شرطة الضفة الغربية وغزة:
يجري حل معظم القضايا بطريقةٍ تكون في صالح الشخص وبشكلٍ يحمي الفتاة. أستطيع أن أحصل لها عن حقها، لكنني لا أريد قتلها من أجل حمايتها. إن ذهابها إلى المحكمة يقتلها اجتماعياً. [وبدلاً من ذلك] فإننا نستطيع اتخاذ إجراء تأديبي ضد الرجل، ونستطيع تطويق المشكلة من خلال العائلة.... إذا أصرت على الذهاب إلى المحكمة فنحن نرسلها إليها، وأما إذا أرادت إنهاء القضية في المخفر فسوف نفعل ذلك... وإذا أرادت الفتاة فبإمكاننا الضغط عليه وعلى عائلته حتى يتزوجها مع تقديم ضمانات بعدم طلاقها. هدفنا هو ضمان مصلحة المرأة بحيث تخرج من مخفر الشرطة حاملةً أقل قدر ممكن من المشاكل.[201]
ويكرر وجهة النظر نفسها قائد شرطة رام الله تيسير منصور (أبو العز):
إذا اكتشفنا أن رجلاً يقيم علاقةً مع امرأة، فإن معظم الحالات تنتهي بزواجهما. إننا نحاول تحجيم المشكلة... فالاغتصاب أمرٌ يحدث. والمهم في الأمر هو أنه حدث فعلاً؛ وهذه هي الفتاة ضمن المجتمع، فمن سيتزوجها؟ ومن أجل صون سمعتها وسمعة أسرتها يقولون لنا [الأسرتان] أنهم موافقون على المصالحة... إن تأمين مستقبل المرأة أفضل لها من أن تكون ضحية. فلنفترض أن فتاة اغتصبت وأننا حبسنا الرجل عشر سنوات. يمكن أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة في مدينةٍ مثل القاهرة حيث لا يعرف أحدٌ الفتاة. أما هنا فهي لا تستطيع الهرب. وماذا لو لم تكن عذراء؟ إنها لا تستطيع التهرب من الأمر ليلة زفافها.[202]
كما كشفت المقابلات التي أجريت مع ضباط الشرطة الفلسطينيين عن ميلٍ إلى اعتبار العنف الجنسي الجاري ضمن الأسرة أمراً يتم بالرضى. فقد قال لنا قائد شرطة رام الله:
الأمر ليس اغتصاباً. إنه الكبت والشعور بالاختناق والجهل. وهذا ناتجٌ عن الاحتلال. لست ألقي بلائمة الأمر كله على الاحتلال، لكنه يلعب دوراً في هذا. يذهب الأب إلى العمل في إسرائيل، وهي مجتمع مفتوح. وهو يشاهد فيها أفلاماً إباحية، أما زوجته في القرية فهي غير معتادةٍ على ذلك. وقد يذهب إلى العمل ويترك الفيلم في المنزل فيشاهده الإخوة والأخوات وأبناء العم ويتأثرون به. ومن الطبيعي أن الأمر يكون بالرضى بعد مشاهدة الأفلام. فهل هناك أخٌ يرغب بالنوم مع أخته؟[203]
ويكرر مدير سجن نابلس، توفيق منصور (أبو محمد) نفس الآراء. وقد تحدث إلينا عن إحدى النزيلات، وهي امرأةٌ في الثلاثين نقلت إلى السجن قبل يومٍ واحد من لقاءنا معه. وقد حملت المرأة بعد أن ورّطها والدها فيما يعتبره توفيق منصور علاقةً جنسيةً رضائية. وهو يقول: "إذا كان قد اغتصبها فلماذا لم تبلغ الشرطة بالأمر؟ وإذا اغتصب شخصٌ أحد أفراد أسرته فإن المجتمع يقتله وينتهي الأمر". وتحدث أيضاً عن حالةٍ أخرى يعتقد أنها ليست اغتصاباً: "لدي قضيةٌ تتعلق بامرأةٍ قتلت زوجها لادعائها باعتدائه على ابنتهما. لكنني رأيتهما. إن الفتاة تبدو أقوى منه".[204]
وقد وصفت لنا كثيرٌ من النساء حالات المعاملة المهينة التي لقينها في مخافر الشرطة. وعندما تحدثنا مع ريم حمد (اسم مستعار) كان قد مضى عليها خمسة أشهر في نابلس ضمن الملجأ الوحيد للنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[205] وقالت لنا أن والدها كان يضربها، وأنه حاول اغتصابها عدة مرات. وبعد واحدٍ من هذه المحاولات ذهبت إلى الشرطة في نابلس طلباً للمساعدة. وتقول أن رجال الشرطة سخروا منها بسبب سمرتها الشديدة: "عندما ذهبت إلى الشرطة قال لي واحدٌ منهم: 'هل ترين نفسك جميلةً جداً حتى يفعل والدك ذلك بك؟'".[206]
يعمل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي منذ أوائل عام 2005 على توفير التدريب التخصصي للشرطة بما في ذلك دورتين تدريبيتين لمدة 80 ساعة حول كيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري. كما ساعد المركز على تدريب العاملين في الشرطة على التعاون مع الملجأ الجديد المقام في مدينةٍ (لم يحدد اسمها) في الضفة الغربية، وهو يقول أن هذا التعاون يسير على نحوٍ طيّب وهو أمرٌ أساسي لنجاح الملجأ. لكن المركز يشعر بالإحباط لتأخر تنفيذ توصيات المنظمات غير الحكومية لعام 2005 والتي حظيت بدعم مجموعة من ضباط الشرطة المتدربين لدى المركز، ثم تبنتها وزارة الداخلية الفلسطينية، وهي تقضي بإقامة وحدة متخصصة في كل مخفر شرطة للتعامل مع شكاوى العنف الأسري.[207]
دور الأخصائيين الصحيين
عادةً ما يكون نظام الرعاية الصحية أول مؤسسة حكومية تحتك بها ضحايا العنف من النساء، بل هو المؤسسة الوحيدة أحياناً. والمؤسف أن هذا النظام غير مجهزٍ جيداً للتعامل مع هذه الحالات بالمستوى المطلوب من التخصص والحساسية. وتشير نتائج الدراسات إلى الانتشار الواسع للمعلومات الخاطئة والمواقف المتحاملة تجاه ضحايا العنف من النساء في أوساط الأطباء الفلسطينيين. ويؤدي اجتماع الموقف المتحيز مع غياب التعليمات والإرشادات الطبية والافتقار إلى التدريب الكافي حول كيفية معالجة ضحايا العنف إلى عدم حصول الضحايا على العون الكافي من قطاع الرعاية الصحية.
غياب الإرشادات الطبية، وخرق السرية
لا توجد تعليمات أو أنظمة وزارية بشأن التعامل مع قضايا العنف الأسري. ويفتقر معظم الأطباء إلى التدريب المتخصص على معالجة ضحايا العنف وأهمية الحفاظ على السرية. وتفتقر السلطة الفلسطينية إلى وجود نظام أو قانون للأخلاق الطبية يحكم سلوك الأطباء.
وتعرف أهيلة شومر، مديرة مؤسسة "سوا" المقدسية المناهضة للعنف الجنسي، كيف يسيء غياب هذه القوانين والأنظمة الطبية إلى جودة الرعاية الصحية المقدمة لضحايا العنف الأسري من النساء: "لا يعرف الناس [الأطباء والممرضات] في غرف الإسعاف كيف يتعاملون مع الضحايا. لذلك فهم يعطونهم حبوباً مهدئة للأعصاب ويرسلونهم إلى البيت. وبعض النساء يتعرضن للأذى ثانيةً في المستشفى".[208]
أما مركز بيسان للبحوث والتنمية، وهو منظمة لبناء القدرات مقرها في رام الله، فقد عقد أربع ورشات عمل للعاملين في قطاع الرعاية الصحية تتناول كيفية التعامل مع حالات العنف ضد النساء. ومن خلال هذا المشروع، درب المركز 20 طبيباً من نابلس ورام الله وبيت لحم، إضافةً إلى 44 طبيباً من غزة. وتقول خبيرة المشروع رحمة منصور أن هؤلاء المتدربين من العاملين الصحيين لم يصدقوا مستوى العنف الموجود ضد النساء.[209] كما لم يكونوا يعرفون كيف يميزون ضحايا العنف الأسري عن غيرهن وكيف يتعاملون مع حالاتهن. وقد قالت لنا: "عندما بدأنا الحديث عن ذلك كان من الواضح أنهم لا يملكون المهارات والمعارف المتعلقة بالتعامل مع الضحايا. وكان لابد من تدريبهم على فكرة أنه يمكن تعرض الضحية للعنف حتى مع عدم وجود علامات مادية تدل عليه".[210]
وكان من نتيجة ورشات العمل هذه أن أصدر مركز بيسان في عام 2003 تقريراً بعنوان "تعامل الأطباء الفلسطينيين مع حالات الإساءة إلى الزوجات".[211] ولتنفيذ هذه الدراسة، أجرى الباحثون مقابلات ووزعوا استبياناً على 396 طبيباً فلسطينياً في فترة سبتمبر/أيلول 2001 – أبريل/نيسان 2002.[212] وكانت النتائج مفاجئةً تماماً. فقد وافق قرابة نصف الأطباء (44%) على عبارةٍ تقول: "إن نسبة النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى الإساءة على يد أزواجهن منخفضةٌ جداً".[213] واعتبر حوالي 63% من الأطباء أن إساءة المعاملة على نحوٍ عنيفٍ ومستمر هي وحدها ما يعتبر عنفاً منزلياً؛ بينما صاغ 47% من الأطباء "إجاباتهم بطريقةٍ يمكن اعتبار أنها تلقي بلائمة سلوك الزوج العنيف على المرأة ضمناً أو بشكلٍ واضح...".[214] وقد أظهر الأطباء قدراً كبيراً من التفهم تجاه مرتكبي العنف وقدراً قليلاً من التعاطف مع الضحايا: فقد وجد 38% أنه "إذا فهمت المرأة ظروف زوجها فمن المرجح أنه لن يسيء إليها"؛ ورأى 29% منهم أن "الزوجات يتعرضن للإساءة بسبب طريقتهن غير الطبيعة في التعامل مع أزواجهن"؛ بينما كان رأي 16% أن "معظم الزوجات اللواتي يتعرضن للإساءة تستحققن المعاملة العنيفة من جانب أزواجهن"؛ ورأى 10% أن "معظم الزوجات المساء إليهن يشعرن بالراحة بعد أن يضربهن الزوج".[215]
ومعظم الأطباء لا يسجلون ما يأتيهم من حالات العنف ضد النساء والفتيات. وقد قال مدير مستشفى رام الله العام لهيومن رايتس ووتش:
نستقبل حالتين أو ثلاث حالات كل يوم، ومن بينها حوادث السير وإصابات العمل. ولدينا أقل من 10 حالات عنف منزلي سنوياً. ليست لدي إحصائيات متخصصة. ونحن لا نصنف هذه الحالات، ولا نكتب في التقرير إلا أن المرأة تعرضت للضرب على يد أشخاص آخرين... أما إذا تحدثنا عن حوادث السير، فإن لدينا هذه المعلومات.[216]
ويفتقر المستشفى افتقاراً تاماً إلى الخبرة المتخصصة في معالجة ضحايا العنف ومساعدتهن. ويقول مدير المستشفى: "لدينا عاملة رعاية اجتماعية واحدة، وهي تؤدي أعمالاً كتابية لأنها غير مؤهلة للإشراف على هذه الحالات".
وقد وثّقت منظمات حقوق المرأة الفلسطينية قيام أطباء في المستشفيات الفلسطينية بالكشف عن معلومات المرضى السرية دون موافقة هؤلاء المرضى؛ وهذا ما يردع النساء عن الإبلاغ عما تعرضن له من إساءة، وما يمكن أن يكلفهن أرواحهن إذا شاعت أخبارهن. وتصف المحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي حليمة أبو صلب واحدةً من هذه الحالات في عام 2002، وهي حالة فتاة في السادسة عشر من رام الله ذهبت إلى المستشفى مع والدتها لكي تعالج إصابةً في ساقها.[217] وبعد أن قام الطبيب بمعاينة الفتاة خرج إلى غرفة الانتظار المكتظة بالمرضى وقال للأم: "كيف أستطيع أخذ صورة أشعة؟ ابنتك حامل في الشهر الثامن".[218] وكان حمل الفتاة ناجماً عن اغتصابها عدة مرات من قبل شقيقيها البالغين 16 و21 عاماً.[219] وفيما بعد، قتلت الأم ابنتها قائلةً أن الضغط الاجتماعي عليها لقتل الفتاة كان كبيراً جداً بعد الكلام الذي دار في غرفة الانتظار بالمستشفى.[220] وفي حين يمضي الشقيقان حكماً بالحبس بسبب الاغتصاب، حكم على الأم بالحبس لشهر واحد بسبب قتل الفتاة، ولم يحكم على الأب إلا بأسبوع واحد بسبب مشاركته في القتل.[221]
وقد قال لنا مدير مستشفى رام الله أن على الأطباء عندما يشتبهون في أن المريضة كانت ضحيةً لأي نوعٍ من الجرائم إبلاغ نقطة الشرطة المجاورة للمستشفى بالأمر سواءٌ وافقت المريضة على ذلك أو لم توافق: "لدى بعض الأطباء قدرٌ من الوعي. فهم يتحدثون مع المرأة وينصحونها بالتوجه إلى جهاتٍ معينة. ومعظم هؤلاء من الأطباء الخصوصيين. أما في المستشفيات العامة فالأطباء يتصلون بالشرطة فوراً، فهم لا يريدون حمل هذه المسئولية".[222] إن أطباء القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتمتعون عموماً بقدرٍ أكبر من إمكانية الوصول إلى الموارد الفنية والمالية إضافةً إلى بعدهم عن السلطات من الناحية المؤسساتية، وهذا ما يمكن أن يفسر هذا الفارق في أسلوب التصرف.
يقدم الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد، وهو منظمةٌ دولية تمثل أطباء التوليد وأمراض النساء في أكثر من مئة بلد، إرشاداتٍ واضحة إلى العاملين الصحيين الذين يعالجون ضحايا العنف. وفي قرارٍ يتعلق بالعنف ضد النساء تبناه عام 1997، يرى الاتحاد أن الأطباء ملزمون أخلاقياً بأن: "يثقفوا أنفسهم وغيرهم من العاملين الصحيين والاجتماعيين بأنواع العنف ضد النساء ومداه ونتائجه السلبية، وأن يزيدوا قدرتهم على تمييز المرأة التي تتعرض للعنف وتقديم المشورة الداعمة لها وتقديم العلاج المناسب وإحالتها إلى الجهات المناسبة، وعليهم أن يعملوا مع الآخرين لتحسين فهم المشكلة عبر توثيق علائم العنف ضد المرأة وما يترتب عليه من عواقب مؤذية، إضافةً إلى تقديم المساعدة عند عرض قضايا الاغتصاب والإساءات الجنسية على القضاء وذلك من خلال التوثيق الدقيق للأدلة، فضلاً عن تقديم الدعم لمن يعملون على إنهاء العنف ضد النساء في أسرهم ومجتمعاتهم".[223] ومن الواجب إدخال هذه الالتزامات الأخلاقية، وغيرها، ضمن التعليمات الصحية التي تضعها وزارة الصحة الفلسطينية.
الأطباء الشرعيون واختبار العذرية القسري
"تعني سلامة غشاء البكارة إمكانية السكوت على الإساءة وإخفائها وإنكار وقوعها".
-د. ناذرة شلهوب كيفوركيان[224]
عادةً ما تطلب الشرطة والنيابة العامة في الضفة الغربية وغزة إخضاع النساء والفتيات غير المتزوجات اللواتي يقعن ضحية الإساءات الجنسية إلى اختبار العذرية الذي يجريه أطباء شرعيون غالبيتهم الساحقة من الذكور.[225] وتستهدف هذه الاختبارات تحديد ما إذا كانت الضحية عذراء أم لا عبر الكشف على سلامة غشاء البكارة، وذلك لمعرفة ما إذا كان قد تمزق نتيجةً لوقوع الجماع ولمعرفة تاريخ تمزقه. ويقول نائبٌ عام من الخليل: "لا يجري تحويل جميع حالات الاعتداء الجنسي إلى اختبار العذرية. فالأمر يعتمد على طبيعة الادعاء. فإذا قالوا أن الجماع لم يحدث فلا مبرر للاختبار. أما إذا كانت المرأة قاصراً أو ادعت أنها اغتصبت، فإننا نجري الاختبار لأن المرأة قد لا تعرف حقيقةً ما إذا كان غشاء البكارة قد تمزق أم لا".[226] ويقول نائبٌ عام آخر في رام الله أن الأطباء الشرعيين غالباً ما يجرون هذه الاختبارات في جميع حالات العنف الجنسي (وذلك بطلبٍ من النيابة العامة)، أما النساء والفتيات اللواتي يدعين التعرض للاغتصاب فيخضعن إلى اختبار الحمض النووي "دي إن إيه" أيضاً.[227]
وفي بعض الأحيان تأمر النيابة بإجراء هذه الاختبارات دون موافقة الضحية. وقد قال أحد النواب العامين لنا: "إذا كان الاختبار ضرورياً في القضية وكنا بحاجةٍ له فعلاً، فإننا نأمر بإجرائه حتى بدون موافقة صاحبة العلاقة. ففي حالة ادعاء الاغتصاب مثلاً نكون بحاجةٍ لاختبار العذرية للتأكد.... ونحن لا نفرض إلا الاختبارات التي تحتمها الضرورة".[228]
وتأمر نيابة الطب الشرعي بإجراء اختبار العذرية على جثة المرأة أو الفتاة التي يعتقد أنها وقعت ضحيةً لإحدى "جرائم الشرف"، وذلك للتثبت من عذريتها قبل موتها. ويمكن للمحكمة استخدام هذه المعلومات لكي تقرر ما إذا كان بوسع مرتكب الجريمة (أو مرتكبيها) الاستفادة من الأعذار المخففة. وإذا وجد الطبيب الشرعي الضحية غير عذراء، حتى لو أمكنت نسبة فقدان العذرية إلى الاغتصاب أو السفاح، يكون بوسع القاضي تخفيف الحكم بحق القاتل. وقد قال أحد النواب العامين لهيومن رايتس ووتش:
عند تشريح الجثة يقوم الأطباء بفحصها من الرأس إلى القدم، بما في ذلك إجراء اختباري الحمل والعذرية. ثم يقدمون تقريراً كاملاً يتضمن نتائج الاختبارات. وأؤكد أن هذا الأمر جزءٌ من التشريح العام وأن من يجري التشريح يقدم لنا جميع النتائج. لكن ما يستقطب الاهتمام عند التحقيق في ما يسمى جريمة شرف هو اختبار العذرية. ومن وجهة نظرنا كنيابة، فإننا لا نهتم بما إذا كانت الضحية عذراء أو لا لأننا نتعامل مع الأمر كجريمة قتل. لكن المشكلة تكمن في المحكمة، وذلك بسبب النص القانوني الخاص بالأعذار المخففة. فالمحكمة تنظر في كل شيء بما في ذلك الدوافع والظروف، إلخ.
وترتبط اختبارات العذرية بما يسمى "جرائم الشرف" بحق النساء والفتيات الفلسطينيات ارتباطاً وثيقاً. وفي بعض الحالات يجبر أفراد الأسرة ضحايا الإساءة الجنسية والنساء والفتيات المشتبه في ممارستهن الجنس خارج الزواج على الخضوع لاختبار العذرية.[229] وتمثل نتيجة الاختبار قضية حياة أو موت، لأن هناك "جرائم شرف" كثيرة يرتكبها أفراد الأسرة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات بعد ظهور النتيجة.[230] ويقول بعض أنصار حقوق المرأة الفلسطينيين ممن فضلوا عدم الكشف عن هواياتهم أن أطباء المستشفيات العامة غالباً ما يتسترون على أسباب الإصابات أو الوفاة عندما تصادفهم حالات العنف الأسري ويسجلون أسباباً كاذبة على شهادات الوفاة في حالة "جرائم الشرف".
كما تقوم الأسر بإجبار الأطباء على تسجيل عدم عذرية المرأة بغية تعزيز الدفاع المستند إلى أن القتل كان "جريمة شرف". ويقول المدير السابق لمعهد الطب الشرعي في أبو ديس د. جلال عبد الجبار أنه كان يجري كثيراً من اختبارات العذرية على ضحايا "جرائم الشرف" المزعومة أو على ضحايا الاعتداءات الجنسية.[231] وقد أجرى هذه الاختبارات أيضاً على جثث نساء وفتيات قتلن على يد أسرهن. وفي الحالات التي يتبين فيها أن المرأة عذراء بشكلٍ يكذب ادعاء الأسرة بوجود علاقة جنسية غير شرعية، غالباً ما يعمد أفراد الأسرة إلى تخويف الطبيب لكي يغير النتائج ويسجل أن المرأة لم تكن عذراء بحيث ينال القاتل حكماً مخففاً:
عندما نفحص امرأة قتلت في "جريمة شرف" ويتبين لنا أنها عذراء، يحاول الناس تخويفنا ودفعنا للقول بأنها لم تكن كذلك. فهم يعرفون أن القاتل سيحكم 17 عاماً إذا كانت القتيلة عذراء بدلاً من حصوله على حكمٍ أقل بفعل الأعذار المخففة.[232]
ويقول د. عبد الجبار أن النيابة العامة لا ترسل إلى معهد الطب الشرعي إلا قلةً من الحالات لأن أفراد الأسرة يقومون أحياناً بدفن المرأة أو الفتاة القتيلة سراً.[233] وقال لنا أيضاً أنهم كانوا يجرون اختبار العذرية بموافقة المرأة عندما كان في المعهد، وأنهم كانوا يجرونه دائماً في حضور سكرتيرة المعهد أو إحدى الممرضات:
أنا في صف المرأة دائماً. وأنا أريد مساعدة الناس. ولا يعني كون المرأة غير عذراء أنها امرأة سيئة. يمكن أن تولد المرأة دون غشاء البكارة.... ولا يمكن للطبيب أن يثق ثقةً قاطعة بأن تمزق الغشاء كان نتيجةً للجماع. وأنا لست موجوداً هنا لأمنح رخصةً بالقتل.[234]
وبالنسبة لبعض ضحايا العنف يكون الخضوع لاختبار العذرية المؤلم المهين الذي ينتهك خصوصيتهن أمراً لا يقل إساءةً عن العنف الذي تعرضن له. وتخلف هذه التجربة أثراً لا يمحى في نفوس بعض النساء والفتيات. فقد أجبرت الشرطة ريم حمد (اسم مستعار) على الخضوع لاختبار العذرية عندما أبلغت الشرطة بمحاولات والدها اغتصابها:
عندها عرفت أن الشرطة ليست في خدمة الشعب. إنهم قذرون جميعاً. لقد فحصوني ولم يجدوا شيئاً فقالوا أنني أكذب. كانت تلك المرة الأولى التي ينظر فيها أحدٌ بداخلي. لقد شعرت بالإذلال. إن أكبر جرائم والدي هو أنه تسبب في فحصي من قبل شخص غريب.[235]
تؤكد هيومن رايتس ووتش أن هذه الاختبارات غير مبررة وأن هذا التركيز على عذرية الأنثى ممارسةٌ تمييزية في حد ذاتها. وهي تؤكد على أن العذرية لا علاقة لها بإقامة الدليل على الاعتداء الجنسي في أي حالٍ من الأحوال. وقد يكون الفحص النسائي الطوعي أمراً شرعياً إذا جرى من أجل الحصول على أدلة تتعلق بتوجيه تهمة الاغتصاب مثلاً. لكن ما من سببٍ مشروع لإجراء اختبارات العذرية. بل أن هذه الاختبارات تكشف عن انشغالٍ زائدٍ في غير محله بعذرية الضحية وتعكس المعتقدات الخاطئة الشائعة حول التحقق من العذرية طبياً. ويؤكد الخبراء أن حالة غشاء البكارة ليست مؤشراً موثوقاً على وقوع الجماع منذ فترةٍ قريبة أو على كونه رضائياً أو غير رضائي.[236] إن درجة مرونة ومطاوعة وسماكة غشاء البكارة، إضافةً إلى موقعه ضمن القناة المهبلية، وبالتالي مقدار تعرضه للتمزق أو التأذي، تختلف من شخصٍ لآخر.[237]
نظام العدالة غير الرسمي
فقد الفلسطينيون إيمانهم بإصلاح النظام القضائي وتزايدت عودتهم إلى الوسائل "التقليدية" في تسوية النزاعات من خلال نظام العدالة غير الرسمي.[238] ويسير هذا النظام بالتوازي مع النظام الرسمي، وهو يستهدف إصلاح ذات البين بدلاً من اللجوء إلى تحقيق العدالة عبر القضاء. ويدير هذا النظام "قضاة غير رسميين" عادةً ما يرثون هذا الدور عن آبائهم وأجدادهم، حيث يجب أن يكونوا أشخاصاً يتمتعون باحترامٍ ونفوذٍ واسعين بين الأهالي. ويقيم هؤلاء القضاة غير الرسميين سلسلةً من الجلسات لمعالجة جملةٍ من النزاعات (كالاعتداءات والنزاع المالي أو العقاري) بين أفراد المجتمع المحلي، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق أو عقد مصالحة يوقع عليه الأطراف المعنيون. وإذا خرق أحد الفريقين شروط الاتفاق فإنه يلقى العقاب الذي عادةً ما يكون بدفع غرامةٍ مالية إلى الفريق الآخر.
وتقول دعاء منصور منسقة الدراسة حول نظام العدالة غير الرسمي والتي ستصدر عن جامعة بير زيت:
لا يعمل القضاة غير الرسميين وفقاً لقانونٍ محدد أو نظام للمحاكمات أو استناداً إلى السوابق في القضايا المماثلة. ومن هنا فإن شكل جلسات المحاكمة العلنية والصيغة المطبقة في كل حالة يعتمدان إلى حدٍّ كبير على رأي القاضي المعني وخبرته. ولا توجد حلولٌ نمطية لأي نوعٍ من القضايا.[239]
وتتحدث دراسةٌ أخرى تتناول العدالة غير الرسمية عن نوعٍ من القانون العشائري (العرفي) غير المكتوب يستخدم إطاراً مرجعياً في نظام العدالة غير الرسمي.[240] وليست لقرارات هذا النظام قوة الإلزام القانوني، فهي "تُفرض" من خلال الضغط الاجتماعي ومن خلال احترام أطراف القضية مكانة القضاة وقراراتهم.
وليس نظام العدالة غير الرسمي جزءاً من نظام العدالة الرسمي المستند إلى القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن المسئولين في نظام العدالة الجزائية الرسمي وبعض العاملين فيه يكونون أحياناً من القضاة غير الرسميين في مناطقهم الأصلية.[241] وتؤكد دراسة جامعة بيرزيت أن الفلسطينيين يلجئون إلى العدالة غير الرسمية أكثر من لجوئهم إلى العدالة الرسمية العادية؛ وأن ياسر عرفات كان يساند النظام غير الرسمي بإرساله كبار المسئولين للحكم بين الناس في قضايا تتميز بصعوبةٍ خاصة، أو بتقديمه مساهمةً مالية في الغرامة التي يتوجب دفعها في بعض القضايا.[242]
وبما أن القضاة غير الرسميين نادراً ما يتدخلون في النزاعات الأسرية، فإن هذا النظام لا يكاد يتناول قضايا العنف ضد النساء داخل الأسرة. وعندما يقوم احتمال وقوع "جريمة شرف"، حيث تكون حياة المرأة معرضةً للخطر، يلجأ الناس أحياناً إلى آليات نظام العدالة غير الرسمي. وتقول إحدى المراقبات أنه "يُعهد بأصعب القضايا الاجتماعية (أي حوادث القتل وقتل النساء) إلى أكثر زعماء العشائر احتراماً ونفوذاً وشهرةً".[243] وكثيراً ما ينظر هؤلاء الزعماء في النزاعات الاجتماعية التي تتضمن ادعاءاً بالاعتداء على "العرض" بوصفها أخطر أنواع الجرائم.[244] وقد يحاول القضاة غير الرسميين رعاية صفقةٍ تتعهد العائلة بموجبها بعدم إيذاء الفتاة أو المرأة أو بالبحث عن شخص في العشيرة أو العائلة الممتدة يكون قادراً على إيواء الفتاة في منزله. لكن دراسةً للمركز النسائي للمعونة والاستشارة القانونية تقول أن القضاة غير الرسميين، وهم من الذكور دائماً، غالباً ما يبدون تعاطفاً مع المعتدي الذكر حتى في حالات القتل لدواعي الشرف. ويقول قاضٍ قابله معدّو هذه الدراسة:
عندما تحوم الشكوك حول المرأة، فهذا يدل على أنها ارتكبت أمراً خطيراً. وأنا أستجوب المرأة حتى أقرر مدى صدق ما تقوله لي. وأنا أستطيع تمييز المرأة الكاذبة من الصادقة. وتمكنني خبرتي من اكتشاف الحقيقة عندما أنظر في عيني المرأة. وفي الغالبية الساحقة من الحالات المتعلقة بالنساء، يكون سلوك المرأة المنحرف هو السبب في موتها. فالرجل لا يعاقب المرأة ولا يقتلها من غير سبب.[245]
وقد أخبرنا رجال الشرطة أنهم عادةً ما ينسقون مع زعماء العشائر في المدينة أو القرية التي يقع الحادث فيها.[246] وتقول إحدى ناشطات حقوق المرأة الفلسطينية أيضاً أن رجال الشرطة طلبوا من عددٍ من زبائنها الذهاب بقضاياهم إلى زعماء عشائرهم للتوسط فيها.[247] وبما أن هذا النظام غير قضائي وغير منظم، فما من سبيلٍ لضمان الحفاظ على الحقوق القانونية للمرأة.
وتقول إحدى العاملات الاجتماعيات أنها تعرف من تجربتها أن زعماء العشائر غالباً ما يتصلون بالشرطة بمجرد وصول قضية تخص أحد أفراد العشيرة إلى المخفر: "وإذا لم يحصلوا على إجابة تعجبهم، فإنهم يتصلون بمن هم أعلى رتبةً في الشرطة. إن لديهم سلطةً كبيرةً ومجالاً واسعاً للحركة يتجاوز حتى ما لدى السلطة الفلسطينية... لقد سمحت السلطة لهذه العشائر النافذة بأن تصبح أقوى منها... ولم تبذل أي جهد للحد من دورهم".[248]
دور المخاتير في نظام العدالة غير الرسمي
"أنا ضد هذا النظام. يجب أن تذهب جميع القضايا إلى المحاكم. لكن هذا نتيجة للوضع الصعب الذي يعيشه القضاء. يريد الناس حلولاً سريعة فيذهبون إلى المخاتير. وهذه نتيجةٌ لفشل القضاء الجزائي. وإذا كانت لديك قضية، حتى لو كانت صغيرة، فهي تستغرق خمس سنوات. فما الذي تفعله؟"
-سهى علايا، معاونة قانونية في وزارة العدل، رام الله، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005
إن المخاتير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذين تعينهم السلطة التنفيذية ويعملون كممثلين للرئيس لمددٍ غير محددة، يلعبون دوراً أيضاً في نظام العدالة غير الرسمي. وتتباين مواقعهم (وبالتالي قدرتهم على التدخل في النزاعات) تبعاً لقربهم من الرئيس.[249] وخلال الانتفاضة كان عمل المحاكم النظامية معطلاً إلى حدٍّ كبير، فكان الفلسطينيون يذهبون غالباً إلى المختار من أجل حل النزاعات بسرعة. وقد أكد لنا الباحثون في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت أن القانون لا يمنح المخاتير سلطاتٍ قضائية رسمية، بل إنهم غالباً ما يكونون جزءاً من نظام العدالة غير الرسمي.[250] ويقول مراقبٌ آخر لدور المخاتير في حل النزاعات أنهم يحاولون تبرير تدخلهم في النظام القضائي استناداً إلى بعض أحكام واردة في القوانين والأنظمة البالية.[251] وتتضمن هذه القوانين تشريعاتٍ أردنية مثل قانون تنظيم التقسيمات الإدارية رقم 1 لعام 1966 وقانون منع الجريمة لعام 1954 الذي يمنح المخاتير صلاحية التدخل في الحالات الطارئة لمنع الجريمة.[252]
ويساهم المخاتير في "حل" قضايا العنف ضد النساء والفتيات. وتذهب ضحايا هذا العنف أحياناً إلى مكتب المختار في المدينة بغية تجنب وصمة الذهاب إلى مخفر الشرطة.[253] فضحايا الاغتصاب وسفاح القربى، وكذلك الحوامل غير المتزوجات وغيرهن من المعرضات لخطرٍ من جانب الأسرة، تذهبن إلى مكتب المختار طلباً للحماية.[254] وفي بعض الحالات يقدم المخاتير ملجأ لهاته النسوة.[255]
وتقول لينا عبد الهادي، المستشارة القانونية لمحافظ نابلس، أن المحافظة تتلقى مئات التقارير عن سفاح القربى. وقد قالت لنا:
شهد العامان الماضيان زيادةً في حالات السفاح بسبب الاشتراك في المسكن وبسبب عدم قدرة الرجال على الزواج... وتردنا ست أو سبع حالات اغتصاب سنوياً، إضافةً إلى كثير من حالات السفاح... وعندما أستدعي الآباء لا ينكرون الأمر. وهم يقولون: 'إن لي حقاً في جسدها قبل غيري' أو 'أريدها أن تذهب إلى زوجها مزودةً بالخبرة'.[256]
ورغم ادعاء لينا عبد الهادي أن من صلاحية مكتب المحافظ احتجاز المرتكبين لمدةٍ تصل عاماً واحداً، فإن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من العثور على مرجعٍ تشريعي يؤكد قولها. فقد قالت: "نستخدم الأحكام القانونية التي تسمح لنا بحبس الناس لسنةٍ واحدة وخاصةً في القضايا الأخلاقية. ويمكن أن يستغرق الأمر سنوات في المحاكم العادية... لكنني أفضل أن تذهب هذه القضايا إلى المحاكم لأنها تستحق أحكاماً أطول مدةً".[257]
ومع أن بعض المخاتير يبدون ميلاً إلى مساعدة النساء اللواتي يبلغنهم بما تعرضن له من إساءات، فإن مخاتير آخرين يظهرون تحيزاً ضد المرأة في تعاملهم مع قضايا العنف ضد النساء. وقد تحدثت إلينا منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة في برنامج غزة للصحة النفسية، حول تجربتها في العمل مع المخاتير: "تكتفي الشرطة بطلب المختار الذي يتولى حل المشكلة. إنهم يحملون المرأة مسئولية المشكلة. ونحن نعاني بعض الصعوبات عند الحديث معهم، فبعضهم يعتقد أن المرأة مخطئةٌ دائماً".[258] وتقول مراقبةٌ أخرى لدور المخاتير: "غالباً ما يفسر المختار القانون وفقاً لما يمكن أن يسميه توجهاً وطنياً... فكثيراً ما يؤدي التشديد على 'الوحدة' إلى اتخاذ جانب الفريق الأقوى في النزاع".[259]
وفي بعض القضايا التي يُخشى فيها خطر وقوع جريمة شرف، يرعى المختار عقد صفقة مع أفراد الأسرة الذين يعدون بعدم إيذاء المرأة إذا عادت معهم إلى المنزل. وقد أدت هذه الصفقات إلى مقتل كثيرٍ من النساء والفتيات. ورغم معاقبة المحافظين والمحاكم المحلية بعض مرتكبي هذه الجرائم من أفراد الأسرة (بأحكامٍ مخففة غالباً)، فإن الشرطة والنيابة العامة لا تحقق أبداً مع المخاتير أو غيرهم ممن يمكن أن يتحملوا قسطاً من المسئولية عن هذه الجرائم. والواقع أنه لا توجد آليةٌ لمراقبة سلوك هؤلاء الموظفين الحكوميين غير الرسميين أو لمحاسبتهم على أفعالهم.
ويوجه بعض الوزراء والقضاة النقد لاستخدام آليات لا تسلك سبيل القضاء العادي لحل النزاعات القانونية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، قال لنا وزير العدل آنذاك فريد الجلاد: "لا أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لحل المشاكل. يجب احترام القضاء. وعلى الشرطة إحالة جميع القضايا إلى المحاكم، باستثناء القضايا البسيطة التي تتضمن حقاً شخصياً بسيطاً".[260] ويقول قاضٍ لم يرغب بالكشف عن هويته: "قبل الانتفاضة، كانت جميع القضايا تذهب إلى المحاكم. لكنها تحل الآن عن طريق 'التوسط' في مخافر الشرطة. وكثيرةٌ هي القضايا التي تصل إلى المحكمة. ويقوم المختار أيضاً 'بحل' كثير من هذه القضايا. توجد شرطة وتوجد محاكم، وعلى المخاتير ألا يفعلوا ذلك". ورغم هذا الرأي، قال لنا وزير العدل أن أي إجراءٍ لم يتخذ للجم النشاطات شبه القضائية التي يمارسها المخاتير.[261]
عدم إتاحة الملاجئ لضحايا العنف
"لماذا تقع الجريمة؟ لأنه لا يوجد مكانٌ لحماية النساء"
-هاني الناطور، القاضي بمحكمة التمييز، رام الله، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005
فشلت السلطة الفلسطينية في إيجاد آلية حماية كافية لتوفير الملجأ من أجل ضحايا العنف. ورغم الطبيعة المنتظمة للعنف ضد المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يكن في الضفة الغربية إلا ملجأ واحد مخصص حصراً لضحايا العنف من النساء وقت إجراء الأبحاث الخاصة بهذا التقرير في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من عام 2005.[262]
والملجأ موجودٌ في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وهو يستوعب 25 امرأة فقط لفترة ستة أشهر. لكنه لا يستطيع استقبال أطفالهن. ويؤوي منزلٌ للفتيات في بيت لحم (بيت الفتيات) بعض ضحايا العنف الجسدي والجنسي، لكن مهمته أوسع نطاقاً إذ تشمل إيواء الفتيات اللواتي لا يستطيع أهلهن رعايتهن جسدياً أو مالياً. وقد أجبر نقص الملاجئ المنظمات النسائية والشرطة على ابتداع حلول خلاقة، وإن تكن خطيرةً في معظم الأحوال، من أجل ضحايا العنف. ومن هذه الحلول إيواءهن في مخافر الشرطة ومكاتب المخاتير وفي البيوت الخاصة وبعض المؤسسات كمدارس المكفوفين وملاجئ الأيتام.
وقبل الانتفاضة الثانية خاصةً، كانت الشرطة تحتجز بعض النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف احتجازاً "وقائياً" في أجنحة النساء في السجون الفلسطينية. لكن الشرطة كفت عن ذلك بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت السجون أثناء الانتفاضة وبسبب تأكيد وزارة الداخلية على عدم قيام الشرطة باحتجاز أيٍّ كان من غير أمرٍ من المحكمة. لكن هيومن رايتس ووتش وجدت أثناء زيارتها إلى سجن نابلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 أن اثنتين من أصل 14 امرأة محتجزة في ذلك السجن موجودتان هناك لحمايتهما من عنف ذويهما. ويقول مدير جناح النساء في السجن أن الشرطة اشتبهت في أن واحدةً من هاتين السجينتين تقيم علاقةً خارج الزواج وتخون زوجها. ومع أن هذه المرأة ترغب بالخروج من السجن وتقول أن أسرتها لن تؤذيها أبداً، فإن مدير إدارة السجون وقائد الشرطة والقاضي الذي نظر في قضيتها مقتنعون جميعاً بوجوب إبقائها خلف القضبان ريثما يطمئنون إلى أن الأسرة لن تحاول قتلها. وقد قررت السلطة نقلها (ونقل الرجل الذي اتهمت بإقامة علاقةٍ معه، وهو محتجزٌ أيضاً) من الضفة الغربية إلى غزة بعد ما قيل عن قيام أفراد من أسرتها بإطلاق النار على مكتب المختار الذي كانا محتجزين فيه. والظاهر أن شابةً أخرى في سجن نابلس موجودةٌ هناك لأنها هجرت منزل ذويها دون موافقتهم مما جعلها معرضةً للخطر من جانبهم.[263]
وتجعل القيود المفروضة على الانتقال بين الضفة الغربية وغزة وداخل كلٍّ منهما من المستحيل عملياً على بعض ضحايا العنف أن يذهبن إلى أحد الملجأين الموجودين في نابلس وبيت لحم؛ وهذا ما يتركهن دون ملجأ من العنف.[264] وفي الحالات الطارئة، تقوم المنظمات غير الحكومية والشرطة (وعلى نحوٍ غير قانوني) بإرسال النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف إلى الأردن أو إسرائيل من أجل سلامتهن. لكن زيادة الإجراءات الأمنية عند الحدود وقيام الجدار العازل يجعلان من هذا الخيار أمراً متزايد الصعوبة. وقد قالت لنا المحامية غدير الشيخ من طولكرم: "ليس في طولكرم ملجأ لحماية النساء؛ فليس للمرأة مكانٌ يحميها حتى وإن قمت بتمكينها. والمرأة ترى أن جميع الحالات المماثلة لحالتها تنتهي بالقتل".[265]
وتؤدي التوغلات العسكرية الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة إلى عزل بعض النساء الفلسطينيات ضمن حيزٍ يزداد ضيقاً، وخاصةً في المناطق الريفية حيث تجد النساء صعوبةً كبيرة في الوصول إلى شبكات العائلات الممتدة أو إلى الخدمات الاجتماعية والوقائية. ويتبين هذا الميل من خلال العدد الصغير من الفتيات المقيمات في بيت الفتيات ببيت لحم وفي ملجأ النساء بنابلس. وقالت لنا مديرة بيت الفتيات ببيت لحم أن عام 1999 شهد إيواء 49 فتاة في وقتٍ واحد، ولكن لم يكن فيه سوى 12 حالة أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وهذا ما يعود (جزئياً على الأقل) إلى صعوبة وصول الفتيات إليه.[266]
وتعيش ضحايا العنف الأسري في غزة أوضاعاً سيئة على نحوٍ خاص لأن من المستحيل عملياً على سكان غزة الذهاب إلى الضفة الغربية، ولأنه لا يوجد ملجأ في غزة. ويؤدي غياب ملجأ لضحايا العنف في غزة إلى إجبار المنظمات النسائية على اللجوء إلى حلولٍ لا تقبل بها من الناحية الإيديولوجية. وقد قالت منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة غير الحكومي: "تتصل بنا الشرطة أحياناً لتقول لنا أن امرأة اغتصبت وأنه لا يوجد مكانٌ لحمايتها. وعند ذلك نضطر إلى طلب مساعدة المختار رغم معارضتنا لهذا النظام لأنه ضد المرأة عموماً. فعادةً ما يطلب المختار من المرأة أن تتزوج مغتصبها إذا عُرفت هويته".[267]
أما فيما يخص الملجئين الموجودين في الضفة الغربية، فإن منظمات حقوق المرأة تعبر عن قلقها من أن معاملة القبول الطويلة فيهما، والتي تفرضها وزارة الشئون الاجتماعية، تمنع الضحايا من تلقي المساعدة العاجلة. كما اشتكت بعض المحاميات والعاملات الاجتماعيات من أن الوزارة لا تسمح لهن بمتابعة أحوال النساء أو الالتقاء بهن لأنهن صرن في عهدتها.
ويقر ممثلو الوزارة بأن هناك نقاط ضعف في معالجة الوزارة لقضايا العنف ضد المرأة. وقد قال لنا أحد كبار العاملين في الوزارة: "إننا نتعامل مع هذه الحالات ونحمي نساء كثيرات من القتل، لكننا لا نتعامل مع هذه الحالات بتخصص بسبب عدم وجود أخصائيين اجتماعيين وعدم توفر الوقت للتعامل مع هذه الحالات".[268]
لقد أدى اجتماع عدد من الصعوبات المالية والإدارية إلى وقف الجهود الرامية لإقامة ملاجئ جديدة في الضفة الغربية وغزة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وقام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بتأمين التمويل ثم ببناء ملجأ للنساء وأطفالهن في بيت لحم، لكنه لم يبدأ نشاطه بعد. وفي أوائل 2006، وبعد انتهاء البحث الميداني من أجل إعداد هذا التقرير، وقّع المركز المذكور مذكرة تفاهم مع وزارة الشئون الاجتماعية وبدأ تشغيل ملجأ للحالات الطارئة في إحدى مدن الضفة الغربية التي لم يكشف عن اسمها بغية توفير مزيد من الحماية للنساء والفتيات الراغبات بالاستفادة من هذا الملجأ. وملجأ الطوارئ هذا مكانٌ تستطيع النساء الباحثات عن مأمن من العنف أن يذهبن إليه بسرعةٍ من غير معاملاتٍ بيروقراطية مرهقة. وبعد عامين من المفاوضات الصعبة مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول شروط القبول وأنظمة إدارة الملجأ، أبلغنا مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في يونيو/حزيران 2006 أن الوزارة وافقت في النهاية على النقاط التي سعى المركز لاعتمادها، وأنه راضٍ عن العلاقة القائمة بين الملجأ الجديد وبين الشرطة المحلية وموظفي وزارة الشئون الاجتماعية في المنطقة.[269] وقد قامت الوزارة أيضاً ببناء وتجهيز ملجأ للفتيات تحت 18 عاماً في مدينة جنين، لكن ثلاث سنوات مرت دون افتتاحه.[270] ولم يتمكن موظفو الوزارة من إعطاء هيومن رايتس ووتش سبباً واضحاً لعدم افتتاح الملجأ حتى الآن، لكن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يقول أن الأمر عائدٌ إلى عقباتٍ مالية وسياسية.[271]
ملجأ نابلس
يعمل ملجأ نابلس على نحوٍ سري مع أننا لا نرغب بهذه السرية. إن المحافظة على سرية الحالات أمرٌ ضروري طبعاً، أما سرية القضية فلا معنى لها. يجب طرح مسألة العنف. وبعض الناس في الوزارة [الشؤون الاجتماعية] ضد هذا الرأي لأنهم يفضلون إبقاء الأمر [العنف ضد المرأة] طي الكتمان.
-ديانا مبارك، وزارة الشئون الاجتماعية، العيزرية (ضواحي القدس)، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005
تتولى جمعية الدفاع عن الأسرة، وهي منظمة غير حكومية تتلقى مساعدة مالية محدودة من وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارة ملجأ ضحايا العنف في نابلس. وأثناء زيارة هيومن رايتس ووتش إلى الملجأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، كان فيه أربع نساء، في حين يمكنه استيعاب 25 امرأة. ويمكن للنزيلات الإقامة في الملجأ ستة أشهر، لكن من حق لجنة مكونة من الوزارة وجمعية الدفاع عن الأسرة تمديد هذه الفترة.[272] وتتولى الوزارة قبول الطلبات وإحالة المقبولات إلى الملجأ. وهي مسئولة أيضاً عن النظام الأساسي للملجأ.[273] وقبل إقامة ملجأ نابلس، كانت ضحايا العنف والنساء المهددات بما يسمى "جرائم الشرف" عادةً ما ينمن في مخفر الشرطة أو في الوزارة، أو كن يحتجزن "وقائياً" في السجون.[274]
وحتى تكون المرأة مؤهلةً للإقامة في الملجأ، يجب أن تلبي مجموعةً من المعايير الصارمة التي وضعتها الوزارة. فالملجأ لا يقبل من يشتبه في أنها مدمنةٌ على المخدرات أو مريضة عقلياً، أو من يشتبه بممارستها الدعارة، إضافةً إلى عدم قبول من يعتبر أنها تمثل خطراً جسدياً على باقي النزيلات.[275] وقد قالت لنا الناشطات الاجتماعيات في أحد أبرز منظمات حقوق المرأة أنهن غالباً ما يترددن قبل إحالة الضحايا إلى ملجأ نابلس بسبب طول فترة الإجراءات التي تفرضها الوزارة. وقالت إحداهن أنها اضطرت إلى إيواء امرأة تتعرض للخطر من جانب أسرتها في مكتبها الخاص عدة أيام ريثما تدرس الوزارة ملفها، مع ما يحمله ذلك من خطرٍ محتمل على المرأة نفسها وعلى العاملين في المكتب.[276] ومن بين شروط القبول في الملجأ إجراء اختباري نقص المناعة المكتسب/الإيدز والحمل، وكذلك اختبار العذرية لتحديد حالة غشاء البكارة.[277] علماً أن الملجأ يقبل العذراوات وغير العذراوات. وقالت النساء والفتيات اللواتي تحدثنا إليهن أنهن يعتبرن هذه الاختبارات إجباريةً ويعتقدن أن لا مناص منها. وقالت لنا واحدةٌ منهن: "لديهم قانون يفرض إجراء الاختبار على كل فتاة تأتي إلى هنا".[278] ولا يقدم المركز للنزيلات أية استشارة تتعلق بهذه الاختبارات.
بيت الفتيات في بيت لحم
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية "بيت الفتيات" في بيت لحم عام 1985 من أجل "حماية وإعادة تأهيل" الفتيات بين 12 و18 عاماً. ويستقبل البيت ضحايا سفاح القربى إضافةً إلى الحوامل غير المتزوجات اللواتي يتعرضن للخطر من جانب أسرهن، وكذلك الفتيات اللواتي سُجن ذويهنّ أو لم يعودوا قادرين على إعالتهنّ. وتشرف الوزارة على إحالة الفتيات إلى هذا البيت. وتذهب الفتيات إلى المدرسة في النهار إذا رأت الإدارة ذلك مأموناً. أما الفتيات من مدينة بيت لحم وجوارها واللواتي يتعرضن لخطر أسرهن، فلا يذهبن إلى المدرسة لكنهن يتلقين تدريباً على الخياطة وتصفيف الشعر داخل البيت. وتقول مديرة البيت بوضوح أنها لا تسمح للفتيات بمغادرة البيت حتى عند بلوغهن سن الرشد (18 عاماً) إلا إذا وافق ذووهن على تولي الوصاية عليهن، أو إذا تزوجن.[279] وقالت أنها لا تسمح للنساء الراشدات بالعيش بمفردهن تحت أي ظرفٍ من الظروف.[280] وعند إثارة الأمر مع وزير الشؤون الاجتماعية حسن أبو لبدة أبدى استغراباً شديداً وقال أن هذا السلوك ليس من سياسة الوزارة.[281]
وعندما يستلم بيت الفتيات فتاة غير متزوجة حملت نتيجة الاغتصاب، يحاول العاملون عادةً التوسط بين المغتصب وأسرة الفتاة. وقالت مديرة البيت لنا أن الزواج هو الحل المثالي لقضايا الاغتصاب.[282] وعند سؤالها عما يحدث إذا لم تكن الفتاة راغبةً بالزواج من مغتصبها وفضلت توجيه الاتهام إليه قالت أن هذا غير واردٍ أبداً. وفي حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، ترى الوزارة أن الزواج أمر ضروري لأن الطفل يكون بغير ذلك "غير شرعي" ولا يحق له الحصول على شهادة ميلاد. وفي هذه الحالة تأخذ الوزارة الطفل فوراً من أمه وتعرضه للتبني.[283] وقد قالت لنا مديرة البيت:
تخبرنا المرأة باسم المغتصب. وإذا كان قد اغتصبها ثلاثة رجال فإننا نجري اختبار الحمض النووي دي إن إيه. ونحن نجبرها على الزواج. ولا يحق له تطليقها لمدة خمس سنوات... وهو يحبس إذا لم يتزوجها. وإذا لم تستطع الشرطة إجباره على الزواج منها، فإنهم يثبتون في وثيقة الزواج تاريخاً قديماً يسبق ولادة الطفل. لا ترغب أغلبية الفتيات بالزواج منه [المغتصب]. لكن طزّ فيها، فالطفل هو المهم.[284]
وخلال ست سنوات من إدارة جهاد أبو العين لبيت الفتيات في بيت لحم، لجأت إلى إجبار خمس فتيات على الزواج من مغتصبيهن.[285] وتقول أخصائية اجتماعية عملت في البيت 15 عاماً أنها شهدت عدداً لا يحصى من هذه الحالات.[286]
ويطلق العاملون في بيت الفتيات على من يثبت الاختبار عدم عذريتها اسم "حالة خاصة"، كما تقول جهاد أبو العين:
نحن لا نتكلم عنهن. ولا تعلم جميع الأخصائيات الاجتماعيات بهذه الحالات. لا تعود 'الحالات الخاصة' إلى أسرهن. فنحن من يقوم بدور الأسرة هنا. تكمل الفتاة تعليمها أو نجد لها زوجاً... نحن لا نلقي الفتيات في الشارع. ولا نسمح للفتاة باستئجار منزل. إنها بحاجةٍ لأن تكون ضمن وضع مشروع ومع أشخاص محترمين.[287]
وقالت لنا أخصائية اجتماعية في بيت الفتيات: "إن الزواج هو أكثر عمليات إعادة التأهيل نجاحاً. أما الفتاة التي لا تريد الزواج فتبقى هنا".[288]
التزامات يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان
مع أن السلطة الفلسطينية ليست دولةً مستقلةً ذات سيادة تستطيع التوقيع والمصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، فقد ألتزمت من جانبٍ واحد بالخضوع لهذه القوانين الدولية وقد تعهد قادة السلطة الفلسطينية مراراً في اجتماعاتهم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وفي أحاديثهم مع وسائل الإعلام، إضافةً إلى ما التزموا به في اتفاقيات أوسلو، بمراعاة معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
وتنص المادة 10 من مشروع الدستور الفلسطيني (القانون الأساسي[289]) على أنه "يجب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها"، و"ستعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون تأخير على الانضمام إلى المعاهدات والإعلانات الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان". كما تنص المادة 9 من القانون الأساسي على أن "الفلسطينيين متساوون أمام القانون والقضاء دون تمييزٍ بينهم على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الإعاقة أو الآراء السياسية". وبموجب البروتوكول الخاص بإعادة الانتشار بموجب الاتفاقية المؤقتة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، التزمت السلطة الفلسطينية أيضاً بأن تمارس شرطتها صلاحياتها ومسؤولياتها في تنفيذ المذكرة مع مراعاة حكم القانون ومعايير حقوق الإنسان المقبولة دولياً، وتسترشد بمبادئ ضرورة حماية الناس واحترام كرامة الإنسان وتجنب مضايقته. إن المادة 9 من القانون الأساسي تضع أسساً هامة للمساواة وعدم التمييز في النظام القانوني الفلسطيني. لكن، وإذا لم يترجم هذا الالتزام إلى حمايةٍ قانونيةٍ ملموسة لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم النساء، فسوف تكون خاليةً من المضمون.
وتقع على إسرائيل أيضاً مسؤولية تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها في المناطق الواقع تحت سلطتها، كالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أكد عليه الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. أما في المناطق التي جرى فيها نقل اختصاص تنفيذ الحقوق الواردة في المعاهدات إلى السلطة الفلسطينية فإن إسرائيل تظل "تحت التزامٍ يقضي بعدم وضع أية عقبات أمام ممارسة هذه الحقوق".[290] ومن هنا، يكون على إسرائيل مثلاً عدم الإقلال من قدرة القضاة وعناصر الشرطة والأطباء الشرعيين والمحامين الفلسطينيين والجهات الفلسطينية التي تقدم الخدمات الاجتماعية من الحركة بين الضفة الغربية وغزة وإسرائيل وفيها بغية أداء عملهم أو من أجل تلقي التدريب.
الحق في المساواة وعدم التمييز أمام القانون
تقضي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن تتخذ الدول "جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".[291] وهي تلزم الدول "بالامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام"، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة". وتفرض هذه الاتفاقية على الحكومات:
تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحامل والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.[292]
لكن جملةً من القوانين والممارسات التمييزية لا تزال موجودة في الضفة الغربية وغزة على نحوٍ يخالف التزامات السلطة الفلسطينية. فهذه القوانين تنكر على النساء الفلسطينيات حقهن في المساواة أمام القانون، وهو حقٌ واردٌ في عددٍ من الاتفاقيات الدولية من بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وينص هذا العهد تحديداً على وجوب تمكن الرجال والنساء من التمتع المتساوي بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي ينص عليها. وتقول المادة 26 خاصةً:
الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ،أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
وعلى النقيض من هذه الأحكام جميعاً، فإن التشريع النافذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمارس تمييزاً واضحاً على أساس الجنس مما يجعل النساء يواجهن انتقاصاً من حقوقهن سواءٌ في القانون أو في الممارسة العملية كما يبين هذا التقرير. ومع أن بعض هذه النصوص محايدٌ في الظاهر إزاء النوع الاجتماعي، فهي تضر بالمرأة الفلسطينية وحدها تقريباً. وهي تحوي ثغراتٍ قانونية تؤدي في النهاية إلى إعفاء المغتصب من العقوبة وتمتنع عن الاعتراف بالعنف الجنسي المرتكب ضمن الزواج. وينكر القانون أيضاً على ضحايا سفاح الأقارب من الأطفال حقهم بتقديم اتهاماتٍ بالاعتداء الجنسي. ولا يتمتع بهذا الحق إلا أفراد الأسرة الذكور الذين قد يكون مرتكب الإساءة واحداً منهم. كما أن هذه القوانين تحظر الإجهاض في حالات الاغتصاب أو السفاح مرغمةً ضحايا العنف الجنسي على الاستمرار في الحمل إلى نهايته.
وتنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية".[293] وبشكلٍ خاص، فإن على الدول أن توفر للمرأة الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.[294] وعندما يفضل عناصر الشرطة الفلسطينيون والعاملون في بيت الفتيات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية اللجوء إلى التوسط وتشجيع عقد الزواج بين المغتصب والضحية، فإنهم يضعون النساء والفتيات تحت القسر وينكرون عليهن الحق في عدم الزواج إلا برضاهن الحر الكامل.
وقد أوضحت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية، أن على الدول أيضاً واجب إقرار "تشريعات تلغي فكرة الدفاع عن الشرف فيما يخص مهاجمة أو قتل أفراد الأسرة من الإناث".[295] وتكرر لجنة حقوق الطفل نفس الرأي: "على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الفعالة للقضاء على جميع الأفعال والنشاطات التي تهدد حق المراهقين بالحياة، بما في ذلك جرائم القتل بدافع الشرف".[296] إن السلطة الفلسطينية، بامتناعها عن ردع جرائم قتل النساء باسم الشرف أو التحقيق فيها أو تقديمها إلى القضاء وإنزال العقاب بمرتكبيها، تسمح باستمرار ممارساتٍ تمييزيةٍ تنتهك حق المرأة في الحياة.
كما أن اشتراك النيابة العامة الفلسطينية والأطباء الشرعيين في فرض اختبار العذرية القسري يخرق الضمانات ضد التمييز التي ينص عليها كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تنتهك هذه الاختبارات بعض أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.[297] وعند إجراء هذه الاختبارات من غير مبررٍ طبي وعلى نحوٍ يخالف إرادة الفتاة أو المرأة، فإنها تعتبر بحد ذاتها نوعاً من الإساءة الجنسية. وهي اختبارات مذلةٌ وتبعث على الخوف، لكونها تمثل اعتداءً جسدياً من جهة، وبسبب العواقب الخطيرة التي يرتبها ثبوت فقدان "شرف" الأسرة من جهة أخرى.
مسؤولية الدولة عن لإساءة التي يرتكبها طرف ثالث
يحمّل القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولة مسؤولية الإساءة التي ترتكبها جهاتٌ خاصة، ويطالب الدول باتخاذ الحيطة اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والرد عليها. ففي ملاحظتها العامة رقم 19 تؤكد لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن: "الدول يمكن أن تكون مسئولة أيضاً عن أفعال الجهات الخاصة إذا امتنعت عن اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع انتهاك الحقوق أو إذا امتنعت عن التحقيق في أفعال العنف ومعاقبة مرتكبيها".[298] كما أن الامتناع المستمر عن ذلك من جانب الدولة يرقى إلى درجة المعاملة التمييزية وغير المتساوية ويمثل خرقاً لالتزامات الدولة بضمان الحمية القانونية المتساوية للمرأة، وذلك عندما تشكل النساء النسبة الغالبة من الضحايا.
وقد حددت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الخطوات الرئيسية اللازمة لمكافحة العنف ضد النساء. وعلى السلطة الفلسطينية بذل قصارى جهدها لإتباع هذه الخطوات ضمن صلاحياتها:
1.تدابير قانونية فعالة تتضمن عقوباتٍ جزائية وعلاجاً مدنياً وإنصافاً قضائياً لحماية النساء من جميع أشكال العنف والإساءة داخل الأسرة، ومن الاعتداء والتحرش الجنسيين في مكان العمل؛
2.تدابير وقائية تتضمن تثقيفاً عاماً وبرامج تعليمية هادفة إلى تغيير الآراء الشائعة المتعلقة بدور ومكانة كل من الرجل والمرأة؛
3.تدابير بهدف الحماية تتضمن توفير الملجأ والمشورة وإعادة التأهيل وخدمات الدعم لضحايا العنف أو المعرضات لخطر العنف من النساء.[299]
إن السلطة الفلسطينية تمتنع ،كما تبين نتائج هذا التقرير، عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من الانتهاك من جانب طرف ثالث. بل إن القوانين النافذة في الضفة الغربية وغزة تؤدي إلى الإفلات الفعلي من العقاب لمرتكبي هذا العنف وتمنع الضحايا من الإبلاغ عن الإساءات. وهي تنكر على الضحايا حقهن في الحماية وعدم التمييز وفي الإنصاف القضائي الحقيقي، وتمتنع أيضاً عن فرض رادع فعلي في وجه مرتكبي العنف بحق النساء والفتيات أو عن فرض العقوبة بحقهم. ويؤدي امتناع السلطة الفلسطينية عن إنشاء آلية مؤسساتية شاملة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة إلى ترك النساء والفتيات الفلسطينيات دون حمايةٍ من العنف الجنسي.
وبالإضافة إلى تصنيف العنف الجنسي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان كتمييزٍ يستند إلى الجنس، يمس هذا العنف الحقوق الجنسية والحق في السلامة الجسدية. إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يكفل الحق في السلامة الجسدية من خلال الحمايات التي يقدمها لأمن الأشخاص.[300]
إن الحماية من العنف الجنسي تنطبق أيضاً على الأشخاص دون 18 عاماً. وتنص اتفاقية حقوق الطفل على وجوب حماية الأطفال من "جميع أشكال العنف الجسدي أو العقلي، والإساءة والأذى والإهمال والمعاملة اللامبالية والمعاملة السيئة والاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية"، وضمان تلقي الضحايا العلاج القانوني والنفسي ـ الاجتماعي.[301]
إن العنف يحرم المرأة من ممارسة جملةٍ من حقوقها. ومن هذه الحقوق الحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،[302] وحق الأشخاص في الأمن،[303] وحقهم في الحياة[304]. وقد لاحظت لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن "العنف المستند إلى نوع الجنس هو ضربٌ من التمييز يحد بشكلٍ خطير من قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل"، بما في ذلك الحق في إحراز أعلى سوية ممكنة من الصحة الجسدية والنفسية.[305]
لقد فشلت السلطة الفلسطينية في إيجاد الإطار المؤسساتي الفعال لمنع العنف ضد النساء والفتيات، ومعاقبة مرتكبي هذه الإساءات عند وقوعها، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الأفعال العنيفة، وحمايتهن من العنف اللاحق. كما تفتقر الشرطة الفلسطينية إلى الخبرة (وإلى الإرادة كما هو واضح) من أجل التعامل مع حالات العنف ضد النساء بطريقةٍ فعالةٍ تتحسس احتياجات الضحايا وتحترم خصوصياتهن. كما أن غياب الإرشادات الطبية الموجهة للأطباء يؤثر على نحوٍ خطير في جودة العلاج الطبي المقدم لضحايا العنف من الإناث.
ولم تتخذ السلطة الفلسطينية الخطوات اللازمة لضمان قدرة ضحايا العنف الجنسي على التماس العدالة. وفي خرقٍ للقانون الدولي، يمكن إجبار أو قسر النساء والفتيات الفلسطينيات، اللواتي يبلغن الأسرة أو السلطات عما يتعرضن له من إساءة، على الزواج من المغتصب أو من أي غريبٍ "لمحو" الإساءة، وذلك حتى قبل وصول القضية إلى النيابة أو إلى المحكمة.[306] إن هذه الزيجات القسرية أمر مدان بوصفها ممارساتٍ تقليديةٍ مؤذية ونوعٍ من العنف المستند إلى النوع الاجتماعي.[307]
وتبعاً للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن ما يقدم للموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من تدريب يراعي حساسية النوع الاجتماعي أمرٌ أساسي من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية. ويمكن لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منع الجريمة وتدابير العدالة الجزائية للقضاء على العنف ضد المرأة أن يؤدي إلى تحسنٍ كبير في استجابة الشرطة الفلسطينية إلى حالات العنف ضد النساء والفتيات. ويدعو هذا القرار الحكومات ، من بين أمورٍ أخرى، إلى: "ضمان التطبيق المنسجم للأحكام القانونية النافذة والأنظمة والتدابير المتعلقة بالعنف ضد المرأة ..."، "وإيجاد أساليب بحث وتحقيق تكون غير مذلةًٍ لضحايا العنف وتقلل من اقتحام خصوصياتهن إلى الحد الأدنى..."، و"ضمان أن تأخذ تدابير الشرطة، بما فيها قرار اعتقال المرتكِب واحتجازه وشروط إخلاء السبيل بكل أنواعه، ضرورة سلامة الضحية بعين الاعتبار... وضرورة أن تؤدي هذه التدابير إلى منع العنف اللاحق بحقها" و"تمكين الشرطة من الاستجابة السريعة لحوادث العنف ضد المرأة".[308]
خاتمة
على المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الحالية حفظ وعود والتزامات سلفيهما بضمان توافق قوانين السلطة الفلسطينية وسياساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعليهما التقدم خطوةً عن سلفيهما باتجاه ضمان انعكاس هذه المعايير في القوانين واحترامها في التطبيق العملي. ومن شأن العمل بهذه المعايير، رغم كونها غير ملزمة للسلطة الفلسطينية، أن يجعل عمل السلطة منسجماً مع أفضل التجارب العالمية وان يلبي ما انتظره الفلسطينيون طويلاً من إصلاح حكومي وأمن شخصي. أما الامتناع عن توفير أعلى درجات الحماية القانونية للنساء ولأفراد المجتمع الفلسطيني فسوف يزيد من تآكل الدعم الشعبي لقوات الأمن الفلسطينية وصلاحياتها.
ويجب أن يحتل إيجاد الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون الفاعلة القادرة على التصدي للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله مقدمة أولويات الحكومة الجديدة. ورغم العقبات الكبيرة التي تواجه السلطة الفلسطينية بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فإن ثمة إجراءات بسيطة ملموسة يمكن للسلطة الفلسطينية اتخاذها على نحوٍ عاجل لإقامة هيكليات مؤسساتية تعالج العنف المستند إلى النوع الاجتماعي. وعليها بالحد الأدنى أن تدرب الموظفين الحكوميين (بمن فيهم عناصر الشرطة والأطباء والمخاتير والأطباء الشرعيين، إلخ) ممن لهم صلة بضحايا العنف الجسدي والجنسي على كيفية التعامل مع هذه الحالات على نحوٍ ملائم، إضافةً إلى وضع إرشادات واضحة ومحددة للتدخل تكون منسجمةً مع أفضل المعايير والأساليب الدولية. وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً أن تبطل معظم ما يحويه القانونان المصري والأردني النافذان في الضفة الغربية وقطاع غزة من أحكامٍ تمييزيةٍ ومسيئة تعمل على عرقلة الجهود الرامية لمعالجة العنف المستند إلى النوع الاجتماعي.
ومع أن العنف ضد المرأة (وهو مشكلةٌ عالمية) ليس مقتصراً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن لدى السلطة الفلسطينية فرصةً فريدة لإدخال حماية الحقوق الإنسانية للمرأة في مشروعي قانوني العقوبات والأسرة الجديدين. ومع أن المواقف الاجتماعية المتساهلة إزاء العنف ضد النساء والفتيات قد تكون بطيئة التغير، فإن من شأن سياسية عدم التسامح مع هذا العنف أن تمثل إسهاماً بارزاً يمكن أن يعمل كحافزٍ على مزيدٍ من التبني الاجتماعي لحقوق المرأة.
التوصيات
"علينا ضمان أن يأتي الرد على التمييز والعنف كافياً وفاعلاً وفي وقته المناسب. فما يلزمنا هو نظامٌ متكامل".
-حسن أبو لبدة، وزير الشئون الاجتماعية السابق، رام الله، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005
تقدم هيومن رايتس ووتش التوصيات التالية لمساعدة السلطة الفلسطينية على إصلاح قوانينها وأساليب عملها بما ينسجم مع المعايير الدولية بغية ضمان قدرة النساء والفتيات الفلسطينيات على ممارسة جميع حقوقهن الإنسانية بمنأى عن العنف. وبعض هذه التوصيات أكثر تطلباً للموارد من غيرها وهي تعتمد على مقدار توفر مساعدات المانحين الدوليين. أما التوصيات الأقل تطلباً للموارد، والواردة أدناه، فمن الممكن والواجب تطبيقها على وجه السرعة.
إلى السلطة الفلسطينية
إلى الرئيس محمود عباس
·وضع خطة خمسية لمنع العنف ضد النساء والفتيات واستئصاله والمعاقبة عليه، بحيث تتضمن خطوات محددة تضمن وصول ضحايا الإساءة الجسدية والجنسية إلى العدالة. ويجب أن تشتمل هذه الخطة تنسيقاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة والنيابة العامة والقضاة مع مشاركة منظمات حقوق المرأة الفلسطينية، وذلك في جميع مراحل وضع هذه الخطة. ويجب أن تتضمن الخطة أيضاً جهداً منتظماً لإجراء الأبحاث والدراسات التقييمية حول العنف ضد المرأة، وأن تتضمن استجابات برنامجية تضمن التوصل إلى أفضل الاستجابات ضمن الشروط الصعبة التي يعانيها كل من المجتمع ونظام العدالة الجزائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛
· إطلاق حملة توعية عامة شاملة حول العنف ضد النساء والفتيات. ويجب أن تشتمل هذه الحملة إعلانات تلفزيونية وإذاعية عن الخدمات العامة المتاحة بحيث تزود الجمهور بأرقام هاتفية ساخنة تمكنهم من الاتصال بمراكز الأزمات وبمعلومات عن الخدمات المقدمة للضحايا الآخرين؛
·إصدار التعليمات إلى جميع المخاتير وزعماء العشائر بإحالة جميع القضايا المستندة إلى النوع الاجتماعي إلى السلطات القانونية المختصة وضمان محاسبتهم على امتناعهم عن ذلك. وعلى الرئيس أيضاً أن يدرس دور نظام العدالة غير الرسمي في التوسط في النزاعات الاجتماعية غير الجنائية لضمان عدم ممارسة النظام القائم التمييز بين أفراد المجتمع؛
·العمل على ضمان التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والصلاحيات فعلاً، بمن فيهم المخاتير وزعماء الحمولات ممن يؤيدون العنف ضد النساء أو الفتيات أو الذين يتسامحون إزاءه، ومحاسبتهم على أفعالهم سياسياً وجزائياً عند الحاجة؛
·إعراب السلطة، عن طريق الإذاعة والصحافة المطبوعة وغير ذلك، عن دعمها لحق النساء والفتيات في المساواة في مختلف نواحي حياتهن العامة والخاصة بما في ذلك عدم التعرض إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمذلة.
إلى المجلس التشريعي الفلسطيني
·سن قانون لحماية الأسرة من شأنه ضمان حظر جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وينزل بمرتكبيها العقوبات المناسبة وبما يتسق مع المعايير الدولية
·وريثما يجري اعتماد هذا القانون، إلغاء أحكام قانوني العقوبات الحاليين النافذين في الضفة الغربية وغزة والتي تتغاضى عن العنف ضد النساء والفتيات أو تسمح به، ومنها:
oالأحكام التالية من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960:
§ المادة 340 التي تخفف عقوبة الذكر الذي يقتل قريبته المتورطة في الزنا؛
§المادة 301 التي تعتبر عذرية المغتصبة ظرفاً مشدداً للعقوبة؛
§المادة 308 التي تسمح للمحكمة بطيّ القضية أو وقف تنفيذ الحكم إذا وافق المغتصب على الزواج من الضحية؛
§المادة 286 التي لا تسمح إلا لأفراد الأسرة الذكور بتقديم تهمة السفاح نيابة عن القصر.
o الأحكام التالية من قانون العقوبات المصري رقم 58/1937
§المادة 237 التي تنص على الأعذار المخففة لقتل الزوجة (وليس الزوج) في حالة التلبس بالزنا؛
§المادة 291 التي تعفي المغتصب الذي يوافق على الزواج من الضحية من العقوبة.
إلى النيابة العامة
·تشجيع النساء والفتيات على إبلاغ الشرطة والنيابة عن العنف الأسري والجنسي، وذلك من خلال اعتماد إجراءات سريعة ولائقة للتحقيق والملاحقة القضائية وتوفير الحماية الكافية للضحية والشهود وتقديم خدمات تخصصية يسهل الوصول إليها من قبل ضحايا العنف الأسري والجنسي؛
·الجمع والتحليل المنهجيين للبيانات وتوفير معلومات عن عدد شكاوى العنف الأسري والجنسي المسجلة، وعن نتائج الملاحقات القضائية، وتحديث هذه المعلومات باستمرار؛
·تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 (والتي تفرض عقوبةً مخففة بحق من يرتكب الجريمة في "سورة غضب") بطريقةٍ تلتزم الحياد بين الجنسين ولا تأخذ باعتبارها "الغضب" ولا "السلوك المتهور" في القضايا ذات الصلة بما يسمى "جرائم الشرف"؛
·دراسة جدوى إقامة مراكز تخصصية ترتبط بالنيابة العامة لتقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف الأسري والجنسي. ويجب أن تكون هذه المراكز مزودةً بعدد كافٍ من العاملين وأن يوفر لها تمويلٌ يمكنها من مساعدة جميع الضحايا على وجه السرعة، كما يجب أن يكون وصول الضحايا إليها سهلاً؛
·إلغاء إجراء اختبار العذرية على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للإساءة، وتوجيه جميع الأطباء والعاملين الصحيين بعدم إجراء هذه الاختبارات.
إلى وزارة الداخلية
·اتخاذ قرار بالالتزام، من القمة إلى القاعدة، بملاحقة جرائم العنف ضد النساء والفتيات على قدم المساواة مع غيرها من الجرائم، أي القضاء على التمييز في مجال منع وقع هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً؛
·وضع توجيهات واضحة ومحددة تضبط تدخل الشرطة في حالات العنف الأسري، بما في ذلك سياسات اعتقال قياسية موحدة بحق المرتكبين، وتسجيل جرائم العنف الأسري ضمن فئةٍ منفصلة في سجلات الشرطة، ووضع أنظمة لإحالة ضحايا العنف الأسري إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية والصحية المناسبة. ويجب أن تنسجم هذه التوجيهات مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منع الجريمة وأصول المحاكمات الجزائية للقضاء على العنف ضد المرأة؛
·إقرار تدريب إلزامي للشرطة حول العنف ضد النساء والفتيات وتكليف خبراء في هذا الموضوع من أجل العمل لإزالة التحيز ضد النساء عند التعامل مع هذه القضايا. ويجب أن تشتمل برامج التدريب (وبالحد الأدنى) إجراءات تلقي جميع شكاوى العنف الأسري على نحوٍ فاعل، وتدريباً قانونياً على القوانين المناهضة للعنف المنزلي (عندما يجري إقرارها)، ووضع نظام للتعامل مع شكاوى العنف الأسري، وكذلك التدريب على آليات حدوث العنف الأسري. ويجب إجراء التدريب وفق منهجيةٍ تحقيقية صالحة للتطبيق على حالات العنف الأسري بما في ذلك أساليب أخذ أقوال الضحايا المصابات بحالة صدمة وأساليب حماية الضحايا والشهود من المضايقات وأساليب جمع الأدلة وحفظها؛
·تطبيق القرار الحكومي السابق بتشكيل وحدة مختصة بالعنف الأسري في كل مخفر شرطة؛
·إصدار تعليمات إلى جميع عناصر الشرطة تقضي بالحفاظ على سرية جميع قضايا العنف ضد النساء والفتيات، إلا ما يقتضيه واجب الشرطة. واتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي شرطي يخرق سرية القضايا؛
·أمر الشرطة بفتح محضر رسمي في كل مرة ترد فيها شكوى حول العنف ضد النساء والفتيات؛
·منع عناصر الشرطة من اقتراح تزويج الضحية من المرتكب كحلٍّ لقضايا الاغتصاب؛
·اعتماد نظام من أوامر الاعتقال يمكن إتباعه بمعزلٍ عن نظام المحاكمات الجزائية من أجل حماية النساء والفتيات من خطر أعمال عنف لاحقة بحقهن؛
·منع الشرطة من إجراء (أو التهديد بإجراء) اختبارات العذرية على النساء دون موافقتهن الواعية، ومنعهم من إحالتهنّ إلى الطبيب الشرعي بهذه الغاية؛
·جمع وتعميم معلومات موثوقة عن عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات التي يبلغ عنها شهرياً في كل منطقة.
إلى وزارة الشؤون الاجتماعية
·إحداث مديرية متخصصة ضمن الوزارة للتعامل مع العنف الأسري. وعلى هذه المديرية اعتماد سياسات وأنظمة داخلية غير موجودة حالياً هدفها توجيه عمل الوزارة في جميع النواحي المتعلقة بالعنف الأسري؛
·توفير مزيد من التدريب للعاملين في الوزارة ممن يتعاملون مع قضايا العنف الأسري. ويجب تنفيذ هذا التدريب بالتعاون مع المنظمات النسائية المعنية التي سبق لها أن قدمت تدريباً اختصاصياً للجهات الحكومية؛
·إقامة مراكز إيواء ذات جودة عالية، أو ما شابهها من الأماكن الآمنة، من أجل النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف بحيث تعمل هذه المراكز كملاجئ دون الانتقاص من خصوصية المرأة واستقلاليتها الشخصية وحريتها في الحركة؛
·إنشاء صندوق لدعم عمل ملجأ جنين الذي صار جاهزاً للعمل لكنه بحاجةٍ إلى تمويل؛
·ضمان عدم تمتع العاملين في الملاجئ بصلاحية رفض النساء الباحثات عن ملجأ من العنف استناداً إلى معايير عشوائية أو شخصية؛
·إقامة خطوط هاتفية ساخنة في الضفة الغربية وغزة من أجل ضحايا العنف الأسري. ويجب القيام بدعاية واسعة لهذه الخطوط التي يفترض أن يديرها كادرٌ مدرّب يمكنه تقديم الاستشارات الأساسية وتوفير فرصة الإحالة (دون اتخاذ موقف من القضية) إلى الملاجئ والجهات التي تقدم الخدمات التخصصية.
إلى وزارة الصحة
·وضع إرشادات لجميع العاملين الطبيين الذين قد تردهم ضحايا العنف الجسدي والجنسي، وذلك بما يضمن احترام السرية مع تقديم ما يلزم من إحالات طبية ونفسية ووقائية وقضائية للضحايا، سواءٌ كانت حالاتهن حقيقيةً أو مشكوكاً فيها؛
·تدريب الأطباء على التعرف على حالات الاغتصاب أو العنف الأسري والتعامل معها بشكلٍ ملائم. وعلى الوزارة التفكير في اعتماد الدليل التدريبي للأطباء حول التعامل مع ضحايا العنف، وهو دليلٌ وضعته منظماتٌ غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وكذلك إتاحة فرصة المشاركة في هذا التدريب أمام المنظمات صاحبة الخبرة؛
·توظيف وتدريب اختصاصيات اجتماعيات يمكنهن تقديم المشورة لضحايا العنف اللواتي يحددهن أطباء قطاع الخدمات الطبية العامة، والدفاع عن هؤلاء الضحايا؛
·جعل المعاهد والكليات الطبية تعتمد برنامجاً تدريبياً في مجال العنف الأسري كجزءٍ من مناهجها. ويجب أن يشمل هذا البرنامج تدريباً على توثيق الإصابات الناتجة عن الضرب أو العنف الجنسي، وأن يتضمن الأسلوب الأفضل لخدمة المريضات اللواتي تظهر عليهن هذه الإصابات؛
·توفير حماية أمنية للضحايا على مدار 24 ساعة، بحيث تكون مدربةً على صد المرتكبين الذين يحاولون مضايقتهن في المستشفيات المحلية؛
·ضمان عدم قيام الأطباء والعاملين الصحيين بإفشاء المعلومات السرية الخاصة بالمريضات. واتخاذ تدابير تأديبية بحق من يفشون هذه المعلومات دون موافقةٍ واعية من الضحايا اللواتي يبلغن عن العنف؛
·إيجاد نظام في مستشفيات الضفة الغربية وغزة من أجل رصد عدد ضحايا العنف الأسري اللواتي يلتمسن الرعاية الطبية.
إلى حكومة إسرائيل
ثمة التزاماتٌ يفرضها القانون الإنساني الدولي على حكومة إسرائيل بوصفها قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتمثل بواجب ضمان أمن وسلامة السكان الفلسطينيين المحميين قانوناً. ويجب توسيع هذا الالتزام بحيث يحمي أضعف أفراد المجتمع الفلسطيني. إن هيومن رايتس ووتش تدعو حكومة إسرائيل إلى:
·منح القضاة وغيرهم من الأشخاص الذين لا غنى عنهم من أجل العمل السليم لنظام العدالة الفلسطيني تصاريح سفر سارية المفعول أثناء فترات الإغلاق. وتوجيه أفراد الأمن الإسرائيلي إلى احترام هذه التصاريح وتسهيل مرور حامليها عند الحواجز؛
·تمكين عمال الإغاثة من اجتياز الحواجز في الضفة الغربية وغزة وبينهما بسرعةٍ بغية نقل ضحايا العنف (سواءٌ كن ضحايا فعليات أو محتملات) إلى أماكن آمنة. وإيجاد فئة خاصة من تصاريح المرور من أجل الفلسطينيين المهددة حياتهم بالخطر، ومن بينهم ضحايا العنف المستند إلى نوع الجنس، والسماح لهم بدخول إسرائيل أو عبور المعابر الحدودية الإسرائيلية إلى البلدان المجاورة طلباً للسلامة؛
·ضمان قدرة ضحايا العنف المستند إلى النوع الاجتماعي على الوصول إلى مؤسسات الحماية داخل إسرائيل عند الحاجة، بما في ذلك ملجأ ضحايا العنف في الناصرة والذي تستخدمه المواطنات العربيات في إسرائيل؛
·تسهيل حركة القضاة الفلسطينيين وعناصر الشرطة والأطباء الشرعيين والمحامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية داخل الضفة الغربية وغزة وإسرائيل بهدف الحصول على التدريب الذي يستهدف تطوير قدرات نظام العدالة الجزائية الفلسطيني، بما في ذلك التدريب المتعلق بالعنف المستند إلى النوع الاجتماعي. وتسهيل حركة هؤلاء الاختصاصيين بحيث يتمكنون من الوصول إلى زبائنهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
إلى مجموعة المانحين الدوليين
·تشجيع السلطة الفلسطينية على تبني التوصيات المذكورة أعلاه. وإثارة قضية ضعف استجابة السلطة الفلسطينية لمشكلة العنف ضد النساء والفتيات في أية اجتماعات رفيعة المستوى تُعقد مع مختلف الوزارات المعنية التي تخاطبها هذه التوصيات؛
·على المانحين الذين يدعمون المشاريع النسائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إيجاد آلية لتنسيق مساعداتهم الخاصة بالنوع الاجتماعي بغية تعزيز أثر هذه المساعدات ومنع ازدواجيتها؛
·دعم البرامج التي توفر الخدمات لضحايا العنف. ويجب أن تشتمل هذه الخدمات على ملاجئ النساء والرعاية الطبية والاستشارات ودورات محو الأمية والتدريب على مهارات العمل والمساعدات القانونية؛
·توفير فرص بناء القدرات للاختصاصيين المحليين وتشجيع استخدام الخبراء المحليين إلى أقصى درجة ممكنة في جميع المشاريع التدريبية التي يمولها المانحون. ويجب استشارة الخبراء المحليين وتحقيق مشاركتهم في جميع جوانب تصميم البرامج والمشاريع وتنفيذها لضمان ملاءمة وفاعلية المشاريع التي يمولها المانحون؛
·مساعدة السلطة الفلسطينية والمنظمات المحلية غير الحكومية على توفير تدريب أفضل للشرطة والمدعين العامين والأطباء والقضاة في مجال التعامل مع حالات العنف ضد المرأة؛
·دعم المشاريع الرامية إلى إعادة النظر في القوانين الحالية وإصلاحها لضمان توافقها مع التزامات السلطة الفلسطينية في احترام مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وعدم التمييز استناداً إلى الجنس أو النوع الاجتماعي، ومنح النساء والفتيات حق تكافؤ الفرص؛
·دعم تطوير البرامج التدريبية والأكاديمية بحيث تنتج اختصاصيين نفسيين أفضل خبرةً وتأهيلاً؛
·دعم توظيف استشاريين نفسيين-اجتماعيين مؤهلين في الجامعات والمدارس حيث يمكن للطالبات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري؛
·إدخال معلومات خاصة بالعنف الأسري ضمن النشاطات التدريبية في جميع برامج التدريب على النشاطات المولدة للدخل التي تستهدف النساء، وذلك لإطلاع المشاركات على أشكال الإغاثة والتدخل في حالات العنف الأسري وكيفية الحصول على الدعم في هذه الحالات.
كلمة الشكر
شارك في كتابة هذا التقرير كلٌّ من فريدة ضيف، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم حقوق المرأة لدى هيومن رايتس ووتش، ولوسي ماير، الباحثة في شؤون إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالاعتماد على الأبحاث الميدانية التي جرت في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2005.
وقام بمراجعة التقرير كلٌّ من جانيت وولش، نائبة مديرة قسم حقوق المرأة، وسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلاريسا بنكومو الباحثة في قسم حقوق الطفل، وويلدر تايلر المستشار القانوني ومدير السياسات، وجوزيف سوندرز نائب مدير قسم البرامج.
وقدمت هويدا بركات، المتطوعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساعدةً قيمة في البحث والترجمة. كما قدم المساعدة كلٌّ من إيرين ماهوني وتامارا رودريغز ريتشبرغ وطارق رضوان وأندريا هولي وفيتزروي هبكنز وخوسيه مارتينيز. وراجعت مسودة التقرير مع تقديم ملاحظات ذكية ومفيدة حولها كلٌّ من د. ناذرة شلهوب كيفوركيان ومها أبو دية شماس.
وتشكر هيومن رايتس ووتش بكل امتنان المساعدة التي قدمها كثيرٌ من الأشخاص والمسئولين الحكوميين والمؤسسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد كانت مساعدتهم عظيمة الفائدة في جهودنا لدراسة العنف ضد النساء والفتيات. ونوجه شكراً خاصاً إلى مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وإلى برنامج دعم وتأهيل المرأة في برنامج غزة للصحة النفسية، وإلى جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وإلى جمعية الدفاع عن الأسرة، وإلى د. ناذرة شلهوب كيفوركيان والمحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق.
ونود بشكلٍ خاص توجيه شكر حار إلى سعاد أبو دية وحليمة أبو صلب من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وإلى منال عواد مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة في برنامج غزة للصحة النفسية، وإلى اعتدال الجريري مديرة العمل الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وإلى المحامي علاء البكري، فقد ساهم كل منهم مساهمة كريمة بمعارفه الفريدة في ميدان العنف ضد النساء وساعدونا على إجراء عشرات المقابلات. كما قدم لنا د. عاصم خليل، مدير الأبحاث في معهد الحقوق بجامعة بير زيت، بالغة الأهمية عن نظام العدالة الجزائية الفلسطيني ونظام العدالة غير الرسمية.
وتخص هيومن رايتس ووتش بالشكر جميع النساء والفتيات الشجاعات ممن أبدين استعداداً للحديث معنا عما أصابهن من العنف، فلولاهن لما كان إعداد هذا التقرير ممكناً.
كما ننوه شاكرين بالمساعدة المالية من صندوق ليزبت روزينغ الخيري، ومن صندوق زيغريد روزينغ، ومن صندوق موريا، ومؤسسة أوك، ومؤسسة سترايساند، ومؤسسة سيلفرليف، ومؤسسة بانكي-لاروك، ومؤسسة شونر، ومؤسسة جاكوب وهيلدا بلاوشتاين، ومؤسسة شيكاغو للنساء، ومؤسسة عائلة غروبر، وأعضاء اللجنة الاستشارية في قسم حقوق المرأة.
ويود قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التنويه خاصةً بالدعم الكريم من جانب حسن المصري ورشا منصوري ومؤسسة بيرز.
[1] لمزيد من المعلومات، انظر ليزا حجار، "النزاع القضائي: نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة"، (بيركلي: منشورات جامعة كاليفورنيا، 2005)؛ ورجا شحادة، "قانون المحتل: إسرائيل والضفة الغربية"، (واشنطن العاصمة: معهد الدراسات الفلسطينية، 1988).
[2] في الفترة 1517 – 1917 كانت مناطق إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة خاضعة للحكم التركي كجزءٍ من الإمبراطورية العثمانية. لكن البريطانيين هزموا الجيش التركي عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى وسيطروا على هذه المناطق حتى عام 1948. وما زالت بعض القوانين والتشريعات العثمانية ساريةً إلى الآن، إضافةً إلى بعض الأنظمة والأوامر الملكية الصادرة عن الانتداب البريطاني.
[3] تميزت الانتفاضة الأولى بشكلٍ كبير بالتظاهرات الفلسطينية غير العنيفة، وبالإضرابات وحملات المقاطعة للإدارة الإسرائيلية ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان عمادها الشباب الفلسطيني الذي واجه الاحتلال الإسرائيلي متسلحاً بالحجارة. انظر مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط، "فلسطين وإسرائيل والنزاع العربي الإسرائيلي: عرض تمهيدي"،http://www.merip.org/palestine-israel_primer/toc-pal-isr-primer.html (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[4] أقرت الجامعة العربية إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بوصفها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني". وللمنظمة هيئة تشريعية هي المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك لجنة تنفيذية ينتخبها هذا المجلس. وتملك المنظمة عضويةً دائمة كمراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
[5] من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية غزة وأريحا أولاً لعام 1994، والاتفاقية المؤقتة حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995، واتفاقية الخليل عام 1997.
[6] وجه الرئيس الأمريكي بيل كلنتون دعوةً إلى كلٍّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات للقدوم إلى كامب ديفيد بالولايات المتحدة في يوليو/تموز 2000 من أجل استئناف المحادثات السلمية المتوقفة. واستمرت هذه القمة أسبوعين لكنها لم تفضِ إلى أية اتفاقية.
[7] اندلعت الانتفاضة الثانية في نهاية سبتمبر/أيلول 2000. وكان السبب المباشر لها زيارة أرييل شارون (الذي كان زعيم المعارضة آنذاك) موقعاً في القدس الشرقية يطلق عليه اليهود اسم جبل الهيكل ويسميه المسلمون الحرم الشريف، وهو أقدس المواقع الإسلامية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
[8] مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، "تحليل أولي: النتائج الإنسانية لمسار الجدار في الضفة الغربية كما تقرر في فبراير/شباط 2005"، فبراير/شباط 2005، (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[9] برنامج دراسات التنمية في جامعة بير زيت، "تقرير التنمية البشرية الفلسطيني، 2004"، http://home.birzeit.edu/dsp/pdhr/2004/ (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[10] في عام 1992 أنشأت حماس جناحاً عسكرياً باسم كتائب عز الدين القسام. ونفذت أول هجوم انتحاري في 16 أبريل/نيسان 1993. وبلغت هذه الهجمات ذروتها خلال الانتفاضة الثانية عندما أدت إلى قتل مئات من المدنيين الإسرائيليين. إن هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين جرائم ضد الإنسانية أدانتها هيومن رايتس ووتش في تقريرها "الاختفاء في لحظة: الهجمات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين"، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2001). وقد اغتالت إسرائيل حتى الآن كثيراً من قادة حماس وناشطيها كان أبرزهم مؤسس الحركة أحمد ياسين، وذلك في 22 مارس/آذار 2004، إضافةً إلى اغتيال عبد العزيز الرنتيسي في 17 أبريل/نيسان 2004. وفي 17 مارس/آذار 2005، وافقت حماس رسمياً على اتفاقية القاهرة التي توصلت إليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في قمة شرم الشيخ في فبراير/شباط 2005، وبذلك أعطت إشارةً تدل على رغبتها في دخول العملية السياسية الجارية. ومع هذه الموافقة، وافقت حماس على "فترة من التهدئة".
[11] انظر الخريطة على الصفحة 3.
[12] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها أبو دية شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 14 يونيو/حزيران 2006.
[13] مبادرة التقييم الاستراتيجي، "الاعتبارات التخطيطية للمساهمة الدولية في القطاع الأمني الفلسطيني؛ تقييم عملياتي من إعداد المجموعة الدولية للمساعدة الانتقالية"، يوليو/تموز 2005. http://www.strategicassessments.org/ontherecord/sai_publications/SAI-Planning_Considerations_for_International_Involvement_July_2005.pdf (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[14] في عام 2005 غيرت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون الانتخابات وزادت عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 إلى 132، بحيث يتم شغل نصف هذه المقاعد عن طريق التمثيل النسبي على أساس القوائم الحزبية الوطنية، وينتخب من يشغلون النصف الآخر من خلال الدوائر الانتخابية المحلية.
[15] يرد شرح هذه الحصة في الملاحظة رقم 70 أدناه.
[16] يصنف كلٌّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس كمنظمة إرهابية.
[17] يقدر البنك الدولي أن نسبة النمو للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستنخفض 27% عام 2006، كما ينخفض الدخل الفردي بمقدار 30% وتزداد البطالة قرابة الضعف تقريباً، أي من 23% عام 2005 إلى 40% عام 2006. انظر "البنك الدولي يتنبأ بسنواتٍ أسوأ للاقتصاد الفلسطيني"، رويترز، 13 سبتمبر/أيلول 2006. ويقول برنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة أن 70% من فلسطينيي غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ويتوقع زيادة عددهم بنسبة 30% خلال عامٍ واحدٍ فقط. انظر "70% من فلسطينيي غزة بحاجةٍ إلى المساعدات الغذائية الدولية للعيش"، وكالة أنباء الأمم المتحدة، 19 سبتمبر/أيلول 2006.
[18] مصدر سابق، رقم 13، ص 12.
[19] يمكن العثور على هذا الإعلان على الرابط: http://www.jmcc.org/politics/pna/plc/plcreform.htm (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[20] تملك معظم الفصائل الفلسطينية في الأراضي المحتلة جماعاتٍ مسلحة أو أجنحة عسكرية ملحقة بها (حماس: كتائب عز الدين القسام؛ فتح: كتائب شهداء الأقصى، والتنظيم؛ الجهاد الإسلامي: سرايا القدس؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: كتائب الشهيد أبو علي مصطفى). وتتألف الفصائل المسلحة الأخرى (مثل لجان المقاومة الشعبية) من أعضاء سابقين في عددٍ من الفصائل السياسية وأجنحتها العسكرية. كما أن بعض الجماعات غير المعروفة سابقاً تدعي المسؤولية عن بعض الحوادث المعزولة، ومنها كتائب عمر بن الخطاب والجيش الشعبي.
[21] تتألف قوات الأمن من قواتٍ عسكرية (قوات الأمن الوطني، والمخابرات العسكرية، وقوة الارتباط العسكرية، والقوة 17، والقوة البحرية/خفر السواحل)؛ ومن قوات أمن (المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوقائي، والقوات الخاصة، والأمن الخاص)؛ ومن أجهزة مدنية (الشرطة المدنية والدفاع المدني)؛ إضافةً إلى عدد من الدوائر (مكتب الأمن الخارجي، ومكتب مستشار الأمن القومي). المصدر السابق، رقم 13، ص 62 – 76.
[22] انظر المتابعات الميدانية والتصريحات الصحفية الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول "الفوضى الأمنية وإساءة استخدام الأسلحة"، على الموقع: http://www.pchrgaza.org/files/weapon/english/weapon.htm، ومن هذه التقارير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستنكر بشدة مهاجمة المؤسسات الدولية والأجانب في غزة"، 15 مارس/آذار 2006، و"تواصل الهجمات ضد المسئولين والمؤسسات الحكومية"، 28 مايو/أيار 2006 (تمت زيارة الموقع في 30 مايو/أيار 2006).
[23] يقوم المجتمع الفلسطيني، كما هي الحال في معظم أنحاء العالم العربي، على الانتماء إلى عائلةٍ ممتدةٍ قوية أو إلى عشيرة تضم عدداً من هذه العائلات الممتدة التي تحمل نفس النسبة وتنحدر من جدٍّ مشترك. وغالباً ما يكون زعماء العشائر أوسع نفوذاً من المسئولين المنتخبين أو المعينين ومن قادة الأجهزة الأمنية وكبار المسئولين، وهم يستولون أحياناً على سلطات هؤلاء المسئولين. انظر السلطة الوطنية الفلسطينية، "المجتمع الفلسطيني"، http://www.pna.gov.ps/subject_details2.asp?DocId=161 (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)، وانظر أيضاً شيلا إ. روثنبرغ، "نظرة إلى الكتابات الأنثروبولوجية حول العشيرة الفلسطينية ووضع المرأة"، مجلة الدراسات العربية والإسلامية، المجلد 2، 1998 – 1999، http://www.uib.no/jais/v002/rothen.pdf (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[24] تقرير مبادرة التقييم الاستراتيجي، المصدر السابق، رقم 13.
[25] المصدر السابق. وطبقاً لدليل المعلومات العالمية الخاص بالمخابرات المركزية الأمريكية، يقارب سكان الضفة الغربية 2.5 مليوناً، بينما يصل سكان غزة 1.5 مليوناً تقريباً، www.cia.gov/cia/publications/factbook (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[26] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ضابط شرطة فلسطيني (تم حجب اسمه)، أريحا، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[27] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، GCMHP، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[28] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمود رحال، مدير كلية الشرطة بأريحا، أريحا، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[29]أنظر المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين، "حالة حقوق المواطنين الفلسطينيين خلال عام 2004، التقرير السنوي العاشر"، ص 73 – 74www.piccr.org/report/annual04e.html (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)
[30] المصدر السابق.
[31] انظر غلين إ. روبنسون، "سياسة الإصلاح القانوني في فلسطين"، مجلة دراسات فلسطينية، المجلد 27، العدد 1 (خريف 1997)، ص 51 – 60.
[32] هيومن رايتس ووتش، "العدالة المهددة: الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان في النظام القضائي الفلسطيني"، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2001).
[33] أنشئ مجلس القضاء الأعلى بالمرسوم الرئاسي رقم 29 لعام 2000.
[34] أقيمت هذه المحكمة عام 1995 في غزة بموجب مرسوم رئاسي من أجل النظر في قضايا تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
[35] في 27 يوليو/تموز 2003 أصدر وزير العدل السابق قراراً خطياً بإنهاء عمل محاكم أمن الدولة، بما فيها محكمة أمن الدولة العليا، وبنقل القضايا التي تنظر فيها إلى المحاكم العادية. لكن القرار الوزاري لم يطبق بشكلٍ كامل. فعلى سبيل المثال، لم تجر إعادة محاكمة أي شخص ممن أدانتهم محكمة أمن الدولة العليا أمام القضاء العادي؛ كما أن الرئيس محمود عباس صادق في 12 يونيو/حزيران 2005 على إعدام أربعة أشخاص كانت محكمة أمن الدولة العليا هي من أصدر الحكم على أحدهم في غزة يوم 11 سبتمبر/أيلول 2000. وهذه المعلومات مستقاة من عاصم خليل، "الإطار القانوني للإدارة الأمنية الفلسطينية"، إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني، مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، 2006.
[36]مصدر سابق، رقم 32.
[37] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية حليمة أبو صلب، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رام الله، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[38] المعلومات المتعلقة بنظام المحاكم مأخوذة من التقارير السنوية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ وهي متوفرة على الرابط:www.pchrgaza.org؛ ومن المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين، وهي متوفرة على الرابط:www.piccr.org؛ وكذلك من نيثان براون، "الهيكليات القضائية العربية، دراسة مقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"،http://www.pogar.org/publications/nbrown/palestine.html(تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)
[39] المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين، "تقرير عن الوضع الراهن للسلطة القضائية والنظام القضائي عام 2005"، مارس/آذار 2006، ص 47 [موجود لدى هيومن رايتس ووتش].
[40]مصدر سابق، رقم 26، ص 65.
[41]مصدر سابق، رقم 39.
[42] المصدر السابق.
[43] رغم إقرار الرئيس عباس قانون إنشاء المحكمة الدستورية (القانون رقم 3 لعام 2006) في أوائل 2006، فقد دار جدلٌ حول طريقة إقرار هذا القانون بحيث بقي وضعه القانوني غير واضح ولم يتم إنشاء المحكمة حتى الآن.
[44] المصدر السابق، ص 71.
[45] بريد إلكتروني من عاصم خليل، الباحث المساعد في جامعة بير زيت ومدير الأبحاث في المعهد القانوني، 24 يونيو/حزيران، 2006.
[46] ورد لدى عاطف سعد، "أجراس الإنذار تُقرع"، تقرير فلسطين، المجلد 11، العدد 50، 19 يونيو/حزيران 2005، http://www.palstinereport.org/art.php?article=806 (تمت زيارة الرابط في 22 سبتمبر/أيلول 2006).
[47] المصدر السابق.
[48] المجلس الوطني الفلسطيني هو سلف المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد سنّ 21 "قانوناً" لا تزال ساريةً حتى الآن.
[49] مازال يسري في الضفة الغربية وقطاع غزة (على الترتيب) قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وقانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937.
[50] قانون العقوبات المصري (58/1937)، المادة 274.
[51] قانون العقوبات المصري (58/1937)، المادة 277.
[52] المصدر السابق.
[53] تقول المادة 237 من قانون العقوبات المصري: "يعاقب كل من فاجأ زوجته في حالة زنا فقتلها في نفس المكان مع من زنى بها بالاعتقال بدلاً من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 234 [الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة] و 236 [الأشغال الشاقة أو الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات]".
[54] انظر تقرير "الحق"، "ملاحظات مقدمة إلى المجتمع المدني الحقوقي حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني". الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش.
[55] يفرض مشروع القانون عقوبة الحبس ثلاث سنوات على هذه الجرائم بدلاً من عقوبة الحبس مع الأشغال لمدة لا تقل عن سبع سنوات والتي يفرضها قانون العقوبات الأردني (16/1960).
[56] الحق، "ملاحظات مقدمة إلى المجتمع المدني الحقوقي حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني". الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش.
[57] مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، "النساء والرجال في فلسطين – قضايا وإحصائيات، 2005"، ص 41. http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/books/booksView.aspx?tabID=0&lang=en&ItemID=1&mid=11239 (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)
[58] المصدر السابق، ص 43.
[59] المصدر السابق، ص 9.
[60] المادة 10 من قانون العمل الفلسطيني رقم 4، تاريخ 29/3/2000 http://www.aida-jer.org/law/law17.html (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)
[61] فريدم هاوس، "حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المواطَنة والعدالة – فلسطين (السلطة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل)"،(تمت زيارة الرابط في 22 أغسطس/آب 2006).
[62] المصدر السابق.
[63]مصدر سابق، رقم 9.
[64]مصدر سابق، رقم 57، ص 51 – 52.
[65] المصدر السابق.
[66]مصدر سابق، رقم 57، ص 23.
[67]مصدر سابق، رقم 57، ص 26 – 27.
[68] نسبة تسرب الأولاد هي 3.6%، ونسبة تسرب البنات هي 2.3%. مصدر سابق، رقم 57، ص 29.
[69]مصدر سابق، رقم 9.
[70] ينص قانون الانتخابات المحلية رقم 5 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2004 على وجوب إعطاء النساء موقعين في كل قائمة انتخابية للمجالس المحلية. ويحتفظ القانون أيضاً بمقعدين للنساء في المجالس المحلية (ويتألف كل منها من 9 إلى 13 عضواً). أما قانون الانتخابات المحلية رقم 9 لعام 2005 فينص على وجود امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى على القائمة الوطنية لكل حزب، إضافةً إلى امرأة واحدة على الأقل في الأسماء الأربعة التالية، وامرأة واحدة في كل خمسة أسماء في القسم الباقي من القائمة، وهذا ما يضمن وجود نحو 20% من النساء بين المرشحين. وينتخب نصف أعضاء المجلس عبر نظام تمثيل نسبي يقوم على القوائم الوطنية، بينما ينتخب النصف الآخر من خلال قوائم في مختلف المناطق بمرشح واحد. وفي انتخابات 2006، وصلت 17 امرأة إلى المجلس عبر القوائم الوطنية الخاضعة لنظام الحصة القانوني، بينما لم تنتخب أية امرأة من خلال القوائم المحلية ذات المرشح الوحيد. انظر "قاعدة البيانات العالمية حول الحصص الانتخابية النسائية"، (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006). وللإطلاع على التاريخ المفصل لعمل النساء من أجل الحصول على حصص انتخابية، انظر أميرة خص، "إرث عرفات النسوي"، هاآرتس [النسخة الإلكترونية الإنكليزية]، 12 أبريل/نيسان 2005. (تمت زيارة الرابط في 15 مايو/أيار 2006).
[71]مصدر سابق، رقم 9.
[72] المصدر السابق. لمزيدٍ من المعلومات عن تاريخ انتخابات المجالس المحلية والتعيين فيها في الضفة الغربية وغزة، وخاصةً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، انظر عبد الناصر مكّي، "الأبعاد الانتخابية في الحكم المحلي في فلسطين"،www.mofa.gov.ps/articals/pdf_files/electoral.pdf (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[73]انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني الخاص بـ "التوزع النسبي للإناث المتزوجات (في سن 18 فما فوق) تبعاً للشخص الذي يتخذ قرار الزواج، وذلك حسب المنطقة ونمط الحي"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/gender/oship_3b.aspx (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).
[74] المصدر السابق.
[75] نهلة عبدو، "المرأة والانتفاضة: النوع الاجتماعي والطبقة والتحرر الوطني"، العرق والطبقة 32، 4 (1991)، ص 19 – 34؛ ريتا جياكامان وبيني جونسون، "المرأة الفلسطينية: بناء المتاريس وتحطيم الحواجز"، في "الانتفاضة: الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي"، من إعداد زاخاري لوكمان وجويل بينين (بوسطن: منشورات ساوث إند بريس، 1989)، وإصلاح جاد، "من الصالونات إلى اللجان الشعبية: المرأة الفلسطينية 1919 - 1989" في "الانتفاضة: فلسطين على مفترق طرق"، إعداد جمال ر. نصر وروجر هيكوك (نيويورك: منشورات بريجر، 1990).
[76] انظر ثريا أنطونيوس، "القتال على جبهتين: أحاديث مع نساء فلسطينيات"، مجلة دراسات فلسطينية 9، 3 (ربيع 1979)، ص 26 – 45؛ وسعاد الدجاني، "بين التحرر الاجتماعي والتحرر الوطني: حركة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين" في "النساء والاحتلال الإسرائيلي: سياسات التغيير"، إعداد تامار مير (نيويورك: روتلدج، 1994).
[77] انظر ريما حمامي، "برلمان النموذج النسائي وإصلاح قانون الأحوال الشخصية"، سبتمبر/أيلول 2000، ص 5 – 6،www.ids.ac.uk/ids/civsoc/final/palestine/pal1.html (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[78] لمزيد من المعلومات، انظر الفصل 3.
[79]مصدر سابق، رقم 77
[80] اللجنة الوزارية لدى السلطة الفلسطينية من أجل تعزيز وضع المرأة، "وضع المرأة الفلسطينية بعد خمس سنوات من مؤتمر بيجين 1995 - 2000"، 2002، ص 31، http://home.birzeit.edu/wsi/All%20Publicaitons/files/Gov%20Report%20on%20Women%20Status.pd f (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[81] المصدر السابق.
[82] المصدر السابق.
[83] في عام 1998، طلب الرئيس عرفات من قاضي القضاة تيسير التميمي صياغة قانون الأسرة الفلسطيني الموحد.
[84] قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000)، S/RES/1325(2000)، http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/7f1629999f97c0a8c1256a0900302211?Opendocument (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[85] "الهيئة الدولية للنساء من أجل سلام فلسطيني-إسرائيلي عادل ودائم"، تصريح صحفي صادر عن يونيفيم، 28 يوليو/تموز 2005، www.peacewomen.org/resources/OPT/IWC2005.html (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).
[86] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، برنامج غزة للصحة النفسية، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. والمنظمات الفلسطينية المشاركة هي: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الضفة الغربية، وبرنامج دعم وتأهيل المرأة، وبرنامج غزة للصحة النفسية.
[87] المصدر السابق.
[88] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أهيلة شومر، مديرة مؤسسة "سوا" في القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[89] خطط عمل وزارة شئون المرأة للفترة 2005 – 2007، صدرت في سبتمبر/أيلول 2004. الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش.
[90] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روز شمالي، طاقم شؤون المرأة، رام الله، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[91] انظر المقالة الافتتاحية في النشرة الإخبارية لطاقم شؤون المرأة، "صوت النساء"، رقم 227، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2005، ص 1 [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش]. افتتاحية في النشرة الإخبارية لشؤون المرأة.
[92] السلطة الوطنية الفلسطينية، مكتب الإحصاء المركزي، استطلاع العنف الأسري 2005، فبراير/شباط 2006، ص 24، [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].
[93] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اعتدال الجريري، مديرة العمل الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، رام الله، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[94] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبير خير (اسم مستعار)، غزة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[95] "العنف.ضد المرأة في فلسطين: استطلاع للرأي العام"، سبتمبر/أيلول 2002؛ كما ورد في "التكامل بين الحقوق الإنسانية للنساء ومنظور النوع الاجتماعي: العنف ضد النساء"، من تقرير إرتورك (انظر الملاحظة رقم 74).
[96] المصدر السابق.
[97] يعيش في الخليل قرابة 150,000 فلسطيني، ويعيش 35 ألفاً منهم في منطقة H2 التي يسكنها أيضاً قرابة 500 مستوطن إسرائيلي؛ وهي الحالة الوحيدة لوجود مستوطنين في قلب مدينة فلسطينية. وهذا هو سبب عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل مدينة الخليل، فهو يحتفظ بوجودٍ أمنيٍّ فيها للسيطرة على منطقة H2، وذلك بموجب اتفاقية الخليل لعام 1997.
[98] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عوني السماري، مدير شرطة الخليل، الخليل، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[99] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها أبو دية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[100] إن قانون العقوبات الأردني (16/1960) والمصري (58/1937) مطبقان في الضفة الغربية وغزة على الترتيب.
[101] المصدر السابق.
[102]- "تنامي العنف الداخلي ضد النساء الفلسطينيات" ميدل ايست تايمز،20 سبتمبر/أيلول 2002
[103] يعزو المعلقون هذه الزيادة في العنف إلى جملةٍ من العوامل. وتشير بعض الجماعات النسائية الفلسطينية إلى ازدياد الفقر والبطالة في الفترة الأخيرة مما جرّد الرجل من دوره كمعيل للأسرة، إضافةً إلى ما يعيشه الرجال الفلسطينيون من إحباط وإذلال على يد الجيش الإسرائيلي عند الحواجز وأثناء اعتقالهم واحتجازهم، وكذلك حقيقة أن الرجل غالباً ما لا يستطيع التنفيس عن هذا الإحباط إلا في تعامله مع أفراد أسرته خاصةً وأن الرجل العاطل عن العمل يمضي وقتاً أطول في المنزل وأن الأسرة كلها تظل محبوسةً في بيتها لأيامٍ وأسابيع عندما تفرض إسرائيل حظر التجول. انظر كامل المنسي، "العنف الأسري ضد النساء في قطاع غزة: انتشاره وأسبابه وطرق معالجته"، (غزة: مركز شئون المرأة، 2001). شملت الدراسة 750 أسرةً في غزة وتضمنت مقابلة 670 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً.
[104] المادة 33، القانون (16/1960)، [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].
[105] المصدر السابق.
[106] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.
[107] المادة 33، القانون (16/1960)، [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].
[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية غدير الشيخ، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، طولكرم، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[109]المصدر السابق
[110] المصدر السابق.
[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي علاء البكري، رام الله، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[112] المصدر السابق.
[113]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ يوسف الديس، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، رام الله، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية رندا حمد، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، طولكرم، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[115] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم إسماعيل (اسم مستعار)، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[116] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم إسماعيل (اسم مستعار)، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[117]استطلاع العنف الأسري الذي أجراه مكتب الإحصاء الفلسطيني عام 2005: نتائج أولية [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].
[118]مكتب الإحصاء الفلسطيني، "استطلاع الصحة النفسية للأطفال، 2004"، ص 82 – 83، [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].
[119] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى ضحايا العنف الأسري [تم حجب اسمها]، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[120] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريمة أحمد [تم حجب مكان وجودها]، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[121] المادة 29 (4) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل الذي جرى إقراره في 18 مارس/آذار 2003. يمكن الحصول على نسخة كاملة من هذا القانون على الرابط: http://213.244.124.245/mainleg/14138.htm (تمت زيارة الرابط في 3 مايو/أيار 2006).
[122]المادة 62، القانون 16/1960 [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].
[123]تنص المادة 286 خاصةً على: "يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة". لمزيد من المعلومات، انظر الفقرة الفرعية الخاصة بالسفاح في الفصل الرابع من هذا التقرير.
[124] المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال/قسم فلسطين، "استخدام الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة: نظرة إلى الأطفال الجنود"، يوليو/تموز 2004، ص 13، http://www.dci-pal.org/english/Display.cfm?DocId=277&CategoryId=8 (تمت زيارة الرابط في 28 أبريل/نيسان 2006).
[125]انظر أمانة سر خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة للوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران 2005، ص 14.
[126]المصدر السابق، ص 85.
[127] يكون من حق السلطات في هذه الحالات إبعاد الطفل عن المنزل.
[128]أمانة سر خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة للوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران 2005، ص 12.
[129] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.
[130]المصدر السابق.
[131]لمزيدٍ من المعلومات، انظر الفقرة الفرعية الخاصة بقتل النساء تحت اسم "الشرف".
[132] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.
[133]ناذرة شلهوب كيفوركيان، "فرض اختبار العذرية: وسيلةٌ لإنقاذ الحياة أم ترخيصٌ بالقتل؟"، العلوم الاجتماعية والطب، المجلد 60 (2005)، ص 1192.
[134] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[135] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العاملة الاجتماعية مها صباغ، رام الله، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[136] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[137] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي هاني الناطور، محكمة الاستئناف، رام الله، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005.
[138] الباب السابع من القانون (16/1960)، الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].
[139] المصدر السابق، المادة 301.
[140] المصدر السابق، المادة 308. انظر أيضاً مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، "تقرير تحليل الفجوات بشأن وضع المرأة الفلسطينية ضمن سياق اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تقرير موجز"، http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=278 (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).
[141] المصدر السابق، المادة 308.
[142] رغم إلغاء هذا القانون من قبل مجلس الشعب المصري عام 1999، فإن غزة تواصل تطبيق النسخة غير المعدلة منه. انظر أيضاً مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، "تقرير تحليل الفجوات".
[143] تقول المادة 321 من قانون العقوبات الأردني (16/1960): " كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".ويكون الاستثناء من هذا الحكم في الضفة الغربية في حالة تعرض صحة الأم الحامل أو حياتها إلى الخطر. أما قانون العقوبات المصري لعام 1937 (المواد 260 - 264) الساري في غزة فهو يحظر الإجهاض دون استثناء.
[144] انظر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، "تقرير تحليل الفجوات".
[145] انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي، "المجرمين المدانين في سجون الضفة الغربية حسب الشهر ونوع الجريمة، 2004"،http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crvd04.aspx، و"المجرمين المدانين في سجون قطاع غزة حسب الشهر ونوع الجريمة، 2004"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crvd05.aspx.
[146] انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي، "الأشخاص المحتجزون في الأراضي الفلسطينية حسب الشهر ونوع الجريمة، 2004"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crvd03.aspx، (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).
[147] انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي، "الجرائم المبلغ عنها في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة ونوع الجريمة، 1996 - 2003"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crv01.aspx، (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).
[148] انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي، "المجرمون المحكومون في السجون الفلسطينية حسب المنطقة ونوع الجريمة، 1996 - 2003"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crv04.aspx، (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).
[149] جاء في المادة 292 من الباب السابع "الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة": "من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات".
[150] انظر المادة 321 من قانون العقوبات الأردني (16/1960) والمواد 260 – 264 من قانون العقوبات المصري لعام 1937.
[151] المادة 286، الباب السابع الخاص بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، القانون (16/1960).
[152] المصدر السابق.
[153] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية حليمة أبو صلب، المركز النسائي للمساعدة والاستشارة القانونية، 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
[154] المصدر السابق.
[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.
[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنان الشريف (اسم مستعار)، نابلس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[157] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ندى عمر (اسم مستعار)، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[158]توجد نسخة من التقرير لدى هيومن رايتس ووتش.
[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعاد أبو دية، رئيسة الوحدة الاجتماعية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[160]ناذرة شلهوب كيفوركيان، "رسم خريطة مشهد قتل النساء في المجتمع الفلسطيني وتحليلها"، (القدس: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2004).
[161]المصدر السابق.
[162] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها أبو دية، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[163] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعاد أبو دية، رئيسة الوحدة الاجتماعية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[164]المصدر السابق.
[165]انظر سُريا سرهادي نلسون، "امرأة تقتل ابنتها المغتصبة لاستعادة شرف العائلة"، نايت ريدر نيوزبيبرز، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2003؛ ومنظمة العفو الدولية، "النزاع والاحتلال والبطريركية: نساءٌ يحملن العبء"، مارس/آذار 2005.
[166]المصدر السابق.
[167] مقابلة هيومن رايتس ووتش مها أبو دية شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 14 يونيو/حزيران 2006.
[168]يمكن العثور على جذور هذا الموقف فيما يتضمنه قانون نابليون من "جرائم الانفعال"، وهو القانون الذي دخل المنطقة من خلال العثمانيين. انظر لمى أبو عودة، "جرائم الانفعال وبنيتها في المجتمعات العربية"، في كتاب "النساء والمسألة الجنسية في المجتمعات الإسلامية"، من تحرير بينار إلكراكان (استانبول: نساءٌ من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة ـ نيوديز، 2000)، ص 363 – 380. ولمزيدٍ من المعلومات عن تخفيض العقوبات في جرائم "سورة الغضب" وسوء استخدام هذه القوانين في حالات "جرائم الشرف"، انظر هيومن رايتس ووتش، "تكريم القتلة: رفض إقامة العدالة في "جرائم الشرف" في الأردن"، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2004).
[169] تقول المادة 340 من القانون (16/1960):
يستفيد من العذر المحل من فوجئ بزوجته أو إحدى المحرمات حال تلبسها بجريمة الزنا مع شخصٍ ما فقتلها أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.
وفي محاولةٍ من الأردن لجعل هذا القانون غير متحيّز لأحد الجنسين، أضيفت إليه عام 2001 فقرة تمنح الأنثى التي تهاجم زوجها نفس التخفيف من العقوبة. لكن هذا التعديل غير نافذٍ في الضفة الغربية.
[170] تقول هذه المادة: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، المادة 98 من القانون (16/1960).
[171] تقول المادة 237 من قانون العقوبات المصري:
يعاقب كل من فاجأ زوجته في حالة زنا فقتلها في نفس المكان مع شريكها بالاعتقال بدلاً من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 234 [الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة] و 236 [الأشغال الشاقة أو الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات].
[172]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.
[173] المصدر السابق.
[174] المصدر السابق.
[175] ناذرة شلهوب كيفوركيان، "نظام العدالة الجزائية الفلسطيني وقتل النساء: هل ثمة بذور للتغيير في سياق بناء الدولة؟"، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 36، العدد 3 (2002)، ص 592.
[176] انظر المادة 99 من القانون (16/1960).
[177] مصدر سابق، رقم 175، ص 593.
[178] "فلسطينيات يحتججن ضد جرائم 'الشرف'"، 7 مايو/أيار 2005.
[179] المصدر السابق.
[180] المصدر السابق.
[181] انظر مثلاً كريس ماك جريل، "القتل باسم شرف العائلة"، الجارديان، 23 يونيو/حزيران 2005، (تمت زيارة الرابط في 5 مايو/أيار 2006)؛ لارا سختيان، "جريمة شرف تؤكد تزايد الانقسام بين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين وتثير القلق من تزايد النزعة الطائفية"، تشارلستون جازيت، 6 سبتمبر/أيلول 2005، ص: 3 أ؛ كارولاين ويلر، "الثمن الذي تدفعه المرأة لقاء عصيانها"، ذا كلوب آند ميل، 16 مايو/أيار 2005.
[182] دونالد ماسنتير، "حماس تعترف بقيام مسلح بقتل امرأة في جريمة شرف"، الإندبندنت، 14 أبريل/نيسان 2005.
[183] المصدر السابق.
[184] المصدر السابق.
[185] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، برنامج غزة للصحة النفسية، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
[186]ناذرة شلهوب كيفوركيان، "نحو تعريف ثقافي للاغتصاب: معضلات التعامل مع ضحايا الاغتصاب في المجتمع الفلسطيني"، المنتدى الدولي للدراسات النسائية، مجلد 22، رقم 2 (1999)، ص: 176.
[187]لمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة الفرعية في الفصل 4 الخاصة ببيت الفتيات في بيت لحم.
[188] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اعتدال الجريري، مديرة العمل الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، رام الله، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى العاملات الاجتماعيات (تم حجب اسمها)، نابلس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[190] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى العاملات الاجتماعيات (تم حجب اسمها)، نابلس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[191] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعاد أبو دية، رئيسة الوحدة الاجتماعية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[192] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى العاملات الاجتماعيات (تم حجب اسمها)، نابلس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[193] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العاملة الاجتماعية سعاد الشتوي، جمعية الدفاع عن الأسرة، نابلس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. إن كل من قانوني العقوبات الأردني والمصري النافذين في الضفة الغربية وغزة على الترتيب يجرّمان الإجهاض في جميع الأحوال إلا عندما تكون صحة الأم أو حياتها معرضةً للخطر. والإجهاض غير قانوني في حالات الاغتصاب والسفاح.
[194] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم إسماعيل (اسم مستعار)، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[195] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قائد الشرطة علاء حسني، رام الله، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005.
[196] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمود رحال، مدير كلية الشرطة بأريحا، أريحا، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[197] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامٍ فلسطيني [تم حجب اسمه]، رام الله، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[198] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عاملة اجتماعية [تم حجب اسمها]، نابلس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[199] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمود رحال، مدير كلية الشرطة بأريحا، أريحا، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[200]المصدر السابق.
[201] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قائد الشرطة علاء حسني، رام الله، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005.
[202] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيسير منصور (أبو العز) قائد شرطة رام الله، رام الله، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[203]المصدر السابق.
[204] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع توفيق منصور (أبو محمد) مدير سجن نابلس، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[205]لمزيدٍ من المعلومات عن الملاجئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انظر الفقرة الفرعية بعنوان "عدم كفاية ملاجئ ضحايا العنف" ضمن الفصل الخامس.
[206] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ريم حمد (اسم مستعار)، نابلس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[207] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها أبو دية شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 14 يونيو/حزيران 2005.
[208] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أهيلة شومر، مديرة مؤسسة "سوا" في القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[209] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رحمة منصور، مديرة تنمية الاتصالات، مركز بيسان للبحوث والتنمية، رام الله، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[210]المصدر السابق.
[211]انظر محمد م. حاج يحيى، "تعامل الأطباء الفلسطينيين مع حالات الإساءة إلى الزوجات"، (رام الله: مركز بيسان للبحوث والتنمية، 2003).
[212]المصدر السابق.
[213]مصدر سابق، رقم 211، ص 79.
[214]مصدر سابق، رقم 211، ص 72.
[215]مصدر سابق، رقم 211، ص 79.
[216]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. حسني عطاري، مدير مستشفى رام الله، رام الله، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[217] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية حليمة أبو صلب، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رام الله، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[218]المصدر السابق.
[219]المصدر السابق.
[220]المصدر السابق.
[221]المصدر السابق.
[222] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد العاملين الاجتماعيين [تم حجب اسمه]، نابلس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[223]وافقت الجمعية العامة للاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد على هذا القرار في المؤتمر الدولي الخامس عشر للتوليد وأمراض النساء، كوبنهاجن، الدانمرك، 3 – 8 أغسطس/آب 1997. انظر http://web.amnesty.org/pages/health-ethicsfigovaw-eng(تمت زيارة الرابط في 17 مايو/أيار 2006).
[224]ناذرة شلهوب كيفوركيان، "سياسات الكشف عن الإساءة الجنسية بحق الإناث: دراسة حالة عن المجتمع الفلسطيني"، الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم، المجلد 23، العدد 12، ص: 1282.
[225] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.
[226]المصدر السابق.
[227]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف نصر الله، رئيس النيابة في الضفة الغربية سابقاً، رام الله، 22 مايو/أيار 2006.
[228]المصدر السابق.
[229]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. جلال عبد الجبار، المدير السابق لمعهد الطب الشرعي في أبو ديس، بيت لحم، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[230]المصدر السابق.
[231]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. جلال عبد الجبار، المجير السابق لمعهد أبو ديس للطب الشرعي. 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2005
[232]المصدر السابق.
[233]المصدر السابق.
[234]المصدر السابق.
[235] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ريم حمد (اسم مستعار)، نابلس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[236] يؤكد د. كريغ لاركن، أستاذ طب الطوارئ في المركز الطبي بجامعة تكساس الجنوبية الغربية، وخبير في ميدان التوثيق الطبي الشرعي في قضايا الاعتداء من جانب الشريك الجنسي، أنه ما من اختبار موثوق للعذرية. ويمكن أن يتمزق غشاء البكارة بفعل جملة واسعة من النشاطات المألوفة، كما أن سلامته لا تعني عدم وقوع جماع. رسالة بالبريد الإلكتروني من د. كريغ لاركن إلى هيومن رايتس ووتش، 14 فبراير/شباط 2006.
[237]المصدر السابق.
[238]تستند المعلومات الواردة في هذه الفقرة على نتائج دراسة أجراها عام 2005 معهد الحقوق في جامعة بير زيت بالضفة الغربية، إلا عند الإشارة إلى غير ذلك. وتحمل الدراسة عنوان: "العدالة غير الرسمية: حكم القانون وتسوية النزاعات في فلسطين"، وسوف تصدر عن المعهد المذكور. وقد حصلت هيومن رايتس ووتش على هذه المعلومات عبر لقائها مع منسقة الدراسة دعاء منصور، رام الله، 7 ديسمبر/كانون الأول 2005.
[239]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دعاء منصور، وحدة القانون والمجتمع، جامعة بير زيت، رام الله، 7 ديسمبر/كانون الأول 2005.
[240]يقول كثيرٌ من الأشخاص البارزين في العشائر أن مصادر القانون العشائري هي التقاليد القديمة (منذ ما قبل الإسلام)، والشرع الإسلامي، والقانون المدني. انظر ناذرة شلهوب كيفوركيان، "رسم خريطة مشهد قتل النساء في المجتمع الفلسطيني وتحليلها"، (القدس: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2004)، ص: 49.
[241]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دعاء منصور، وحدة القانون والمجتمع، جامعة بير زيت، رام الله، 7 ديسمبر/كانون الأول 2005.
[242]المصدر السابق.
[243]مصدر سابق، رقم 241، ص 48.
[244]المصدر السابق.
[245]المصدر السابق، ص 53.
[246] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تيسير منصور (أبو العز) قائد شرطة رام الله، رام الله، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[247] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، برنامج غزة للصحة النفسية، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
[248]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عاملة اجتماعية (تم حجب اسمها)، رام الله، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[249]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غسان فرمند وعاصم خليل، معهد الحقوق بجامعة بير زيت، رام الله، 28 يوليو/تموز 2006.
[250]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غسان فرمند وعاصم خليل، معهد الحقوق بجامعة بير زيت، رام الله، 28 يوليو/تموز 2006.
[251]انظر توباياس كيلي، "دراسة رقم 41، المدخل إلى العدالة: النظام القانوني الفلسطيني وتجزؤ سلطة القسر"، مركز أبحاث التنمية، مدرسة لندن للاقتصاد، مارس/آذار 2004.
[252]المصدر السابق. يوجد القانون الأصلي باللغة العربية لدى هيومن رايتس ووتش.
[253]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لينا عبد الهادي، المستشار القانوني لدى محافظ نابلس، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[254]المصدر السابق.
[255] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اعتدال الجريري، مديرة العمل الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، رام الله، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[256]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لينا عبد الهادي، المستشار القانوني لدى محافظ نابلس، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[257]المصدر السابق.
[258]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، برنامج غزة للصحة النفسية، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[259]مصدر سابق، رقم 253.
[260]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فريد الجلاد، وزير العدل السابق، رام الله، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[261] المصدر السابق.
[262]منذ ذلك الحين أبلغ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هيومن رايتس ووتش بافتتاح ملجأ ثانٍ بدأ يعمل بنجاح عام 2006.
[263]تستند جميع المعلومات في هذه الفقرة على ما زودنا به توفيق منصور، مدير جناح النساء في سجن نابلس، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[264] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، برنامج غزة للصحة النفسية، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[265] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية غدير الشيخ، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، طولكرم، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[266] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جهاد أبو العين، مديرة بيت الفتيات في بيت لحم، بيت لحم، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[267] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، برنامج غزة للصحة النفسية، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[268] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ديانا مبارك، وزارة الشؤون الاجتماعية، العيزرية، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[269]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها أبو دية شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 14 يونيو/حزيران 2006.
[270]مصدر سابق، رقم 269.
[271] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعاد أبو دية، رئيسة الوحدة الاجتماعية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[272] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمل الأحمد، مديرة ملجأ نابلس، نابلس، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[273]المصدر السابق.
[274]المصدر السابق.
[275]المصدر السابق.
[276] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اعتدال الجريري، مديرة العمل الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، رام الله، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[277]مصدر سابق، رقم 273
[278] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة من نزيلات ملجأ نابلس [تم حجب اسمها]، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[279] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جهاد أبو العين، مديرة بيت الفتيات في بيت لحم، بيت لحم، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[280]المصدر السابق.
[281] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن أبو لبدة، وزير الشئون الاجتماعية، رام الله، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005.
[282]المصدر السابق.
[283]المصدر السابق.
[284]المصدر السابق.
[285]المصدر السابق.
[286] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اختصاصية اجتماعية في بيت الفتيات ببيت لحم، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[287] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جهاد أبو العين، مديرة بيت الفتيات في بيت لحم، بيت لحم، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[288] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اختصاصية اجتماعية في بيت الفتيات ببيت لحم، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
[289]تم إقرار القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في 18 مارس/آذار 2003. وتوجد نسخة كاملة من القانون على الرابط: http://213.244.124.245/mainleg/14138.html(تمت زيارة الرابط في 3 مايو/أيار 2006).
[290]انظر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، "الآثار القانونية لإقامة الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.html(تمت زيارة الرابط في 22 أغسطس/آب 2006)، الفقرة 112.
[291]المادة 2، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة، القرار 34/180، وثيقة الأمم المتحدة أ/34/64، دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1980.
[292]المصدر السابق، المادة 5 (أ).
[293]المصدر السابق، المادة 16 (1).
[294]المصدر السابق، المادة 16 (1) (ب).
[295]لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، فقرة 24 (r) (ii).
[296]لجنة حقوق الطفل، ملاحظة عامة رقم 4 (الجلسة الثالثة والثلاثون، 2003): صحة المراهقين ونموهم في ضوء اتفاقية حقوق الطفل، أ/59/41 (2004)، الفقرة 24.
[297]أنظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 2؛ والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، المادتان 3 و26؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 7.
[298]لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، العنف ضد النساء، وثيقة الأمم المتحدة أ/47/38، فقرة 9.
[299]لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، العنف ضد النساء، وثيقة الأمم المتحدة أ/47/38، فقرة 24 (t).
[300]العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 9، الملاحظات العامة للجنة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تستشهد الملاحظة 19 الخاصة بالعنف المستند إلى النوع الاجتماعي بحق الحرية وحق الأشخاص في الأمن. لجنة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ملاحظات عامة، رقم 19، فقرة 7.
[301] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 19. أعرب الرئيس الراحل ياسر عرفات عن التزامه باتفاقية حقوق الطفل في 5 أبريل/نيسان 1995. انظر أمانة سر خطة العمل الدولية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة الوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران 2005.
[302]إن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منصوصٌ عليه في المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، (999 U.N.T.S. 171)، دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976.
[303]الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، المادة 3؛ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 6.
[304]تقول المادة 6 (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".
[305]لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، الفقرتان 1 و7. كما تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق أي شخص في التمتع "بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، قرار الجمعية العامة 2200 أ (21)، 21 (U.N. GAOR Supp (no.16) at 49)، وثيقة الأمم المتحدة رقم أ/6316 (1966)، 993 U.N.T.S.، دخل حيز التنفيذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976.
[306]ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على وجوب عدم وقوع الزواج إلا "بموافقةٍ ورضا تامين من جانب الشخصين المعنيين". العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 23 (3). كما أن الاتفاقية الدولية الخاصة بالموافقة على الزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل الزواج، وثيقة الأمم المتحدة رقم 521، U.N.T.S. 231، والتي دخلت حيز التنفيذ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1964 تُلزم الدول بأن:
"تتخذ جميع التدابير الملائمة مع التوجه إلى إلغاء الأعراف والعادات والقوانين والممارسات القديمة عن طريق ضمان، من بين أمور أخرى، الحرية الكاملة في اختيار الزوج، والقضاء الكامل على ظاهرة زواج الأطفال والوعد بتزويج الفتاة قبل بلوغها، ووضع عقوبات ملائمة حيث تدعو الحاجة إليها، وإنشاء سجل مدني أو غير ذلك لتسجيل جميع الزيجات".
[307]انظر لجنة اتفاقية حقوق الطفل، ملاحظة عامة رقم 3، فقرة 11؛ وكذلك لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، الفقرة 11.
[308]انظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتدابير منع الجريمة وتدابير العدالة الجزائية للقضاء على العنف ضد المرأة، قرار الأمم المتحدة A/RES/52/86، 2 فبراير/شباط 1998.